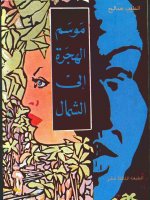مقال جريدة الحياة
الخميس، ١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦
جريدة الحياة
ابراهيم العريس
«موسم الهجرة الى الشمال» للطيب صالح: ما بعد الأيديولوجيا
«... لأن شخصية مصطفى سعيد حضارية، فإنها لن تحتل مكانها الصحيح كشيء له معنى، إلا اذا وضعت في مكانها الصحيح من تاريخ البلد الذي إليه ينتمي. لقد ولد مصطفى سعيد، على سبيل المثال في الخرطوم في 16 آب (اغسطس) 1898. وهذا التاريخ لا معنى له، ككل تاريخ آخر في المطلق. لكنه في سياق تاريخ السودان، تاريخ خطير الدلالة: فقد ولد مصطفى سعيد في اليوم الذي بدأت القوات الإنكليزية، بقيادة كتشنر، اجتياحها دولة السودان. ولأن شخصية مصطفى سعيد مركبة من الحقد والحب، فإنها شديدة التعقيد. ولأنها شديدة التعقيد، فقد تبدو متناقضة اذا نظر اليها بعين واحدة. وذلك هو السر في ان البعض يرى فيه ثائراً على الاستعمار ومقارعاً له، بينما يرى فيه بعضهم الآخر عميلاً للانكليز وجاسوساً لهم. ولهذا بالتحديد أراد مصطفى سعيد ان يكتب بنفسه سيرته، حتى تفهمه الأجيال من بعده ولا تظلمه. ومع انه لم يكتب من قصة حياته سوى الإهداء فإن هذا الإهداء يغني عناء كل صفحات الكراسة التي بقيت فارغة ناصعة البياض، فقد جاء فيه: الى الذين يرون بعين واحدة، ويتكلمون بلسان واحد ويرون الأشياء إما سوداء أو بيضاء، إما شرقية أو غربية». بهذه العبارات حاول الكاتب والناقد جورج طرابيشي، في كتابه «شرق وغرب، رجولة وأنوثة» (1977)، ان يحلل شخصية البطل المحوري في رواية الكاتب السوداني الطيب صالح «موسم الهجرة الى الشمال» التي تعتبر دائماً واحدة من أهم الروايات العربية التي صدرت خلال النصف الأخير من القرن العشرين. ولئن كان طرابيشي وفق الى حد ما في هذا التحليل، ضمن محاولته الايديولوجية المهيمنة على كتابه، فكان واحداً من النقاد العرب الأكثر غوصاً في الشخصية، كما في المعنى العام للرواية في شكل أساسي، فإن ما كان ينقص الناقد في ذلك الحين عنصران لم يكن للنقد العربي عهد بهما: النظرية ما بعد الكولونيالية من ناحية، والتخفيف من حدة التأويل في تفسير الأدب الابداعي من ناحية ثانية. صحيح ان ثمة هنا ما يغرينا بالتعمق أكثر في هذا العنصر الثاني لنعلن، مع سوزان سونتاغ، ان من الأفضل بالنسبة الى تحليل هكذا رواية ان نرفض التأويل من أساسه، لكن هذا يبدو لنا غير منطقي بعدما عاشت هذه الرواية حياتها وصارت مع الوقت مَعْلماً من معالم الروايات العربية ذات المعنى والرسالة. أما بالنسبة الى العنصر الذي يرتبط بنظرية ما بعد الكولونيالية، فلعل في امكاننا ان نقترح ان «موسم الهجرة الى الشمال» تنتمي اليها قلباً وقالباً، على غرار أدب نايبول وسلمان رشدي، بل تفوقهما تأدلجاً في هذا المجال بالتحديد.
ومع هذا كان الطيب صالح لا يفتأ يقول لمن يسأله، يوم انبعثت روايته هذه انبعاث الصاعقة في الفضاء الأدبي العربي، نهاية ستينات القرن العشرين، بأنه يعتقد انه انما اراد أولاً وأخيراً ان يكتب رواية عن قرية سودانية – عن القرية السودانية – تنخرط في إطار ثلاثية اذ تستكملها روايتاه «دومة ود حامد» و «عرس الزين». فهل كان يقول هذا بتواضع في زحام الاستقبال الصاخب و «الوطني القومي» الذي كان لروايته؟ أم تراه كان يقوله عن يقين غير مبالٍ بالتأويلات التي جعلت من عمله الروائي ككل – وهو قليل بل نادر على اية حال -، الأدب المؤدلج بامتياز في الكتابة العربية؟
لن نحاول هنا الإجابة عن هذا السؤال. سنحاول فقط التوقف عند الرواية نفسها إذ تبدو اليوم منسية بعض الشيء (على رغم صدورها في طبعة جديدة – منفردة كما مع أعمال الطيب صالح الكاملة – لدى دار العودة في بيروت). ولربما تنبع رغبتنا في التوقف عندها من واقع ان مجلة «نوفيل اوبسرناتور» الفرنسية خصّتها من بين ألوف الروايات العربية الصادرة في القرن العشرين، بإدراجها في سياق نحو خمسين رواية عالمية أصدرت عنها عددين خاصين واعتبرتها خلاصة الأدب الروائي العالمي – غير مشركة معها من تاريخ الأدب العربي سوى «ألف ليلة وليلة» – مكلفة الأديب المغربي باللغة الفرنسية طاهر بن جلون بكتابة نبذة عنها. صحيح ان في هذا ظلماً لأعمال أدبية عربية كثيرة، لكن فيه كذلك نوعاً من رد الإعتبار لهذه الرواية السودانية التي ظلمها صاحبها بعدم انكبابه على كتابة غيرها طوال سنوات وسنوات، وظلمها النقاد ومؤرخو الأدب حين تعاملوا معها، في أغلب الأحيان بوصفها بياناً سياسياً!
وللإنصاف نقول ان في رسم شخصية مصطفى سعيد ما كان من شأنه ان يسهّل مثل ذلك الظلم. فمصطفى، سواء في الصفحات الأولى من الرواية حين يكون هو الراوي، أو لاحقاً حين يتابع – بعد موته غرقاً؟ انتحاراً؟ عبثاً؟ وقد غرق في فيضان النيل – الحديث عنه ذلك الراوي الآخر الذي يتولى هنا خوض لعبة المرايا، هو الذي يقول انه لم يظهر إلا بعد اختفاء مصطفى سعيد، مصطفى لا يكف عن ترداد مثل هذه العبارة، لا سيما خلال محاكمته بتهمة قتل زوجته الانكليزية في لندن حين درس فيها و «غزا» أربعاً من نسائها، انتحرت منهن من انتحرت وقتل هو الرابعة: «... حين جيء لكتشنر بمحمود ود احمد وهو يرسف في الأغلال بعد ان هزمه في موقعة عطبرة قال له: لماذا جئت الى بلدي تخرب وتنهب؟ الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الارض، وصاحب الارض طأطأ رأسه، ولم يقل شيئاً. فليكن ايضاً ذلك شأني معهم. إنني أسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة، وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهي تطأ ارض القدس. البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدفع لا الخبز، وسكك الحديد أنشئت اصلاً لنقل الجنود. وقد انشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقوم: نعم، بلغتهم...».
أجل، لقد توقف النقد العربي عموماً، عند هذا الجزء من الرواية، عند مصطفى سعيد. صحيح انه شخصيتها الأساس، وبالتالي واحد من أغنى وأغرب الشخصيات في الرواية العربية، وصحيح أن طيف مصطفى سعيد يلوح في باقي فصول الرواية بعد رحيله، من خلال الأسئلة المثارة من حوله، وزوجته حسنة -التي من دون ان تعرفه جيداً، تقرر أنها لن تتزوج أحداً من بعده، فإن زُوّجت بالقوة من ود الريّس ستقتله وتقتل نفسها، وهي تفعل هذا-، كما من خلال الراوي شبه المجهول الذي يكاد يصبح أناه الآخر هو الموكل عنه برعاية زوجته وذريته. غير أن الطيب صالح قد يكون محقاً في تأكيده على انه كتب «أيضاً» وربما «خاصة» رواية عن الأرض والقرية السودانيتين، وعن نهر النيل وتدفقه حتى احتضان مصطفى سعيد الذي عاد من لندن ومن «غزو نساء الغرب» ليعيش حياته هناك حيث بدأت تلك الحياة. وفي يقيننا في هذا السياق ان الأوان قد آن للعودة الى «موسم الهجرة الى الشمال»، في شكل أكثر رحابة وفي كلام أكثر علاقة بالأدب واللغة ولعبة الراوي والمرايا، و- هنا على خطى جورج طرابيشي الثاقبة -، لعبة الرجولة والأنوثة، وليس فقط في بعد لعبة الشرق والغرب. بل لربما كان من المفيد اليوم ان يعود النقد الى هذه الرواية مأخوذة في السياق المتكامل لأدب الطيب صالح الذي لم ينتج خلال الثمانين سنة التي عاشها (1929-2009) سوى خمسة كتب بين قصص قصيرة (مجموعتين) وروايات، لا يتجاوز عدد صفحاتها معاً الخمسمئة صفحة من القطع القصير. وذلك شرط ان يخلص النقد الجديد ذلك الأدب من فقاعة البعد الايديولوجي الذي طغى عليه، ونعرف ان الكاتب نفسه كان أول وأشد مستغربيه. ولا بد ان نذكر اخيراً ان السوداني الطيب صالح تحدر من بيئة متواضعة ودرس في الخرطوم والقاهرة، ثم توجه الى لندن حيث أكمل دراساته العليا ليعمل بعد ذلك في القسم العربي بهيئة الاذاعة البريطانية التي أوفدته لاحقاً الى فرعها في بيروت حيث عمل فترة قبل ان يلتحق باليونسكو ويعيش بعض آخر سنوات حياته في الخليج العربي.
“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.
مقال جريدة القدس العربي
جريدة القدس العربي
السنة السادسة والعشرون ـ العدد 8049 الجمعة 20 آذار (مارس) ـ 29 جمادي الأول 1436هـ
سامي البدري - روائي وناقد عراقي
الطيب صالح غازيا ثقافيا
لن آتي بجديد إذا ما قلت أن ثمة، ليس فقط ما يشد، بل ما يسحر المثقف العربي في الحضارة الأوروبية ومروج ثقافاتها النضرة، وبالتأكيد أنا أعني بهذا النزوع والتشوق إلى كل مميزات وثراء مباهج قصر الثقافة والحضارة الأوربيين، من دون سلة نفاياته طبعا، ذلك القصر الذي لفت جميع الأنظار والاهتمام بثراء تأثيثه المعرفي والفكري (الثقافي)، وهذا بالذات ما حاول الطيب صالح الروائي السوداني، وصاحب أكبر انعطافة فنية في تاريخ الرواية العربية، إيصاله إلينا، عبر صفحات غزوته «موسم الهجرة إلى الشمال» لتلك الحضارة، في عقر دارها.
لعل أهم ما ميز (غزوة) الطيب صالح عن غزوات من سبقوه من الأدباء العرب إلى ديار (الإفرنجة)، موضوعيته في النظر لمنجز و(أخلاقيات) تلك الحضارة (موضع اتهامها الأول من قبل الثقافة العربية) أولا، وتجرده في تقييم تلك الحضارة وثقافتها، ثانيا، بعيدا عن التعصب والأحكام المسبقة والانفعال البدوي الذي شد طريقة نظر الأدباء العرب، الذين سبقوا الطيب صالح في غزو ديار المستعمِر القديم، ومن منطلق أن الموضوعية والأمانة الفكرية، تفرض علينا مكاشفة النفس، بالجذور البدوية لثقافتنا العربية، التي لم نستطع الفكاك منها، خاصة على صعيد التقييم وإصدار الأحكام المسبقة، التي فرضتها حقبة الاستعمار ورجال العسكر، الذين احتككنا بهم، كواجهة لفعل الثقافة الأوروبية على أراضينا.
يصف الطيب صالح، وعلى لسان راوي «موسم الهجرة إلى الشمال» البريطانيين، مستعمريّ السودان السابقين، لأهل قريته، وبعد أن أقام بين ظهرانيهم سبع سنوات ودرس في جامعاتهم بقوله: «إنهم مثلنا يعملون ويتزوجون وينجبون الأطفال…» وهذا التبسيّط الذي فرضه المستوى المتواضع لثقافة المخاطب، أهل قريته الرابضة عند منحنى نهر النيل، ربما فرضته الأمانة العفوية للراوي، الذي اقتصرت مشاهداته لتلك الحضارة على هيكلية وآليات الحياة البريطانية العامة، من دون الغور في أعماقها الثقافية، خاصة أن الراوي ولد بعد رحيل المستعمِر ولم يشهد ممارساته، بصورة مباشرة؛ وأيضا لم يشهد ـ وهذا ما يحرص الصالح أن يلفت نظر المتلقي إليه ـ إلا الجانب المشرق منها، خلال سنوات دراسته في جامعاتها، هو القروي الذي تدهشه القشور، وتجعله غير منحاز لماضيه في الحكم، وخاصة ـ وهذا ما ركز الصالح على إظهاره في الرواية ـ أن ثقافة الراوي البسيطة أو خلفيته الثقافية القروية، هي التي كانت وراء ذلك التصور، لأنه كان يرى أنه المثقف الوحيد في تلك البقعة المهمشة من قرى السودان.. وهذا ما تؤكده ثورته على بطل الرواية، مصطفى سعيد ابن العاصمة، الخرطوم، عندما يسمعه، في ساعة راحة، تحت تأثير الشراب، يردد أبياتا من الشعر الإنكليزي، وبلغتها الأم، بقوله وهو مهتاج: ما هذا؟ ما الذي تقوله؟ لأنه كان يتصور نفسه المثقف الوحيد في تلك البقعة من الأرض، إن لم يكن في كامل أرض السودان! وكذلك في قوله، في موضع آخر من الرواية، وهو يتحدث عن صديقه محجوب: «خفت من شدة غروري أن لا يفهم ما أقول».
وبرأيي المتواضع، فإن ما عمد إليه الطيب صالح من متوازية بطليّ الرواية، الراوي ومصطفى سعيد، والفرق بين فهم وانفعال وتقبل كل منهما لحضارة مستعمِرهما السابق، إنما جاء لدفع تهمة الانحياز في رصده لمحاسن الحضارة الأوروبية، خاصة أنها تمثل حضارة المستعمِر السابق الذي مازالت آثار ندوب سياطه على جلود السودانيين، ومن دون التوقف أمام مساوئ وإشكالات هذه الحضارة الثقافية، على صعيد التعامل والسلوك الفعلي على مصطفى سعيد، بطل الرواية، لتأثره، بثمرات وألوان هذه الحضارة أو لاستعداده غير الطبيعي، للانسلاخ عن جذوره، خاصة في ما جسدته الرواية، في نهايتها الغائمة، بعودة مصطفى سعيد لأرض تلك الحضارة، بعد أن وجد نفسه عاجزا عن مواصلة الحياة في سكون الموات (الثقافي) الذي تعيشه تلك القرية المنسية (يتعمد الصالح عدم تسميتها إمعانا في إظهار هامشيتها) عند منحنى النيل، رغم أن مصطفى سعيد ـ ولأنه دخل بريطانيا وعاش تجربة حضارتها وهو في سن مبكرة ـ يعود إلى جذوره السودانية البعيدة، والغائمة في ذاكرته، بعد اصطدامه بثقل وعمق تجربته الحياتية في عمق تلك الحضارة وآلياتها (التي دخلها غازيا، كما يردد في مذكراته وحصل وحقق في ظل انفتاحها كل أحلامه وما تمناه) الثقافية المتطورة والمنفتحة ومرارة تجربة ذوبانه فيها، ومن ثم نكوصه إليها مرة ثانية، بعد اصطدامه بضحالة آليات ثقافة جذوره (السودانية) وسباتها واستمرارها على منوالها الأول نفسه الذي دفعه للهروب منها في بداية حياته وهو صبي، رغم أن ذلك الهروب جاء بناء على نصيحة واختيار راعييه الإنسانيين، مستر ومسز روبنسن، اللذين وجدا أن حتى محيط ثقافة القاهرة سيكون ضيقا عليه ولن يحتوي قدراته العقلية.
ولكن، وبما أننا هنا بصدد التركيز على النظر في الجانب السيكولوجي لهذه الإشكالية، أجدني مضطرا للقفز على جميع الجوانب العملية والعلمية والتنظيمية، اقتصادية واقتصاد سياسية، والتي هي من ثمار دراسات مصطفى سعيد في جامعات تلك الحضارة (حضارة وثقافة الآخر) التي سعى لتطبيقها في (ثقافة) تلك القرية المهملة، من أجل الارتقاء بها وبواقعها الزراعي المتخلف، لنصل إلى مناقشة الآثار الفكرية والنفسية التي خلفتها ثقافة مصطفى سعيد (المستوردة) في حياة وطرق تفكير وذائقة فلاحيّ تلك القرية وزوجته حسنة، على وجه الخصوص، كنموذج لها، والتي اقترن بها بعد عودته إلى وطنه الأم، وبصفته ممثلا ـ ثقافيا وحضاريا ـ لثقافته المكتسبة.. ورغم أن رجال القرية شدهم (علمه وسلوكه الرصين وأدبه الجم) إلا أن أثره الثقافي لم يظهر إلا في حياة حسنة، دون باقي نسائها ورجالها، بمن فيهم الراوي، بطل الظل في الرواية، أو المعادل الفني لا الموضوعي لمصطفى سعيد، باعتباره قد خاض تجربة الاقتراب من ثقافة (الآخر) من دون استيعابها أو تمثلها، كحراك ومفتاح تغيير.
فحسنة، وبفضل اقترابها من صميم حياة مصطفى سعيد كزوج (آخر) لا يشبه الأزواج/الرجال الذين من حولها، وقفت على شذرات من ثقافته المختلفة، التي تمثلت في تفهمها، على الأقل، لنكوصه عن جمود ثقافة القرية وسطحيتها، إن لم نقل تمسكها وإصرارها ـ القرية/السودان ـ على ذلك الجمود أولا، ولإخلاصها القائم على الوفاء لذكراه، لما لمسته فيه من اختلافات ثقافية و(تحضر) على مستوى التعامل الإنساني والاحترام لكينونتها الأنثوية المزدراة في ثقافة القرية، وحبه لها لذاتها ثانيا.. وأيضا لامتلاك هذا الزوج (الآخر) والمختلف عن ثقافة رجال القرية، ما يميزه على مستوى المشاعر والعمق ثالثا، رغم تصريحه، في مذكراته الخاصة، التي يكشفها لنا الراوي في ما بعد، عن سلوكياته الانفعالية، كغاز جنسي مع النساء وتسببه للكثير منهن بالألم والأذى النفسي.
حسنة التي رملها نكوص وهروب مصطفى سعيد المفاجئ إلى ثقافته الأوروبية، في موسم هجرته إلى الشمال، ووفاءً منها لذكراه، كآخر مختلف ومتوفر على ما شدها وأدهشها من ثقافته المكتسبة، نراها تسلم مفتاح غرفة مكتبه الخاص، التي يشبه سقفها ظهر الثور، والتي لم تدخلها ولم يطلعها على أسرارها، إلى بطل الرواية الظل، الراوي، لينفذ فيها وصية زوجها وفي ولديه أيضا، وإبداء الرأي أو تقرير مصير تركة فقيدها الثقافية والفكرية، والمتمثلة في مكتبته التي تحتل جدران تلك الغرفة، التي لا تشبه غرف القرية؛ وكذلك في تركته الروحية المتمثلة في مذكراته الخاصة، رغم أن ذلك التنفيذ قد بلغ حد انتقام الحرق، لفظاعة سلوك وقيم صاحبها، تخلصا من أكذوبة ظهور أو مرور مصطفى سعيد في تلك القرية، بحسب الراوي، ولتفوّق (أعاجيب) ثقافة سعيد على ثقافة ووعي واستيعاب الراوي، القروي الذي لم يستطع الخروج من جلد ثقافته المحلية، رغم عيشه لسبع سنوات في بريطانيا ودراسته لحياة أحد شعرائها في جامعاتهم… هل لأنه كان محصنا ـ بثقافته المحلية ـ ضد عدوى جرثومة ثقافة الآخر ـ كما سماها مصطفى سعيد ـ أم لأنه لم يستطع هضم إلا قشور الحياة اليومية لتلك الثقافة؟ وهل انغماس مصطفى سعيد في رغباته، بسبب وفرة أساليب إشباعها في ثقافة الآخر، هي جزء ثقافي من ثقافة الآخر، أم هي مجرد انحراف في تكوين وذائقة مصطفى سعيد الفطريين، ساعدت الوفرة على إظهاره وإنضاجه؟ مصطفى سعيد يقول إنه ورث جرثومة العدوى من أيام استعمار الآخر الذي يغزوه من أجل استرجاع الحق.. أما ثقافيا فنقول إنه انحراف في السلوك والذائقة، وكان عليه أن يكسب من الثقافة المتطورة ما يهذبهما.
كما أن حسنة، ولنقل انبهارا منها بثقافة مصطفى سعيد، وما مثلته لها من انتقالة نوعية في توجيه وعيها وذائقتها، ترفض الزواج بغيره من رجال القرية، بعد رحيله، لانغماسها وتلذذها بقيم ثقافة تعامله معها (المختلفة أم الأكثر تحضرا من ثقافة محيطها القروي؟) كأنثى، وعندما تجد إصرارا من أهلها على تزويجها، تضطر للطلب من بطل الظل، أن يتزوجها، من أجل أن يخلصها من الزواج من (ود الريس) العجوز (الذي عقله في رأس ذكره) كما تصفه بنت مجذوب، لأنها توسمت به، ومن خلال ثقة مصطفى به، ومن خلال دراسته في مكان (ثقافة) زوجها المتحضر نفسه، في أن يكون متميزا بثقافة تعامل مصطفى نفسها، ذي الثقافة المختلفة، إن شئنا عدم استخدام كلمة المتحضرة، طمعا في تخليصها من عملية الاغتيال الثقافي التي يمثلها لها الزواج من قروي… لن يشبه مصطفى سعيد بشيء من اختلافه (المتحضر).
ويعمد الطيب صالح لإظهار ذلك الاختلاف الثقافي وأثره الكبير، لأنه يمثل انتقالة ثقافية نوعية في حياة من يلامسه روحيا، بدفع حسنة، في لحظة اليأس النهائي بالانتقام القهري من (ود الريس، بصفته رمز تخلف محيطها القروي الذي لا ينظر إليها إلا كوسيلة متعة) بقطع ذكره، (كرمز لامتهانها من قبل ثقافة ذكورة مجتمعها) وقتل نفسها.
والآن نصل إلى سؤال المكاشفة في قراءتنا هذه: أين الخلل في تشرب مصطفى سعيد بالثقافة الأوروبية، ولو كسلوك إنساني متحضر، لمسته حسنة؟ وهل كان نكوصا وهروبا أو عودة مصطفى سعيد إلى محيط ثقافته الشمالية (الثقافة الأوروبية) غير هروب من ضحالة ثقافته الأم؟ ألم يكن هروب مصطفى سعيد هروبا من تحجر ثقافتنا العربية عند نقطة بعينها وعدم مسايرتها لسنن التقدم الطبيعية؟
أعتقد أن الطيب صالح طالبنا بعملية مكاشفة شجاعة لبنانا الثقافية القائمة على الخوف الأعمى من الآخر والشك المسبق بنواياه، أولا من حيث كونه آخر بذاته، وثانيا استنادا إلى لوثات ماضيه… متناسين أن كل شيء يتغير، وفقا لسنن تطور الحياة، بمن فيها الإنسان، في بنى تفكيره وسلوكه، وإن علينا التوقف عن رفض الآخر الانفعالي والتقرب منه وملامسته ودراسته بعناية، من أجل التعرف عليه أولا، ومن أجل فهم أسباب كونه آخر وإزالة اللبس عنها ثانيا.
عن موقع جريدة القدس العربي الجديد
المقال في جريدة القدس العربي بالـ pdf
صحيفة القدس العربي هي صحيفة لندنية تأسست عام 1989.
ويكيبيديا
موسم الهجرة إلى الشمال على ويكيبيديا