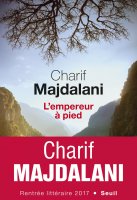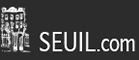Auteur(s) : Charif Majdalani)
Titre : L’Empereur à pied
Editeur : Seuil
Parution : 17/08/2017
400 pages
EAN 9782021372502
Présentation
Au milieu du XIXe siècle, un homme apparaît avec ses fils dans les montagnes du Liban. Il s’appelle Khanjar Jbeili, mais on le surnommera vite l’Empereur à pied. Il est venu pour fonder un domaine et forger sa propre légende. Sa filiation ne tarde pas à devenir l’une des plus illustres de la région. Mais cette prospérité a un prix. L’Empereur a, de son vivant, imposé une règle à tous ses descendants : un seul par génération sera autorisé à se marier et à avoir des enfants ; ses frères et sœurs, s’il en a, seront simplement appelés à l’assister dans la gestion des biens incalculables et sacrés du clan Jbeili. Serment, ou malédiction ? Du début du XXe siècle à nos jours, les descendants successifs auront à choisir entre libre-arbitre et respect de l’interdit. Ouverts au monde, ils voyageront du Mexique à la Chine, de la France de la Libération aux Balkans de la guerre froide, en passant par Naples, Rome et Venise, pourchassant des chimères, guettés sans cesse par l’ombre de la malédiction ancestrale. Jusqu’à ce que, revenu sur le sol natal, le dernier de la lignée des Jbeili rompe avec le passé et ses interdits, à l’aube du XXIe siècle. Mais à quel prix ?
Charif Majdalani
Charif Majdalani est né au Liban en 1960. Depuis 1999, il enseigne les lettres françaises à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Avouant un goût prononcé pour le baroque et le métissage des cultures, il se définit volontiers comme « méditerranéen ». Son roman Caravansérail a été récompensé en 2008 par le prix Tropiques et le prix François-Mauriac de l’Académie française.
En savoir plus sur le site de l’éditeur
L’écrivain libanais de langue française a été couronné pour son roman Villa des femmes par le grand prix Jean-Giono 2015. Un récit qui conte la déchéance de la riche famille des Hayek et qui se confond avec celle du Liban.
الجمعة، ٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٧
جريدة الحياة
حوار مع عبده وازن
شريف مجدلاني : أعيش بين ثقافتين ... وتجذبني الأزمات الكبرى
قد لا يحتاج هذا الحوار مع الروائي اللبناني الفرنكوفوني شريف مجدلاني إلى تقديم، فهو يقدم نفسه بنفسه من خلال الأسئلة والأجوبة التي تناولت تجربته الشاملة بخطوطها البارزة وعلاماتها ورويته الجديدة « الامبراطور المترجل » الصادرة حديثاً بالفرنسية عن دار سوي، وقد وردت للفور في اللائحة الطويلة لجائزة « رونودو » العريقة للرواية الفرنسية. ومنذ صدورها قبل أسبوع باشرت الصحافة الفرنسية بالترحاب بها وبصاحبها الذي بات واحداً من الروائيين الشباب البارزين ليس في الأدب الفرنكوني فقط وإنما في الأدب الفرنسي ولا سيما الرواية. نال مجدلاني جوائز فرنسية عدة سابقاً ومنها جائزة جان جيونو الراقية وبلغ اسمه اللوائح القصيرة لجوائز أخرى مهمة. ولكن بعيداً من الجوائز التي تشكل موسماً كل خريف في باريس يمثل مجدلاني حالة روائية خاصة في جمعه بين جذوره اللبنانية التي لا يزال مشدوداً إليها وانتمائه اللغوي والأدبي إلى اللغة الفرنسية التي يعدها أيضاً لغته الأم مثلها مثل العربية، والتي نشأ على القراءة بها والكتابة بها والتعمق في أسرارها وتطويعها إبداعياً. هنا الحوار.
عبده وازن
> من رواية إلى أخرى تبدو أنك صاحب مشروع روائي ولست فقط روائياً. ويتجلى مشروعك أولاً في التيمة التاريخية التي تعيد من خلالها النظر في الرواية التاريخية مفتتحاً أفقاً جديداً تندمج فيه مقاربة التاريخ على المعطى السوسيولوجي والسياسي والأسري إضافة إلى البعد التخييلي، وثايناً في الأسلوب الذي يتحول لديك إلى خلاصة أساليب. كيف تحدّد معالم هذا المشروع الذي تتفرّد به؟ يبدو أنك كروائي تمد يد المساعدة إلى المؤرخ لديك مما يجعلك تكتب رواية جديدة تاريخية ولكن على نحو مغاير لمفهوم رواية التاريخ : كيف يلتقي الروائي والمؤرخ لديك وكيف يختلفان؟
– في البداية، يهمني التأكيد أنّني لا أكتب روايات تاريخية بالمعنى المُتفّق عليه نقدياً في تحديد هذا النوع من الكتابات الإبداعية. فالرواية التاريخية تضع في موقع الأحداث شخصيات تاريخية معروفة، أو على الأقلّ تُقحمها في طريقة ما داخل الحبكة الروائية، إلى جانب شخصيات متخيلة. وهذا ما لم اعتمده في أيٍّ من رواياتي. فأنا أكتب حكاياتٍ متخيلة تُظلّلها خلفية تاريخية تتمثل في لبنان خلال القرن العشرين أو الحادي والعشرين. من هذه الزاوية، يمكن القول إن مشروعي يتلخّص في كتابة التاريخ الاجتماعي للبنان، تماماً كما ذكرت في سؤالك، وذلك عبر رصد التحولات التي عاشها البلد منذ نهاية السلطنة العثمانية حتى الآن. إنّه امتداد زمني طويل، وهذا ما يناقض مفهوم الرواية التاريخية التي تركز على أحداث معينة في مدة زمنية محدودة نسبياً. وأنا شغوف جداً بالتغيّرات التي تطرأ على المجتمعات التي تواجه أزمات كبرى (حروب، نهاية حقبة...)، وأهتم كذلك بالطريقة التي يتفاعل بها الناس، أفرادًا وجماعات، مع كلّ تلك الخضّات.
والمعروف أنّ لبنان عاش زمنين من التحوّلات المحورية في تاريخه، الأولى مع نهاية الحقبة العثمانية، والثانية عند اندلاع الحرب الأهلية. وفي روايتي، تجد هذين الحدثين التاريخيين، مع التركيز على الحرب الأهلية. لكنني لم أتناولهما بالتأريخ والتوثيق، بل كتبتُ عنهما من الداخل، أي من الناحية الحميمة إن صح القول، انطلاقاً من التركيز على الحياة اليومية لعائلات وشخصيات، في طريقة تضع الحياة اليومية داخل حبكة الزمن الأطول، التاريخ. ولهذا يمكن أن تجد نسبة التخييل أكبر في أعمالي. ففي رواية « تاريخ المنزل الكبير »، صوّرتُ لبنان في نهاية الحكم العثماني، ومن ثم انتقلت إلى العالم الجديد عبر مصير عائلة ورجل، مركزاً على التفاصيل الصغيرة التي تحصل ضمن سياق الأحداث الكبرى. أما في رواية « سيد المرصد الأخير »، فتحدثت مثلاً عن التحولات في أحد أحياء بيروت وتأثيرها في سكانه، من البدايات حتى الحرب الأهلية، وعن مآلات الحرب اللبنانية عبر حكاية زعيم عشيرة. وفي « الأمبراطور المترجّل »، تناولت علاقة الإنسان الإشكالية بالأرض، عبر حكاية الانتقال من الاقتصاد الزراعي في القرى إلى الاقتصاد التجاري وظهور طبقة جديدة بعد الحرب الأهلية، وكلّ هذا من خلال سيرة خمسة أجيال وعبر أحداث متنوعة.
لا أكتب رواية تاريخية
> هل تعنيك مقولة جورج لوكاس التي يفيد فيها أن الروائي التاريخي لا ينظر إلى التاريخ إلا من خلال قضايا الحاضر أو الراهن وأن الرواية لا تكون تاريخية إلا إذا حملت من زمن كتابتها قضاياه الأساسية؟ هل يمثل الواقع والحاضر لديك دافعاً لاستعادة التاريخ وإعادة كتابته روائياً؟
– حتماً. ولهذا أقول أيضاً إنني لا أكتب روايات تاريخية. ما يهمني حينما أكتب هو العالم الراهن، سواء في اختيار موضوع الرواية أو في التوجه العام لكتابتي. عندما تناولت في روايتي الأولى مثلاً قضية نشوء الزعامات اللبنانية بالتزامن مع نهاية الأمبراطورية العثمانية، كنتُ أكتب في الوقت عينه عن الصيغة الإشكالية لممارسة العمل السياسي في لبنان المعاصر. وحينما رويت الحقبة التي سبقت الحرب الأهلية، في كثير من رواياتي، إنما كنت أصف مجتمعاً يعيش في إنكار دائم لمشاكله، تماماً كما هي حال شعب يعيش عند سفح بركان، يسمع أجيج نيرانه، لكنه لا يهتم بما حوله لأنه يعتقد أن ما يراه أو يسمعه هو حدث طبيع- أزلي لا عواقب له. إنه وصف يختصر حاضرنا وواقعنا كأبناء مجتمع لا يواجه مشاكله، بل لا ينثني عن إنكار وجودها، لأنه مشغول ببساطة باقتناص المتع الذاتية وصنع الأرباح المادية. في روايتي الأخيرة أصف فقدان الجبل اللبناني مكانته، كمثالٍ ومشهدية طبيعية، لكنني جعلت من هذه الحالة الخاصة نموذجاً لتدهور كوكبنا كلّه.
> ما يميّز عملك على الرواية التاريخية هو انفتاحها على الجغرافيا والجيو سياسة حتى لتبدو في معنى ما كأنها رواية أمكنة ومجتمعات وعشائر وعائلات وجماعات وطبقات، وهذا ما تبدى واضحاً في « قصة المنزل الكبير » و « فيللا النساء » و « سيد المرصد الأخير » وفي روايتك الجديدة أيضاً التي تتميّز عن الروايات السابقة وهذا ما سنعود إليه. كيف تنظر إلى هذه الناحية في عملك الروائي؟ إلى أي مدى يختلط التاريخي بالجغرافيا المكانية والإنسانية والجماعية؟
– كما قلت لك سابقاً، أنا أكتب روايات عن التاريخ الاجتماعي أكثر مما عن التاريخ نفسه. وفي طبيعة الحال، كتبي هي في معظمها سجلات سردية لعائلات، والمقصود هنا العائلة بمعناها الأوسع أي العشيرة، لكونها الأقدر على وصف العالم من داخله ورصد تطوره. لكنني أتفق معك على أن رواياتي قد تكون روايات جغرافية باعتبارها تتناول الأمكنة، ولا سيما البيت والحي، وهما مربطان للأسر والعشائر. فما يهمني ككاتب هي الحياة اليومية للمنزل، أو العشيرة، أو أي مجتمع يلتقي حول رئيس (زعيم). وأنا استخدم كلمة « بيت » قاصداً فيها المعنيين اللذين تحملهما اللغتان العربية واليونانية القديمة فقط. « البيت » بالعربية يعني المنزل بمعناه المادي كما يعني العائلة فنقول هنّ من بيت فلان والمقصود بها آل أو عائلة فلان. وفي اليونانية القديمة، يرمز البيت أو Oikos (أويكوس) إلى المعنى المعروف (المنزل) تماماً مثلما يعني العشيرة. وأنا أهتم بالتطورات والتغيرات التي تطرأ على هذا « البيت » وأهله نتيجة الزمن والأحداث السياسية والتاريخية. ولكن، إضافة إلى هذه الجغرافية الإنسانية، أجدني أتناول أيضاً الجغرافية المادية لأنني شغوف بالطبيعة وتحولاتها. ففي « الأمبراطور المترجّل » أصف تطور الاقتصاد الزراعي الساحلي، وصولاً إلى التخلّي عن تلك العلاقة مع الأرض في القرى الجبلية خلال القرن العشرين. فأنا أرى المكان الجغرافي نفسه عالماً قائماً بذاته، لذا أجدني أرسم شخصيات تغامر وتسافر وتهاجر، غالباً نحو الشرق. فالعالم الذي أقدّمه في رواياتي منقسم إلى قسمين : عالم الثابتين أو المستقرين، وعالم المسافرين أو الرحّل، أو حتى المهاجرين. ولعلّ هذا التقسيم يلخّص حالة اللبنانيين المنقسمين بين تعلّق أزلي بالأرض ورغبة جامحة في الرحيل.
> في روايتك الجديدة تواصل شغلك على التاريخ لكنك تسعى في شكل خاص إلى فضح هذا التاريخ وتعريته، فرواية « الأمبراطور المترجل » هي رواية شخص شبه أسطوري هو خنجر الجبيلي ورواية سلالته أو أبنائه ورواية طقوس العشيرة ورواية الهجرة والشتات الذي هو الشتات اللبناني (المكسيك، البلقان، فرنسا، روما، البندقية...) ورواية أجيال تتصارع... كيف خطرت على بالك فكرة هذه الشخصية وهذه السلالة والتحولات التي طرأت عليها من جيل إلى آخر حتى بلغت عمق القرن العشرين وأواخره؟
– كل رواياتي، ما عدا « خليفة السراي »، تجري أحداثها في بيروت أو في ضواحيها القريبة مثل منطقة الحدث بما فيها الشياح والغبيري وحارة حريك. ولكن منذ فترة طويلة، يسكنني مشروع تأليف كتاب عن الجبل وعن تطور مفهوم الجبل في أذهان اللبنانيين، الذي بدأ بالتمجيد المثالي قبل أن يتدهور وتصبح فكرة الأرض مجرد سلعة تجارية للبيع والشراء. أما في ما يخص شخصية خنجر الجبيلي فهي ولدت من جمال الجبل وعظمته، كما يقول الراوي في بداية الكتاب. ومن أجل التعبير عن عظمة هذه الطبيعية الأصلية، كنت في حاجة إلى شخصية قوية، مهيبة، وقصّة تحمل شيئاً من الأسطورة. وفي كل قصّة، سواء كانت عائلية أم وطنية، ثمة مكان مرجعي أسطوري، يمثّل « الأصل » الذي يرتبط به هذا المجتمع أو ذاك. وفي هذا الكتاب، يشكّل الجبل نقطة مرجعية عند عائلة جبيلي، بل هو مسرح تاريخ السلف الأول. هذه الجبال هي الفرع الأول لكل جيل من الأجيال التي تعرضها الرواية، وسوف تنفصل عنها تدريجاً قبل أن يصير حلمها متمثلاً في استخلاص الفوائد الاقتصادية والتجارية. أما الجيل الأصغر فتمّ حرمانه من ذاك الجبل وفق قسَم الأسلاف، لذا فإن أبناءه لا يبرحون في بحث مستمر عن أرض تقترب من المكان الأصل أو الجذور. وفي الرواية أيضاً، أعالج شكلاً آخر من أشكال التدهور وهو يرتبط هنا بروعة المغامرة أو مثاليتها. فالمغامرة بمعناها الراسخ في أذهاننا فقدت كثيراً من وهجها وغموضها وسحرها بعدما أدت معرفتنا الزائدة بهذا الكوكب الذي نعيش فيه إلى خسارتنا متعة الاكتشاف. ومن أجل تصوير هذه السلسة من التحوّلات في الأشياء والأفكار والمعايير، كان من الضروري أن أكتب الرواية على مدى أجيال. وكما سبق أن قلت، الوقت الطويل هو الذي يهمني أكثر من أي شيء، وفي هذا الكتاب كان هو الأطول.
> تبدو روايتك هذه ذات نفس ملحمي يظهر في إيقاعها التاريخي والزمني والمكاني وفي تعاقب الأجيال فيها واتساع دائرة الأحداث والوقائع وتشابكها بعضها ببعض : هل توافقني على هذا الوصف الذي يبدو واضحاً تماماً أمام المقاربة النقدية؟
– نعم تماماً. « الملحمي » من الأنواع الإبداعية التي أشعر معها بكثير من الارتياح. في صيغتها التقليدية، كانت الملاحم تزاوج بين الشعر والنثر. وأنا أحلم بأن تعتبر رواياتي، وهي كتابات نثرية محض، كأنها قصائد وأشعار. وبالعودة إلى النوع الملحمي، أذكر تعريفاً بديعاً يعود إلى أكاديمي فرنسي كبير يقول فيه إن الملحمة تضع في الواجهة الأرض والحرب. وأظنّ أنّ هاتين الموضوعتين تشكلان فعلاً قلب رواية « الأمبراطور المترجّل ».
> تبرز لديك شخصية الراوي والدور الذي يؤديه وهذا ما يظهر في معظم رواياتك. إنه الراوي الواعي والمتخيّل في آن واحد، راوٍ شخصيّ وعلني وغفل ومشارك في السرد وغير مشارك في وقت واحد، ومشكّك أيضاً في ما يرويه. كيف أعددتَ وظائف الراوي لديك وطوّرت تقنياته؟ هل يبرز هنا شريف الناقد أو الأستاذ الجامعي الملمّ بتقنيّات السرد؟
– أحاول دائماً الإعراض عن الكتابة من موقعي كأستاذ جامعي. أخال الأمر فظيعاً. ومع ذلك، فأنا أكتب طبعاً على ضوء كلّ ما عرفته وقرأته لكأنّ الكتابة نوع من أنواع المحاورة مع الأدب والروايات والنصوص الأخرى، مهما اختلفت مصادرها. أما عن سؤال الراوي، فأنا انتبهت مرة أن كل رواياتي تقوم على حكايات يرويها راوٍ حاضرٌ من دون أن يكون مشاركاً بالضرورة في الأحداث. ولكنه في المقابل يغدو شريكاً في النص عند السؤال عن حقيقة ما يرويه وآلية معرفته بالمرويات والحقائق. ربما هو موقف أخلاقي، لا أدري. ولكن الأكيد هو اقتناعي بأن كل حكاية هي في الواقع « مصنّعة »، سواء كانت حكاية عائلية أو حكاية وطنية. وأعتقد أن كل « التأريخ » الوطني إنما هو عبارة عن « عمارات » أو بالأحرى وقائع وضعت ضمن سياق قصصيّ عبر مؤرخين. وهذ الشيء نفسه ينطبق على قصص الأسر والعشائر التي يطغى عليها التخييل بقوة. في « تاريخ المنزل الكبير » كتبت حكاية عائلة وفي الوقت عينه بيّنت الطريقة التي تتخذها كل عائلة في « اختراع » حكايتها أو إعادة خلقها من الماضي وعلى امتداد الأجيال. وهذا ما ينطبق أيضاً على رواية « الأمبراطور المترجّل ».
كاتب الضفتين
> إنك من الكتّاب الجديرين بلقب كتّاب الضفتين وربما الأكثر من ضفتين : الشرق والغرب يلتقيان هنا التقاء حقيقياً وليس أكزوتيكياً وكذلك اللغتان الفرنسية والعربية الأم. كيف تنظر إلى هذا اللقاء المزدوج؟
– مثل كثير من اللبنانيين، أعيش - من دون أزمة حقيقية - بين ثقافتين، حياتين، لغتين. وأراه حظاً كبيراً أن يتمكّن المرء من فكّ شفرات عالمين برموزهما المختلفة.
> عندما تقرأ رواياتك مترجمة إلى العربية هل تشعر بحنين إلى الكتابة باللغة الأم؟ هل تشعر أن الترجمة العربية تخون رواياتك أم تضعها في جلدها الأصلي؟
– في الواقع، أنا أقول دائماً إن اللغة الفرنسية هي لغتي الأم واللغة العربية هي لغتي الأب. وأنا أعني هذا الكلام بحرفيته، لأن أمي هي لبنانية عاشت في مصر، والمعروف أن اللبنانيين الذين استقروا في مصر قديماً كانوا لا يتكلمون العربية جيداً لأنهم يرتادون مدارس فرنسية ويعيشون في مجتمع فرنكوفونيّ. وحين عادت أمي إلى لبنان، اصطحبت معها الكتب والروايات الفرنسية ومن ثم نشأت في هذا الجوّ الثقافي. وحينما أقرأ رواياتي مترجمة إلى العربية - وأنا أشتغلها مع المترجمين أنفسهم - أكتشف أن اللغة العربية مريحة جداً ومناسبة لرواياتي لكونها تتمتّع بشيء من الغنائيّة والتقطيع الشعريّ. وهذا الإحساس بالحميميّة تجاه رواياتي المترجمة طبيعي جداً لأنها تدور أساساً في عالمٍ ناطق بالعربية.
> في روايتك الجديدة « الأمبراطور المترجل » تبلغ مشارف الحرب الأهلية من غير أن تخوضها : هل فكّرت يوماً في كتابة رواية هذه الحرب؟ هل تشعر في حاجة إلى كتابة رواية الحرب هذه؟
– في روايتي « الأمبراطور المترجل » وصلت حتى عام 2015، وأشرت أيضاً إلى أزمة النفايات في لبنان. وتناولت حقبة الحرب وما بعدها أيضاً. ولكن ما أردت قوله ربما هو أن الرواية تخلو من الأحداث الشائعة للحرب. واخترت في المقابل أن أظهر كيف أن المیلیشیات وقادتها حاولوا خلال سنوات الصراع تدمير السياسيين السابقین، وکیف أن رؤيتهم إلى مستقبل البلاد اختلفت عن رؤیة الطبقة السیاسیة القدیمة. ومن ثم حاولت أن أعيد تسجيل ميلاد طبقة اجتماعية جديدة خلال السنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب، والتي تتألف أساسًا من حديثي النعمة كوّنوا ثرواتهم خلال الفترة السابقة. هنا أيضاً، تجد طفرات العالم التي أردت تسليط الضوء عليها ومعالجتها.
"الحياة" صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت "الحياة" سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت "الحياة" لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت "الحياة" منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت "الحياة" وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل "الحياة" رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم "الحياة" نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.
الأربعاء، ٣٠ أغسطس/ آب ٢٠١٧
جريدة الحياة
باريس - أنطوان جوكي
لبنان والعالم والأجيال في جدارية تاريخية لشريف مجدلاني
« لا شيء مؤكَّدا في أيٍّ من هذه القصص، أو حتى في أي قصّة. نشيّد حيواتنا وأقدارنا على قواعد هشّة، مصنوعة من كُتَلِ واقعٍ مجبولة بطين الأساطير ». جملة نقرأها في رواية الكاتب اللبناني شريف مجدلاني الجديدة، « الإمبراطور مترجّلاً » (دار « سوي » الباريسية) ولا تلخّص مضمونها الغني بالقصص والأحداث والشخصيات بقدر ما تلخّص واحدة من الرسائل المهمة العديدة المسيَّرة داخلها.
وتجدر الإشارة بدايةً إلى أن المحرّك السردي في هذه الرواية هو نفسه الذي اعتدناه في روايات مجدلاني السابقة، أي تلك الرغبة في تسليط الضوء على قدر شخصية خيالية - واقعية تحملها طموحاتها الكبيرة على خطّ مسارٍ حياتي فريد ومليء بالمغامرات والإنجازات. أما جديدها فيكمن في المواضيع المقاربة فيها وأيضاً في مدى تطبيع الكاتب « وصفته » الروائية وتعقيدها من أجل سرد ليس فقط قصة شخصية واحدة نموذجية في طابعها المغامر، بل مجموعة شخصيات من هذا النوع تنتمي إلى أجيال عدة من عائلة واحدة.
تنطلق أحداث الرواية عام 1835 مع حضور رجلٍ يدعى خنجر جبيلي إلى بلدة مصيف التي تقع في أعالي منطقة كسروان اللبنانية، برفقة أولاده الثلاثة. حضورٌ يصوّره الكاتب كوصول فاتحٍ نظراً إلى قامة هذا الرجل الضخمة وسطوة شخصيته الملغَّزة والأساطير التي تحيط بشخصه. ولذلك، يلقّبه أبناء البلدة بسرعة بـ « الإمبراطور المترجّل ». لقبٌ يناسبه جيداً لأنه أتى إلى هذه البلدة لتأسيس « مملكة » له ونحت أسطورته. وهو ما سيتمكّن من إنجازه عبر إقناعه أحد إقطاعيي المنطقة بتسليمه أراضي « جبل صافية » لزراعتها. فمع أن أراضي هذه المنطقة وعرة وغير قابلة للزراعة، ينجح خنجر في مهمّته، ثم يتملّك هذه الأراضي بعد تشييده منزلاً له في مرتفعاتها، قبل أن يستفيد من مقتل جابي الضرائب ليحلّ مكانه. أما أوج قوّته فسيبلغه في السنوات الأخيرة من حياته، إثر اندلاع ثورة الفلاحين في جبل لبنان عام 1859 وطلب آل الخازن حمايته.
لكن قبل وفاته، ومن أجل الحفاظ على إرثه الضخم داخل العائلة، يفرض خنجر على أبنائه وأحفاده قاعدةً غير قابلة للنقاش : فقط الابن البكر له الحق في الزواج والإنجاب، أما أخوته وأخواته فمهمتهم معاونته في إدارة أملاك العائلة. وهذا ما سيحصل على مدى خمسة أجيال، علماً أن ذلك لن يتمّ من دون اعتراض أو تمرّد على هذا المحظور، وأن الأشخاص المغامرين مثل خنجر داخل سلالته لن يكونوا الأبناء البكر، على رغم مقارعة هؤلاء الأخيرين إياه سواء في طموحاتهم المادّية أو في عنفهم.
وفي هذا السياق نطّلع، بعد قصة خنجر وأولاده، على قصة زيد، ابن حفيده معن الذي حرمه أخيه البكر من حقّه في الإرث لتزوّجه وإنجابه. حرمان يدفع بزيد إلى السفر في صباه إلى إيطاليا حيث يعاشر أبرز العائلات الأرستقراطية، قبل أن يتوجّه إلى المكسيك ويتمكّن من إنجاز ما أنجزه خنجر قبله، لكن من دون أن ينعم يوماً بذلك قبل مقتله. كما لو أن لعنة هذا الأخير لحقت به إلى المكسيك وجعلته يشعر بحالة نفي حتى في قلب نجاحاته.
بعد ذلك، نطّلع على قصة شهاب، ابن عم زيد، الذي يقوده شغفه بمؤسّسي الممالك القديمة إلى التوجّه عام 1919 إلى دمشق للالتحاق بجيش الأمير فيصل، لظّنه أن هذا الأخير تمكّن من حشد جيشٍ شبيه بجيش الإسكندر المقدوني أو نابوليون. لكن الخيبة التي كانت تنتظره هناك تدفعه إلى الانتقال إلى بغداد ثم طهران حيث يتصادق مع الأرستقراطي الروسي غريغري سيليمنوف الذي فرّ من بلده بعد الانقلاب البولشفي. وبعد توقّف سريع في أصفهان وبرسبوليس، يقرر الصديقان الالتحاق بأحد قادة الجيش الروسي الأبيض، بريمرغين، الذي كان يتنقّل في سهوب كازاخستان على رأس بعضة آلاف من الفرسان القوزاق. مغامرة مدوخة يخوضها شهاب فقط من أجل « بلوغ لحظة سامية نادرة من التأمّل في العالم بعيني ملكٍ فاتح »، وتنتهي بموته في لبنان بحادث سيّارة مروّع.
لكن القصة الأجمل تبقى تلك التي نتعرّف فيها إلى نوفل، ابن أخي شهاب، الذي ستنقلب حياته رأساً على عقب حين يختبر قصة حب مستحيلة مع شادية، ابنة زوجة أبيه الثانية، فيغادر لبنان عام 1946 إلى بروكسيل، ثم إلى أنفرس فباريس حيث يمضي وقته في الشرب في الحانات ومعاشرة مختلف أنواع النساء، قبل أن يتعرّف إلى بيكاسو ويروي له أساطير لبنانية توحي للفنان بلوحته « نساء وسَتير يرقصون قرب شجرة تين ». بعد ذلك، ينتقل إلى الشاطئ اللازوردي حيث يعاشر الطبقة الثرية ويتابع مغامراته العاطفية، قبل أن يقوده بحثه عن لوحة ضائعة للفنان فيرونيز إلى البندقية فمدينة كوتور في يوغوسلافيا الشيوعية التي يتمكن من دخولها بمساعدة الشاعرين إيلوار وأراغون. وإثر فشل هذا البحث، يتوجّه عام 1948 إلى اليونان للقاء زعيم « جمهورية الجبال »، الثوري ماركوس، فيقع في حبّ فتاة يونانية مناضلة ويُقتل في قصفٍ جوّي برفقتها.
ويختتم مجدلاني روايته بقصة رائد، ابن أخي نوفل، الذي سيلتحق في مطلع السبعينات بمنظمة شيوعية فلسطينية راديكالية إشباعاً لرغبته في المغامرة وقلب التاريخ وعيش أشياءٍ كتلك التي كان يقرأها في الكتب. لكن اندلاع الحرب الأهلية في لبنان وعنف التجاوزات التي سترتكبها الأحزاب والمنظّمات الضالعة فيها تدفعه إلى المغادرة وتمضية سنوات طويلة في الخارج متتبّعاً أثر نوفل وشهاب وزيد، قبل أن يعود بعد الحرب ويضع حّداً للعنة سلفه خنجر.
باختصار، رواية تمسك بأنفاسنا حتى الصفحة الأخيرة سواء بالمغامرات والرحلات المشوّقة المسرودة فيها، أو بنثرها السيّال والرشيق، الشعري تارةً والتأمّلي تارةً أخرى. ولسرد قصصها، يستعين مجدلاني بمصغٍ تقتصر مهمته على نقل ما يرويه شهاب لوالده عن جدّه خنجر وابن عمه زيد، وما يسمعه بنفسه عن شهاب ونوفل ورائد وسائر أفراد آل جبيلي من رائد بالذات، وهو ما يمنح عملية السرد حيوية الحكاية ويفسّر طابعها الآسر.
لكن قيمة هذه الرواية لا تكمن فقط في طبيعة سرديتها وبنيتها المُحكَمة وثرائها بالقصص، بل أيضاً في المواضيع الكثيرة التي يقاربها الكاتب من خلال هذه القصص. فقصة السلف خنجر تسمح له بتسليط ضوءٍ كاشف على طبيعة الروابط الاجتماعية والمذهبية في جبل لبنان في القرن التاسع عشر. وعن طريق قصّة زيد، يطلعنا مليّاً على وضع الطبقة الأرستقراطية في إيطاليا عند مطلع القرن الماضي التي كانت متشبّثة بامتيازاتها وطريقة عيشها لشعورها باقتراب نهاية عهدها، كما يطلعنا على وضع المكسيك والعنف الذي كان متفشّياً فيه آنذاك. وعبر أسفار شهاب ونوفل، يقطّر تفاصيل مثيرة ومنيرة حول أحداث تاريخية مهمة شهدها عالمنا خلال النصف الأول من القرن الماضي.
أما قصة رائد فتوفّر له فرصة للتوقف عند فصل الحرب الأهلية في لبنان وتصوير نتائجها المأساوية على أبنائه، وخصوصاً على مواقعه الطبيعية التي شهدت تشويهاً يتعذّر إصلاحه. وفي هذا السياق، نشير إلى أن الرواية تشكّل أيضاً نشيداً لجمال الطبيعة التي يوقّع وصفها المتواتر والجميل عملية السرد ويمنح القارئ فرصة لالتقاط أنفاسه.
وفي حال أضفنا استعانة مجدلاني بكل هذه القصص لإظهار، من جهة، عنف الإنسان المزمن والمتفشّي في كل مكان، ومن جهة أخرى، دور الخيال أو الاستيهام في عملية تشييد الماضي أو التاريخ، لتبيّن لنا مدى ثراء روايته التي يتعذّر هنا التوقف عند كل مصادره.
"الحياة" صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت "الحياة" سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت "الحياة" لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت "الحياة" منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت "الحياة" وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل "الحياة" رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم "الحياة" نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.