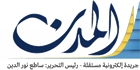جريدة المدن الألكترونيّة
الجمعة 10-03-2017
الصفحة : ثقافة
شريف الشافعي
"في فمي لؤلؤة" لميسون صقر.. رواية الغوص المتعدد

"لا تذوب اللآلئ في الفم، مثلما أنها لا تتلاشى في ماء البحر، ذلك الذي خلا من الصيادين التقليديين، وامتلأ بحقول النفط. الفم المتعطش للآلئ، عليه بالغوص في عمق البحر، فليس قرب الشاطئ إلا الزبد. اللآلئ في الفم حياة كاملة لا ترتضي النهايات، وعالم متجدد غير قابل للهدم. هذه اللآلئ “الطبيعية”، ليست مجرد خيالات يحلم بها الحالم (الذي ينثرها من فمه، في حلمه، والناس يأخذونها منه فإنه “قاضٍ يعظ الناس، والناس ينتفعون به”، وفق تفسير ابن سيرين)، ولا هي مجرد “كلام يضيء بمفردة واحدة” (كما في قصيدة محمود درويش).
في رواية “في فمي لؤلؤة” للكاتبة الإماراتية ميسون صقر (*)، تحل “المغاصات” محل الفصول، وهي “أسماء عامية لأماكن الغوص واصطياد المحار”، وفي مفتتح كل مغاصة من المغاصات الست في العمل، هناك عبارة مفتاحية، تفجّر المدارك وتفتح المدارات أمام التجليات العُليا لتلك اللآلئ التي تختزل الحياة وتختزن الوجود. ابن سيرين، ومحمود درويش من بين أصحاب هذه العبارات الناضحة بالدلالات والتأويلات. جلال الدين الرومي بدوره حاضر، ثم يأتي الكتاب المقدس، والقرآن الكريم، ليضفيا قدرًا من “القداسة” و"الخلود" على تلك اللآلئ، وكيف لا، والحور العين أنفسهن “كأمثال اللؤلؤ المكنون”؟
لقد أرادت الكاتبة أن تتيح في روايتها فتوحات أكبر وفضاءات أرحب للآلئ، التي تتمركز كمحور للكون تدور حوله الموجودات وتتعاقب دورات البهجة والشقاء والحياة والموت للكائنات، وتتحدث تلك اللآلئ عن ذاتها في حقيقة الأمر، بدون صوت، أكثر مما يتحدث عنها صيّادوها من الفقراء والمقهورين عادة (الذين قد يدفعون أرواحهم ثمنًا لها)، وأكثر مما يحكي مقتنوها من الأثرياء والملوك والنبلاء وأصحاب المتاحف وصالات المزادات.
بل إن لؤلؤة واحدة قادرة على تحويل “المتسول” إلى “أمير”، في لحظة ما، استثنائية، تنقلها الكاتبة في تقديم روايتها، نقلًا عن “روبرت براوننغ”، الشاعر والكاتب الإنكليزي (1812-1889): “هناك لحظتان في مغامرة الغواص، واحدة يكون فيها متسولًا وهو يستعد للغطس، وواحدة يكون فيها أميرًا حين يطفو حاملًا لؤلؤته”.
غلاف الرواية، بصورة الممثلة مارلين مونرو متقلدة عقدًا من اللؤلؤ الأبيض وافر الحبّات، مع ابتسامة تتجلى فيها كذلك أسنان لؤلؤية ناصعة، يحيل إلى ذلك العناق الأزلي بين “اللآلئ” و"الجَمال"، فرهان الكاتبة دائمًا على تلك الجماليات، الظاهرة والكامنة، للآلئ الفريدة، تلك التي سحرت جميع شخوص الرواية، من صيادين وأصحاب مراكب يتقاتلون على اللؤلؤة الأم العظيمة، ونساء يتكالبن على التزين بها، وفتاة من العصر الحديث اسمها “شمسة”، تعد دراسة نظرية وعملية عن صيّادي اللؤلؤ، وتستدعي التاريخ من خلال حكايا أمها، وقراءاتها المعرفية والبحثية، وتخيلاتها الشخصية. هذه الفتاة العصرية، التي تستخدم الكمبيوتر والإنترنت وتؤمن بلغة العلم، اعترفت بوضوح لأستاذها بأن فتنة اللؤلؤ سلبتها عقلها: “تسلسلت الأشياء هكذا، وجريت وراء سرها، سر اللؤلؤ. بدأت أدخل المتاهة، متاهة الحب، والسر، والحياة. وددتُ لو كنتَ معي تسمع وترى. هل تعلم أن مارلين مونرو وضعت عقدًا من اللؤلؤ حول عنقها الجميل؟ مارلين مونرو رمز الغواية والإغراء تستعين باللؤلؤ لتثبيت الفكرة في الأذهان”.
هذه “الجماليات اللؤلؤية”، إذا جاز التعبير، في النص الروائي، أخصب وأعمق من مقدرتها على خطف عين الرائي وقلبه “لحظيًّا”، فلؤلؤة واحدة قد تحمل في طياتها مئات الأعوام من المعاناة والدموع والدماء، وعشرات الحكايا والأساطير المسكونة بالأوجاع، وربما بالموت. تقول: “كأن للموت جمالياته هنا، مروحة تتهادى مع الموج، رحلات الموتى في الذهاب إلى القاع، الرحلة الأخيرة للغواص، يذهب فيها ولا يعود بلؤلؤة أو محارة، يذهب ليصبح حارسًا للمغاصات التي نبشت. تقول المغاصات: هنا كانت يد تقطع محارًا، لتأخذ لؤلؤًا لامرأة غريبة. لكن البحر رغم ذلك كان كريمًا، هم يأخذون لؤلؤه، وهو يقبل جثامينهم دون اعتراض. هل اعترض يومًا؟ كلا، لم يعترض، بل كان يحاورهم، كي تظل فيه أجسادهم”.
بمثل هذه اللغة السحرية، السرية، يصير للبحر أيضًا حديثه الخاص، مثلما أن “اللؤلؤة” هي الصوت الأبرز في العمل الروائي، بوصفها البطلة الفعلية، وتتكشف تدريجيًّا من خلال تفاعلات الشخوص وأضواء اللؤلؤة وبوح الأمواج، عوالم منطقة الخليج العربي من خلال تصوير حياة صيادي اللؤلؤ البسطاء، ومكابداتهم مع الحرفة التقليدية التي امتهنوها على مدار مئات السنين، حتى بدأت في التلاشي في القرن العشرين، مع ظهور “اللؤلؤ الصناعي”، وسيادة عصر النفط، كما توضح الرواية في حدثها الختامي، إذ عاد “الصياد مرهون” إلى وطنه بعد سنوات من الاغتراب في الهند: “نظر مرهون أمامه، كانت المدينة مختلفة عما تركها، ما عادت هناك عرائش ولا خيام، بل بيوت وعمائر أسمنتية، كيف لم ينتبه وهو قادم لكل هذا التغيير؟ قال له الرجل: تأخرتَ سنوات وسنوات، يا النوخذة الجديد، تأخرتَ وتغيرنا”.
في هذا العمل الروائي الزاخم، تقدم الكاتبة ميسون صقر ما يمكن وصفه بالجدارية التشكيلية، إذ تتجاور مشاهد بانورامية، تتمحور كلها حول صيد اللؤلؤ الطبيعي بالطريقة التقليدية، لكنها تنتمي إلى حقول متباينة. لكأن هناك مخرجًا للعمل، يصوّره بأكثر من كاميرا، ويختار في كل مشهد: أية كاميرا هي التي تنقل الصورة الرئيسية، فيما تظل بقية الكاميرات كخلفيات، أو تغيب جزئيًّا بعض الوقت.
هناك، على سبيل المثال، “شمسة”، الفتاة العصرية، التي تعد دراسة عن صيد اللؤلؤ، ولا تكتفي بالجانب النظري، فتعيش في خيالاتها قصص الصيادين القدماء وزوجاتهم، المليئة بالصراعات والخيانات والدم، التي ترويها لها أمها. هذه الفتاة، التي تسرد بعض الفصول، تمثل كاميرا الحداثة المطلة على الماضي بوصفه تاريخًا. وتبدأ الرواية بانبهارها بالعقد التاريخي في سحّارة أمها، ذي اللؤلؤات الساحرة، ومن ثم تحكي لها أمها عن تاريخ اللؤلؤ. وتنتهي الرواية بتنازل الأم عن عقد اللؤلؤ للمتحف، ليوضع في مكانه الطبيعي، فلم يعد محتملًا أن ترتدي الأم في رقبتها “تاريخًا للغبن والقهر”.
في حين أن كاميرا أخرى تنقل، بالأبيض والأسود، بعض الفصول من قلب التاريخ ذاته، مصاحبة أجواء الصراعات الحمراء على الجواهر واللؤلؤة الأم العظيمة من داخل الأحداث الدرامية الملتهبة في عهد المعتمد البريطاني في الإمارة والحروب والقبائل المغيرة، وهذه الكاميرا الحية هي التي سجلت الوقائع الأبرز في العمل، وجسدت بحرفية قصة عشق “آمنة” لمرهون الصياد، وكيف أنها هربت من زوجها يوسف، الذي سرق اللؤلؤة العظيمة وسكت عن قتل الأبرياء المتهمين بسرقتها، لتذهب وراء مرهون إلى الهند، ومعها لؤلؤة الفتنة، التي تتأسطر حولها الأحداث، إذ يذهب يوسف وراءهما للانتقام، ويقتل آمنة، ثم يموت قتيلًا هو الآخر، وتنجو اللؤلؤة، ويعود مرهون إلى وطنه حالمًا بمعاودة الصيد من جديد بدلًا من التجارة، لكن في ظل ظروف أفضل وعدالة اجتماعية ومراعاة لأحوال الصيادين القاسية، حيث كانوا يعملون بالسخرة، ويتعرضون للتعذيب والقتل إذا لم ينفذوا الأوامر، لكنه يكتشف أن عصر اللؤلؤ قد انتهى إلى غير رجعة.
وهكذا، تتعدد الكاميرات والدفقات المشهدية المتتالية كموجات بحر متلاحقة، ويتسق هذا التكنيك مع ما تقترحه الكاتبة في عملها الكبير الصاخب، من غوص متعدد الأعماق من جهة، ومتعدد الأشكال من جانب آخر. “الغوص” هو الكلمة المفتاح، التي لم تستدعها الكاتبة من الأقاويل المأثورة، لكنها الطاقة السحرية التي تصل بها إلى ذلك “الما وراء” المراد من كل حكاية ومشهد وتفصيلة.
“في فمي لؤلؤة”، رواية ليس أكبر همها نقل الحدث، إنما الفلسفة الكامنة وراءه. لو أن صيادًا غطس وعاد بلؤلؤة، لكان أمرًا مكرورًا حال نقله حرفيًّا، لكن ما يستوقف الرواية أمام حدث كهذا، على سبيل المثال، هي تساؤلات من قبيل: ماذا قال البحر للغواص؟ ماذا بقي من جثامين من رحلوا في طيات المد والجزر؟ هل مع تحلل الخلايا الحية في المياه، تتحلل المشاعر الإنسانية والعواطف؟ هل اللؤلؤات المتشكلات في البحر، يتكونّ من بقايا الكائنات الذائبة، وأيضًا من هذه المشاعر؟
هناك مستويات متباينة الأعماق للغوص، في العمل الروائي المحتفي بالتأملات الإنسانية، وجدليات الفلاسفة، وإشراقات المتصوفة. مصائر البشر، يتم تقصيها بأناة واصطبار، من خلال ترصّد دورانهم الطويل حول اللؤلؤة “المركزية”، وصراعاتهم المتصاعدة بتشويق: “الكل يلهث وراء اللؤلؤة، يرى أنها ملكه، أنه صاحب الحق فيها، وللأسف كلهم مدّعون. مرهون، الرجل الوحيد الذي جلبها من قاع البحر وكاد يفقد حياته بسببها لم يتكلم، بل لم يهتم. مرهون، مالك اللؤلؤة، هل ينصفه الحلم أم النسيان؟ حكايات وحكايات كلها يختلف عند بداية الجزيرة والقتل لتنغمس الحقيقة في تراب الذكريات”.
إنها اللؤلؤة الطبيعية، الحقيقة التي لا يقوى على امتلاكها أحد، فتبيت محفوظة في النهاية في درج من أدراج التاريخ، تطالعها العيون من كل حدب وصوب للتأمل، وتتعدد حولها الشروح والتأويلات. من أجلها، طرحت الرواية أشكالًا لا نهاية لها من الغوص، فهناك، على سبيل المثال، الغوص الفلسفي، والغوص الأسطوري، والغوص التاريخي، والغوص المجتمعي، والغوص النفسي، والغوص الحلمي، وغيره، وهناك دائمًا الغوص الجمالي، في أسرار اللؤلؤة، وكل ما/ ومن يتعلق بها، ويدور حولها، مهما نضح بالألم، على غرار مرهون: “بعض حكاياته ممتع، وبعضها مؤلم وإنساني، لكنه وهو يحكي تتسرب متعة غير الاكتشاف، متعة أن يتحدث شخص من الماضي، خفي لكنه ممتلئ بالإنسانية”.
أما الغوص الشعري، فهو فاكهة الرواية، لما للكاتبة من رصيد لافت في هذا المضمار، ويتقطر الشعر ليس فقط من خلال المعزوفات الغنائية المنفردة، وما أكثرها، وإنما أيضًا من خلال لغة السرد، ومفارقات المواقف، بل وعبر فيوضات الحوار، كأن تقول الأم لابنتها التي تتساءل عن كيفية ارتداء الأم العقد، ذا التاريخ العميق والمؤلم، دون أن ينحني رأسها: “شرف لي أن أحمل تاريخًا للوجيعة يا حبيبتي”.
هذه الشعرية “الخام” لدى الشخوص، هي الوجه الآخر للمحارات الطازجة المحتوية اللؤلؤات الحية، فإذا تحدث البحر، فهو بالضرورة شاعر هو الآخر: “ما لا تعلمه يا مرهون، أنني كبير وكريم لكم. أجسادكم حين تصل إليَّ بلا أرواحها، تظل شجرًا مائيًّا فيَّ دون أن أعترض. كم من جسد سُجّي هنا؟ العالم، الكون الذي يحتويني. أنا البحر العميق أعمق من مجرد بعض أجساد لا تحسب. أنا كون غاضب سخيّ يا مرهون. أنا البحر الذي لا أظنك تعرفه. أنا كون قائم بذاته، لي عوالمي وكائناتي ونباتاتي. أنت مجرد قاطع طريق سمحتُ له بسرقة بعض لؤلؤ مني”.
(*) صدرت عن “الدار المصرية اللبنانية” في عام 2016، ووصلت مؤخرًا إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب (فرع الآداب، الدورة الحادية عشرة، 2016-2017).
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.
الأربعاء، ٨ مارس/ آذار ٢٠١٧
جريدة الحياة
عمر شبانة
ميسون صقر تنقّب في لؤلؤ الإمارات
كما في روايتها الأولى «ريحانة» (روايات الهلال، 2003)، تنشغل ميسون صقر في روايتها الثانية «في فمي لؤلؤة» (الدار المصرية اللبنانية، ضمن القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2017)، بأسئلة كثيرة وهاجسين. الهاجس الأول متعلّق بوطنها الأول، بماضيها وطفولتها، يأتي عرضه- في الروايتين- من خلال الهاجس الثاني المتعلّق بمكان إقامتها الدائم، مصر (القاهرة) التي باتت أساساً عضويّاً في تكوين هذه المبدعة، ثقافياً واجتماعياً.
تقوم الرواية الجديدة على تقنية «رواية داخل الرواية»، وتضمّ حكايتين- روايتين متداخلتين. الأولى هي حكاية شمسة، ابنة الديبلوماسيّ المتنقّل بين الأردن ومصر ثم الصين. تعيش في القاهرة مع والدتها وجدّتها، وتحاول البحث في ماضيها، من خلال دراستها في الجامعة المصرية، وهو ما يسمح بتقديم «رواية» مصرية، تتصل بجوانب من الحياة السياسية والاجتماعية المصرية. والحكاية الثانية هي التي ترويها «الجدّة»، منطلقة من «العقد الفريد» الذي ترتديه الوالدة، حكاية تصوغها شمسة، وتتضمن مجموعة كبيرة من حكايات «مجتمع» هو سفينة النوخذة أبو حمد، والعاملون معه.
«في فمي لؤلؤة»، أو في فمي كلام كثير، لا أستطيع إطلاقه. هذه خلاصة من بين خلاصات كثيرة تريد رواية ميسون صقر أن تقولها. ففي المأثور الشعبيّ الإماراتيّ، كما يَرِد في الرواية، يضع الشخص في فمه لؤلؤة، كي لا يتكلم إلا القليل، والضروريّ فقط. تصف الراوية لحظة اعتراف آمنة، بطلة في الرواية، بحبّها لمرهون «وضعت لؤلؤة صغيرة في فمها، حتّى لا ينزلق الكثير من الكلام، وباحت: يا مرهون ترى أنا أحبك». وفي سعيها نحو معرفة تاريخ «عقد لؤلؤ» ترتديه والدتها، وهو «تاريخ الغبن والقهر»، تبذل شمسة (بطلة الرواية) جهوداً مُضنية في بحثها عن «لؤلؤة مفقودة» من العقد. وما هذه اللؤلؤة المفقودة، سوى ذريعة للدخول في سياقات البحث في هذا الماضي، وذلك التاريخ.
تحديات البحث
تبدأ الرواية في التشكّل، منذ اللحظة التي فيها تقرّر شمسة، طالبة الماجستير في قسم الأنثروبولوجيا أن تتحدّى أستاذها المشرف عليها، عز الدين عبد الفتاح، كي تكتب رسالتها- البحث في صورة غير أكاديمية. صورة تمزج الأكاديمي بالإبداعي، لتمنح البعد الإنساني في الرسالة، مساحة أوسع من البعد الأكاديميّ «الجافّ»، الأمر الذي استدعى خلافها مع الأستاذ، بل الهروب إلى ما تبتغي تحقيقَه بأسلوبها، ووفق قناعاتها هي، وصولاً إلى سفرها إلى بلدها الإمارات حيث ماضيها وذكرياتها، بغية التواصل مع مصادر بحثها ومراجعه، لتخوض مغامرة البحث التي ستكون هذه الروايةُ محصّلة لها.
منذ وصول شمسة إلى الفندق الإماراتي، من دون تحديد اسم الإمارة، تبدأ أولى حلقات الفانتازيا الروائيّة. تلتقي في ردهة الفندق بأحد أبرز «أبطال» روايتها، الغوّاص الأسطوري مرهون. وسيتكشّف عن شخصيّة ذي بِنية أسطوريّة، بين عديد الغوّاصين، في حياة «مجتمع سفينة الصيد»، وفي علاقته الخاصّة مع البحر، واللغة المشتركة بينهما. تظل شمسة تطارد مرهون على الشاطئ المحاذي للفندق، بين الخيال والحلم، مثلما تلتقي بعض شخوص الرواية في صور شتّى، كأسلوب شائق من أساليب السرد والبناء الروائي الغرائبيّ.
شمسة هذه، وللاسم دلالاته في الإضاءة على التاريخ، مهجوسة بماضيها على نحو مَرَضيّ، مشوب بالاضطراب. لذا فإنها تتلقى علاجاً، وهي وفق الطبيب تعاني من «رغبة التواصل مع روح الماضي» ومن «اضطرابات دمج الخيال بالواقع، والكذب بالحقائق، وطمس الألم فيهما». وهي من جهة ثانية، تعيش اضطراباً عاطفيّاً، فبعدما تحرّرت من علاقة مع سامح، الذي تحوّل نحو التزمّت، نجدها تقع في حبّ أستاذها الذي لا يقل تطرّفاً، لكنّه نوع من التزمّت الأكاديميّ. ما يجعلها تعاني في علاقتها الملتبسة معه، التباساً على المستويين الدراسيّ والإنسانيّ- العاطفيّ. ولكن في تطرّف سامح (غير المتسامح) إشارة إلى صعود ظاهرة التطرّف في المجتمع المصري، هذا المجتمع، والعالَم الذي تطل عليه الرواية من خلال عدد من الشخصيات، خصوصاً رفيقتها مروة وعائلتها وبيئتها.
عَبْر ست مغاصات- ستة فصول وستمائة صفحة، تغوص ميسون صقر في عدد من الأمكنة، وفي أزمنة متداخلة. فتقدّم مجموعة كبيرة من الشخوص وحكاياتهم. هي حكايات ذات بعدين، البعد الأول هو المعيشي اليوميّ البسيط، وهو الهامشيّ الذي لا ينفصل عن البعد الثاني، وهو الوجوديّ الأعمق والأساسيّ. وهذا الترابط بين البعدين، ينطبق على المكان، كما على الشخصيات. فعلينا ونحن نقرأ حيوات الشخصيات ومصائرها، أن لا نغفل التحوّلات الجذرية التي أصابت المكان- البلاد، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالانتقال من مرحلة الغوص من أجل صيد اللؤلؤ (الطبيعيّ) وتجارته، ودخول أشكال من اللؤلؤ المزروع (اليابانيّ)، وصولاً إلى زمن مختلف كليّاً هو «زمن النفط».
تنطوي الرواية على ثلاث من صور الغوص، أو أكثر. الصورة الأولى، هي الغوص لصيد المحار- اللؤلؤ، وتبدو منذ عنوان البحث الذي قدّمته شمسة إلى أستاذها «البحر ورحلات الغوص»، لكنّ الرواية التي تذهب عميقاً في هذا البعد من الغوص البحريّ الواقعيّ، وتعود بالكثير من اللؤلؤ الثمين، تذهب في الغوص «الفانتازيّ»، فتتغلغل في أعماق النفس البشرية لاستخراج لآلئها النفيسة. مثلما تغوص أيضاً، وهذا هو البعد الثالث للغوص، في تاريخ منطقة الخليج، وخصوصاً تاريخ الإمارات العربية قبل قيام دولة «الاتحاد»، وما شهدته هذه المنطقة من صراع مع الاستعمار، بسبب غناها باللؤلؤ أولاً، ثم مع بدايات اكتشاف النفط ثانياً.
مغامرة
هي مغامرة روائية على الصعيدين، البنائيّ والموضوعاتيّ. فمن جهة البناء، نحن حيال بِنية شديدة التشظّي، قائمة على بناء حكاية ثم محوها، وكأنها بِنية بَحريّة تعصف بها الأمواج، فكلّما استقرّت مراكب السرد وحكاياته في محطّة، عصفت بها حركات البحر وتوتّراته، فعادت الرواية لتبدأ من محطّة جديدة، حتّى يكاد القارئ يتشكّك في مصائر الشخصيّات، بل في أسمائها، فضلاً عن حقيقة وجودها أصلاً.
وعلى صعيد اللغة، ثمّة مستويات عدّة أيضاً، من اللغة الفصيحة أساساً، إلى اللهجة العاميّة، المصرية بين شمسة ورفيقتها مروة، والخليجية في عالم البحر والصحراء والمدينة، وإلى ذلك، هناك لغة ذات طبيعة روحانية، وصوفية أحياناً، تحضر في مفتتح بعض فصول الرواية حيناً، كما يمكن أن تتلمّسها في غلالة شعرية تهيمن على لغة الرواية عموماً، بما يحيل إلى عوالم ميسون صقر في مجمل نتاجها، فهي سرديّة في الشعر، شاعرة في السرد.
تتنقّل الكاتبة بين زمنين، زمن رحلة شمسة الدراسية والإبداعية المضطربة والمتوترة، وهو الزمن الراهن، من دون تحديد سنوات أو حوادث بارزة، وزمن حياة شخوص الرواية، قبل سبعينات القرن العشرين. عودة إلى قرون خالية في مجتمع البحر والغوص، وما تنطوي عليه كل شخصية من نزوعات بشرية، واضطرابات نفسانيّة وروحانيّة تأخذها مآخذ شتّى. وفي تنقّلها هذا، تستخدم أساليب السرد المتعددة والمختلفة، معتمدة الحوارات الثنائية (الخارجية)، والمونولوغات الداخلية، مع استخدام كثيف وموسّع للوثائق والمادة التاريخية، إلى درجة لا نكاد نجزم معها بحقيقيّة الوثائق، أم أنّها مجرد أسلوب سرديّ. لكنّ الحجم الهائل من المعلومات، يحيل على عملية بحث واسعة وعميقة قامت بها الكاتبة لإنجاز عملها هذا، وهو ما يتّضح في «المراجع» المشار إليها في نهاية الرواية.
تبني شخصية شمسة، وتكوينها ومساراتها ومآلاتها، بما يلائم بناء شخصية ذات أبعاد فردانية، منقطعة عن جذورها، من دون الانقطاع عن تراثها وتاريخها، شمسة التي تفصح عمّا تريد، بعيداً عمّا يريده الآخرون «إرادتي الآن، أن أهزّ بجذع حياتي عميقاً، حتى يساقط منها رطباً جنيّاً».
بينما يجرى استخدام الديالوغ أو الوصف، في ما يتعلّق ببناء شخصيات مثل آمنة ومرهون، على رغم ما تتميز به هذه الشخصيات من محاولات التمرّد و «الانخلاع» عن بيئتها.
فانتازيا وواقع
بين «مغاصات» اللؤلؤ الحقيقيّ، تعثر شمسة على «مغاصتها» الأهمّ، متمثّلة في مركز الوثائق والبحوث والدراسات. وفي هذا المبنى الذي تستعيد فيه بعض ماضيها وذكرياتها، تقيم الكاتبة حفل «الفانتازيا» الأبرز في الرواية. ففي جولتها، تتوقّف أمام أحد الأبواب، وإحدى الغرف، فتستمع إلى أصوات آتية من الماضي.
وقريباً من هذه الفانتازيا، وعلى نحو مختلف، حيث يمتزج الفانتازي بالواقعي والتاريخي، ما سيجرى في معرض للصور، لمصوّر بريطانيّ، هو شخصية روائية بين المتخيّل والواقعي، كان على سطح سفينة أبو حمد، هو وليم جورج، أو لعلّه مبارك بن لندن، فهي «تغمغم» في هذا الجانب، حيث تشاهِد شمسة صورة العقد الذي تمتلكه والدتها، وتتصرف على نحو شديد الغرابة، وبما يشبه حالة «غيبوبة»، في حضور وسائل الإعلام، فتُحدث بلبلة إعلامية، تصل إلى شاشات التلفزة، ما يتسبب في تفكيرها في إنهاء رحلتها.
وعلى رغم هذا الكمّ الهائل من التاريخ، من الرسائل والوثائق، فالكاتبة (شمسة- ميسون) تترك هذا كله جانباً، لتكتب ما يعبر عن اليوميّات والذاكرة. المادة التاريخية بالنسبة إليها «معاشة من التجربة الإنسانية، لا كمادة ارشيفية»، وثمّة تواريخ وحيوات عدّة متداخلة، تريد من خلالها التعبير عن ذاتها وحريتها. وما اختيارها لشخصية آمنة، سوى تجسيد لخيار البحث عن وسيلة لتحقيق الذات. ولهذا فهي ترسلها في رحلة- مغامرة إلى الهند، إذ تهرب من زوجها الغوّاص يوسف، بسبب عنفه معها أولاً، ولشخصيّته الانتهازية، وخياناته حتى للنوخذة الذي ربّاه.
هروب
تهرب آمنة مع سفينة عسكرية بريطانية تقودها كاترين، المتخفية في صورة قبطان رجل، وهي تحمل «اللؤلؤة المفقودة» التي كان مرهون عثر عليها، وسلّمها للنوخذة، ثمّ سرقها زوجها يوسف وأهداها لها. وفي رحلة هروبها تتخفّى، وتنقطع عن بلدها وعالمها، وتتحوّل إلى «تاجرة» ثرية، وتلتقي بمرهون في الهند، وتعلن له حبّها، قبل أن تنتهي مقتولة بخنجر زوجها (يوسف) الذي استطاع التوصّل إليها في كيريلا الهندية. وتخوض آمنة مغامرة الهروب هذه، كما تقول، ربما لكي «تمحو ذاتها، وتصبح ضمن هذا العالم الواسع، ربما تنجز ما كانت تحلم به في عرض البحر». وهي الرغبة نفسها لشمسة في محو ذاتها الراهنة، بحثاً عن ذات مستعادة من طفولتها.
وكما تأخذنا الرواية إلى المجتمع الهندي، عبر الإمساك بخيوط الحياة في هذا المجتمع المختلط، تأخذنا مع الرحالة البريطاني وليم جورج وعشيقته فكتوريا، إلى كينيا وأفريقيا، لنعيش الصراع بين الاستعمار العنصري وأهل البلاد، حيث الغيتو الخاص، وأعمال النهب وتجارة العبيد والأسلحة والعاج، والبدائية والعنف، ضمن ملفّ يتضمّن معرفة واسعة ومعمّقة بهذا العالَم الغريب.
تحضر في الرواية عوالم من الحياة والمجتمع الإماراتي عبر رحلة في كثبان الرمال، مع شعراء النبطية. وتتخيل الشاعر خلفان الذي ترك الصحراء ليختفي في البحر، فتقدّم مَسردًا تفصيليّاً عن سلالات النوق وأنواعها. وتنتهي مع مرهون، الاسم الذي يحيل على شخص «رهن الذاكرة». مرهون الذي حاول التخفّي وراء اسم بلال، وعاد من الهند ليبدأ حياة جديدة، حالماً أن يكون «نوخذة»، فيتدرّب على المهنة مع سفينته العُمانية «الغراب»، ليكون «أمير البحر، صديق ابن ماجد»، ولكن «متأخّراً»، ومع ظهور «ماكيموتو» (اللؤلؤ المزروع)، ومع تحولات كثيرة في البلاد، حيث الفقر يدفع الإماراتيين للهجرة إلى الكويت والبحرين للعمل في النفط. وهنا تنقض شمسة الروايات كلها، وتعود إلى القاهرة هي وصديقتها المصرية رفيقة السفر مروة.
“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.