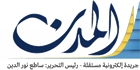جريدة المدن الألكترونيّة
الثلاثاء 13-11-2018
المدن - ثقافة
أسامة فاروق
سحر خليفة تروي سيرتها الذاتية.. بالفضح أم بالصدق ؟!

"ما عدت أحس بالآخرين إلا حين أكتب عنهم. فهم في الواقع ما كانوا سوى منافسين، وكنت أتغلب عليهم. لا وقت عندي للحب، ولا للمشاعر، ولا للقرابة، ولا للصداقة. لا أحد سواي وسوى ديبورا. حتى ديبورا غابت فذابت، وبقيت أنا، أسير في الدرب وحيدة بقلب مقفر. لا أحد معي، لا أحد سواي، لا أحد لي، ولا أرى إلا ظلي".
(سحر خليفة - “الميراث”).
هل كان على سحر خليفة أن تكون حادة وقاسية تجاه الجميع هكذا؟ تلوح بقبضتها حتى تجاه من ساعدها في بدايتها، من أناروا لها الطريق، ومهدوا لها طرقاً غير مأهولة؟! هل كان عليها أن تكون واضحة في سيرتها إلى هذا الحد، صادقة بهذا القدر، كاشفة عن كل مكنون صدرها بلا حذر أو خجل أو تردد؟
لكن، لماذا تتردد في حين أن الحياة نفسها لم تكن خجولة في فرض قسوتها عليها، ولم تتردد في صب أزمات لازمتها منذ الطفولة، لم تسألها رأيها في هجران الأب، وقسوة الأم وفساد الزوج، وفوق هذا كله احتلال تعاني نكبته حتى الآن.
كان يمكن لسحر خليفة أن تستسلم لدور الضحية، وهي كذلك فعلاً، فلن يلومها أحد. لكنها تكتب في ملعبها، كما يقال. هنا هي ليست ضحية، هنا -وربما هنا فقط- تستطيع أن تنتصر لنفسها وقضيتها.
لهذا يتداخل التاريخ الشخصي مع العام مع التاريخ الروائي في “روايتي لروايتي”(*)، حتى يصعب أحياناً الفصل بينهم جميعاً، بل ربما هم شيء واحد منذ البداية، المَشاهد والأحداث الحقيقية، تصبح صفحات في رواية بأبطال جدد ومشاعر جديدة. مسار جديد تخطه بيدها هذه المرة. يصبح الأمر صادماً فقط حينما يتجاوز الألمَ الحقيقيَّ، ما تم تدوينه في الروايات. لذا، فالكتاب ليس فقط أحد أجرأ السير العربية وأصدقها، بل ربما لا تصلح قراءة أعمال سحر خليفة إلا بعد المرور به. فهو كدليل العلامات في الخرائط، مع كل ندبة تسببها الحياة، عمل جديد، يعطى الكتاب تاريخ الندبة وأسبابها، وحتى الصفحات التي كتبت فيها وبسببها. يوضح مساحات أخرى في أعمال سحر خليفة، يضيء المعتم، ويفسر الغامض، ويوسع التفسيرات حول ظروف الكتابة وأماكنها، وحتى وضع الكاتبة نفسها وقت الكتابة.
يقفز الكتاب فوق الولادة الأولى، ويبدأ مع الثانية، مع الحصول على الطلاق في الثانية والثلاثين من العمر، وينتهي مع قرار العودة من أميركا بعد مِنحة دراسية في خريف 1978. وفيه تحكى سحر خليفة قصة روايتها الضائعة، وأولى رواياتها المنشورة، القصص الواقعية التي صاحبت “لم نعد جواري لكم” و"الصبار" و"مذكرات امرأة غير واقعية" وحتى “الميراث”. قصص الهجر والصدمة والحب، وتطور آليات استقبال القسوة والتعامل مع الخذلان.
من دار العائلة، فوق الجبل الشمالي من نابلس، تبدأ الحكاية، مع والد عصامي أصبح من الوجهاء، بعدما بدأ حياته يتيماً فقيراً، سرق تَرِكته من كان بمثابة الخال “رجل نصَّاب بعمامة، وامرأة ساذجة أمّية، وأطفال صغار بحكم القٌصّر. ولأن الأرملة خافت على ميراث القٌصّر من وصاية الأعمام، لجأت إلى خالها المعمم وخبأت لديه ما كان تحت البلاطة من عثمليات، أي مجيديات عثمانية وليرات ذهبية، إذ لم يكن في ذلك الوقت بنوك ومصارف وما شابهها. أخذ الخال النصاب الليرات والمجيديات وأنكر ما أخذ، فباتت جدتي أرملة فقيرة وأمّاً لأيتام” (من رواية “أصل وفصل”).
تعلم الأب الميكانيكا، طوّر مهاراته وكبرت تجارته وأصبح من ملاك العقارات. الأم عربية تقليدية، لم تتعلم، لكنها تهوى الشعر وتحفظ منه مئات الأبيات. كارثتها الأكبر كانت إنجاب البنات، كانت تلك نكبتها التي عانت بسببها طوال حياتها، أنجبت ثماني بنات، ماتت اثنتان طفلتين، وذَكَر وحيد، دللته حتى أفسدته، فانكسر ظهره قبل أن يعدل ظهرها، وظل رهن كرسي العجلات طوال عمره وعمرها.
الضغوط الكبيرة وخِلفَة البنات، خلَّفت أمّاً عصبية متوترة، لا تقبل الخلاف والاختلاف، لذا توترت علاقتها بالابنة المتمردة التي عشقت الرسم والتلوين.. “لم تكن علاقتي بأمي سهلة، فقد كانت مليئة بالمطبات والعثرات. وحتى الآن ما زلت اعتبرها المسؤولة عما أصابني وأصاب عائلتنا من عدد لا بأس به من الانتكاسات والكدمات”. علّمتها الأم، من دون أن تدري، أنها من جنس آخر قليل القيمة، عديم النفع، وربما يستحق الرثاء. علّمتها أنها عورة، وتهديد محتمل لسمعة العائلة. ضغوط الأم صحيح خلَّفت ندوباً في جسد الابنة، لكنها في المقابل زرعت بداخلها أول بذور الرفض والتمرد، دفنت نفسها في القراءة والكتابة والرسم كوسيلة للهرب من هذا الجو الخانق، واللوحات التي أنتجتها وقتها تعبّر عما كان يدور في ذهنها الصغير من أفكار. “خلف الجدران” تمثل فيها فتاة صغيرة تنبطح على بطنها في أرض حديقة محاطة بالأسوار. وداخل الحديقة، خلف الجدران، ترتفع صفصافة تمد ذراعها نحو الداخل، والفتاة تنظر إلى ذاك الفرع وفى عينيها خوف ويأس وقلة حيلة. ولوحة ثانية أسمتها “متمردة”، تصوّر فتاة ذات قسمات حادة وعينين حمراوين، تشد قبضتها إلى صدرها كما لو كانت تتوجع من ضربة أو مرض عضال.
الزواج كان خطة العائلة للتخلص من الفتاة المتمردة، والأخيرة بدورها رأت فيه فرصة للخروج من جو المنزل الخانق، الخروج إلى العالم الرحب مع زوج عائد لتوه من سنين قضاها في أميركا، سحرها بعالم آخر مغاير لما نشأت فيه وللجو الذي اختنقت من تقلباته. لكن لم يمض كثير وقت حتى أدركت الفخ الذي وقعت فيه، تبخر الحلم. يقامر الزوج ويخسر، يستدين ويقترض ويتغير مزاجه وتفسد أخلاقه، ويحول حياتها إلى جحيم. في الوقت نفسه، يقرر الأب هجران الأم، والزواج بشابة في عمر بناته “لم أنم تلك الليلة. طوال الليل وأنا أبكي وأندب حظي، وحظ أمي، وأخي المشلول، وقطيع البنات. أمي الثكلى، وأخي العاجز، وأخواتي المتعثرات في زيجاتهن العشوائية المبتسرة، والخوف من زمن يغدر بنا وقد بتنا ولايا مقطوعات، لأن الوالد، سند العائلة، انتهى أمره، وأخي عاجز، وزوجي مقامر، وأخواتي كن في مهب الريح”.
نكبة العائلة تتزامن مع نكبة الأمّة، “معبود الجماهير” يعلن خطأه وسوء تقديره، ورغم ذلك تنزل الملايين في الشوارع تطالبه بالاستمرار والبقاء.. “هكذا استقبلنا استقالة عبد الناصر، بالدموع والأسى وإحساس باليتم، لأنه كان الأنبل والأخلص على الرغم من خطئه. وما زلنا نحس، معظمنا، بأن خطأ عبد الناصر مغفور، لأنه اجتهد ولم يفلح، بينما الآخرون لا يجتهدون، وعن سبق إصرار وترصد لا يفلحون”. هكذا استقبلت هزيمتها - التي لم تنفصل منذ ذلك الوقت عن هزيمة شعبها وأمتها. لكن كان للنكبة وجه آخر، عرّفها ربما للمرة الأولى على شعبها الحقيقي. نزلت إلى الشارع واحتكّت بالجميع، فتح الواقع القبيح عينيها على ما لم تكن تراه، ذابت وسط الجموع، وحاولت قدر طاقتها مساعدة النازحين والبسطاء، لتصطدم مجدداً بالواقع الاتكالي العربي القبيح، وباللعنات والاتهامات من كل جانب.
تركت هذا الواقع الساخن، عادت مجدداً إلى واقعها البائس، هذه المرة إلى ليبيا، مع زوجها الذي انتقل للعمل في أحد البنوك هناك.. “ذقت في ليبيا الأمرَّين.. جو مشؤوم من البداية. بيت فارغ وبلد غريب، ومال شحيح لا يكفي إلا للأكل، يادوب للأكل، ولا توجد أمّ ألجأ إليها لأشكو همي فتواسيني وتهون على، ولا أقارب، ولا حتى مكتبة البلدية أغرف منها الكتب التي شكلت لي لسنوات طوال، نوعاً من الهروب ومصدراً للعزاء”.
لجأَت إلى الكتابة للخروج من هذا الجو المشؤوم، في أثناء غياب الزوج تعود لقراءة الروايات والكتب ودواوين محمود درويش وسميح القاسم. تكتب قصائد، وتحاول أن تحكي بها حكايتها، لكن الصور كثيرة والمأساة متعددة الوجوه. فوجدت ضالتها في الرواية.. “المَشاهد التي تملأ رأسي بالصور والأفكار لا بد لها من مساحات رحبة، مرنة، تتسع لما هو أكثر وأغنى وأعمق من المشاعر، وأن نقاش ما وصل إليه بلدي وما وصلت إليه أنا يحتاج إلى القص والبوح والتحليل وتصوير المشاهد والشخصيات”. كتبت الرواية خلال السنة الأولى من مكوثها في ليبيا، استرجعت فيها تجربتها مع الاحتلال، وكيف استقبلته وتفاعلت هي وقريتها معه، شخصيات مختلفة الأعمار والخلفيات في عمارة واحدة، وفي كل شقة من طوابق العمارة شخصية تعبّر أو ترمز إلى شريحة اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية مختلفة، التاجر والمزارع وإمام المسجد، والطالب الجامعي الناصري، وفتاة ذات تفكير مستقل تنتمي إلى عائلة متوسطة الحال.
انتهت من الرواية ولم تعرف ماذا تفعل بعد ذلك، توصلت بعد حيرة إلى أن المكان الوحيد الذي تستطيع من خلاله نشرها هو دار الأسوار في عكا، التي نشرت دواوين محمود درويش وسميح القاسم. لكن، كيف تدخل مخطوطة الرواية، وكل قصاصة تُراقب وتُحوَّل إلى مكتب المخابرات الإسرائيلي. فكرَت أن الحل ربما يكون في نسخها بدفاتر بناتها المدرسية، التي لن يشك فيها أحد، وفعلت ذلك. تركت المخطوطة الأصلية في ليبيا، وهربت بعدما تأزم الوضع مع زوجها الذي بدأ مرحلة جديدة في رحلة عذابها. لكن الدفاتر وقعت أيضاً في يد محقق إسرائيلي استهزأ بها ورفض أن يعيدها إليها، لتفقد سحر أولى رواياتها وتبدأ مرحلة جديدة تماماً في حياتها المليئة بالتحديات.. “ربما ما حدث لروايتي يلخص ما يحيق بنا كشعب فلسطيني، وكأمّة عربية، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي صادر نسخة الرواية المنسوخة، وصادر نسخة الرواية الأصلية زوجي العربي، فأي المصادرتين أوجع وأبلغ! هذا هو السؤال الكبير الذي لم أتمكن حتى الآن من الإجابة عنه بكل وضوح”.
عادت إلى فلسطين، ثم إلى مقاعد الدراسة، تحدّت الجميع مجدداً، وأعادت صياغة واقعها، رغم الألم الكبير الذي حاق بها. كتبت روايتها الثانية “لم نعد جواري لكم” ونجحت في نشرها هذه المرة، في واحدة من أكبر دور النشر العربية، “دار المعارف” في القاهرة، وانطلقت من هناك في دنيا الأدب الواسعة. ورغم مشاعر الفرحة التي كانت حاضرة وقتها، والتي لم تُخفِها الكاتبة في سيرتها، لكنها تعود أيضا إلى مساءلة حلمي مراد، ناشر كتابها الأول، وأكبر المتحمسين لها في ذلك الوقت. تلومه أحياناً على مقدّمته التقريظية، تلومه على مبالغته، رغم اعترافها بالفضل، ورغم صدق نبوءته عن مولد كاتبة عربية “ذات شأن”. تسائله أيضاً: “لا أعرف ما هو الشأن؟ وما هو بالتحديد تعريفه؟!”.
تَعِد سحر خليفة بجزء ثان من سيرتها الذاتية الأدبية، يتناول الروايات التي تلت أوسلو والانتفاضة الثانية وضياع القدس، وما تبع ذلك. تقول إنها ما أرادت من هذا الكتاب إلا التأكيد على أن الأدب ليس اختراعاً أو خلقاً، ولا عملاً خارقاً لا تقدر عليه إلا النخبة أو المصطفون الحائزون قدرات علوية. فقناعاتها الشخصية ترى أن البيئة هي التي تهيء للكاتب أجواءه، وتوحي إليه بالمشاهد والشخوص التي يحوّلها بدوره إلى صور فنية درامية تعيد تشكيل الواقع أو ترميزه.
لكن، من ناحية أخرى، ربما يصدق أيضاً القول الذي يرى أن الأحداث أو الشدائد، إن شئنا الدقة، لا تقع إلا لمن يستطيع صياغتها، وإعادة خلقها، وأن الأدب العظيم يحتاج ألماً عظيماً أيضاً، فهي نفسها تتساءل في ثنايا كتابها: “وجدتُ الرواية أم وجَدَتني، هذا هو السؤال الذي لطالما راودني وأقلقني، لو لم يكن زوجي بذلك السوء، فهل كنت ألجأ إلى الرواية؟ لو لم تكن ظروفي تلك الظروف وكان زوجي أقل انحرافاً وحقارة، ولو كنت سعيدة في زواجي، فهل كنت لجأت إلى الكتب والروايات كي أنسى همومي؟ وتنهى تساؤلاتها بأن تقول وتعترف: حمداً لله أن كان زوجي بذلك السوء، وشهدت تجاربي كامرأة مقموعة وتجارب أمي وأخواتي وقريباتي، وزواج أبي الذي حررني من اتكاليتي وخنوعي، إذ لو كنت سعيدة وهانئة لما وصلت إلى ما وصلت إليه، ولبقيت سجينة في قوقعتي ككل النساء، أو معظمهن، وبقيت عمياء متخمة ومترهلة ومجهولة”.
(*) “روايتي لروايتي”.. سيرة ذاتية أدبية صدرت عن “دار الآداب”.
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.
السبت، ٣ فبراير/ شباط ٢٠١٨
جريدة الحياة
شيرين أبو النجا
سحر خليفة تكتب سيرتها إبداعاً وإخفاقاً
لم تعد السير الذاتية جنساً يحار القارئ في إيجاد مكان راسخ له في التاريخ الأدبي. فالذات تلجأ إلى كتابة سيرتها لتعيد ترتيب التطوّر النفسي أو الفكري أو المهني. وفي محاولة الترتيب والتأريخ الطولي المتتالي، تتحوّل السيرة إلى عمل لا يعكس الواقع، فالذات لا تنعم بحياة مرتبة أنيقة كتلك التي نقرأها، بل هي في الأصل متعددة ومنشطرة وأحيانا منقسمة على نفسها. ومن هنا لحظت الدراسات النقدية أن السيرة النسوية لا تعمد إلى الترتيب والتنميق من أجل كتابة خطية متتالية، بل تُبقي على التعددية النفسية والاخفاقات الفكرية والارتباك الذي يُصاحب لحظة الانغماس في الحياة والذي يؤدي إلى ما يشبه الحركة الدائرية، فلا تلجأ السيرة أبداً إلى السرد الذي يعتمد واثقاً على حدث كذا ثم حدث كذا. وفي أحدث أعمالها، أدركت الكاتبة الفلسطينية سحر خليفة أنّ كتابة السيرة الحياتية قد يكون أمراً مستحيلاً، فالأمر يحمل من البساطة والتعقيد قدرا متساويا: شابة تركت زواجاً فاشلاً وأكملت تعليمها الجامعي وكتبت ما يزيد عن عشر روايات وأصبحت شهرتها تجوب الأفق وحصلت على العديد من الجوائز العالمية وأشكال أخرى من التكريم. هذه هي سحر خليفة. أما أن تقرر أن تكتب سيرة الكتابة فهذا أمر آخر يتطلب استعادة اللحظة التي وقعت فيها الكتابة والظرف الذي أنتج العملية ذاتها وشكل التلقي ومدى تأثيره على رؤية الكاتبة، وهو ما بدأت تأريخه في «روايتي لروايتي» (دار الآداب، 2018).
من الصعب أن تدخل الكاتبة مباشرة في سيرة الكتابة من دون أن تسرد البدايات النفسية لشابة نشأت في نابلس وتمكنت من الافلات من زواج فاشل، وإن كان ممكناً أن يستمر وفق مقاييس المجتمع. شابة لديها ابنتان ومن دون أي مورد مادي ومن دون شهادة وبدون سند من الأب في بلد واقع تحت الاحتلال. تبدأ هذه الشابة بأول قرار جريء يتمثّل باستكمال دراستها في جامعة «بيرزيت»، وربما ما كان يُمكن أن تصمد في وجه المؤسسة بلا الدعم الذي تلقته من الأم. تغتزل حلم الكتابة ويغازلها، فتصدر أول رواية لها «لم نعد جواري لكم» (1974). وهي رواية تحمل تجربتها الشخصية في الزواج، وتُعلن عن مولد كاتبة، كما كتب حلمي مراد آنذاك. تبدأ الرحلة الفكرية الصعبة، التي تكاد تكون صراعا في حالة سحر خليفة بشكل خاص، وفي الساحة العربية بشكل عام. تعيش الكاتبة هذا الصراع غير مدركة أنه صراع كائن على نطاق أوسع في النظرية والممارسة. أيهما أصح: لن تتحرر المرأة إلا بتحرر الوطن/ المجتمع أم لن يتحرر الوطن/ المجتمع إلا بتحرر المرأة؟ أكاد أجزم أن هذه الإشكالية المستندة إلى أدبيات يسارية ظلت (وربما لا تزال) مسيطرة على مجتمعاتنا منذ الثمانينات، وتزداد حدّتها بالطبع في فلسطين المحتلة، إذ يبدو السعي إلى تحرير النساء رفاهة بورجوازية تعبّر عن أنانية فردية لا يحتملها الواقع الذي يحطمه النضال ضد المُحتل. وبين غياب الأب وتسلّط الزوج ودوغمائية التنظيمات اليسارية فيما يتعلق بالنساء وانغلاق المجتمع على نفسه- كما يحدث دائماً- في مواجهة الاحتلال والقصور المجتمعي في العلاقات بين الجنسين تخوض خليفة معركتها الشرسة، من دون أن تكون واعية لشراستها، ضد إبقاء المسألة النسوية في الخلفية سواء التنظيمية أو الفنية. إلا أنها كانت مستندة على ثقتها في شخصياتها الروائية التي تعرفت عليها في الواقع ودرستها وخبرتها ثم وضعتها في قالب التخييل. هكذا جاءت الرحلة معكوسة، فتلك الشخصيات الروائية هي التي سهلت للكاتبة فهم الازدواجية التي يحملها اليساري تجاه النساء، بما في ذلك مفهومه للحرية التي يتوقعها من امرأة ستدفع ثمنها بمفردها، وهو ما استفاضت فيه المصرية الراحلة أروى صالح في كتابها الشهير «المبتسرون» (1997).
انطلقت معركة سحر خليفة من الكتابة الأدبية، ولكن في المجتمعات المحتلة لا تتوقع المؤسسة- أياً كان شكلها- أن يكون الخطاب الأدبي مخالفا لتوجهاتها وشعاراتها. وعلى تلك الخلفية، كان الهجوم ضاريا على شخصية رفيف في رواية «عباد الشمس». كانت المؤسسة تتوقع صورا مثالية للشخصيات، نماذج ايجابية لا تشوبها شائبة، لكنّ التقابل الذي ظهر في الرواية بين رفيف (النخبة) وسعدية (القاعدة الشعبية) كشف هشاشة الشعارات ومحدودية أفق النظرة تجاه النساء، فقد كن النساء حلية في التنظيمات، يعدن انتاج خطاب مؤسسي ذكوري، من دون أي رغبة في رمي بذور للفكر النسوي (المعادل الموضوعي للبورجوازية). لم تتوقف سحر خليفة عن خوض معركتها ضد الازدواجية، فكانت مصرة على المضي بقناعاتها، فتقول: «سأساهم في تهشيم الأوهام والادعاءات الفارغة والتنطع» (128). وعندما سافرت للدراسة في الولايات الأميركية المتحدة واجهت هناك نموذج الأب العربي الأميركي في كل شيء فيما عدا بناته، ومن تلك الواقعة استلهمت بداية روايتها «الميراث».
تبدو السيرة الذاتية لكتابة سحر خليفة جريئة ومتسقة وصادقة، فمنبع الجرأة هو عدم اخفائها للتفاصيل الحياتية التي ساهمت في تكوينها (زيجة مؤلمة، وهم الحب، علاقات قاصرة، رغبات غير متحققة، هجوم حاد من بعض النقاد)، أما منبع الاتساق فهو ذاك التوافق بين الفكر والكلمة، بين الرؤية والسرد، بين الواقع والمتخيل، والأهم هو القدرة على النقد الذاتي (استراتيجية تعلمناها من التنظيمات اليسارية)، فتُعيد الحق لصاحبه بعدما كانت صادرته في غمرة انفعالها، وتكشف عن مناطق القصور- كما تراها- في عملها الأول (الذي يُقلقها طوال الوقت). ولا تغفل مطلقاً أن الدافع المؤثر في مسيرتها هو الرسام الفلسطيني اسماعيل شموط الذي كان يدفعها إلى إيجاد الظرف الخاص الذي يمكن ان يمضي بها إلى الأمام، وهو ما يجعلها الآن تتساءل: «وجدت الرواية أم وجدتني، هذا هو السؤال الذي لطالما راودني وأقلقني» (86). وفي هذه الرواية التي وجدتها تمكنت من هدم الثنائيات، على اعتبار أن سرقة الأرض مساوية لسرقة الروح، وتسلط الأب مساو لتسلط المحتل.
جريدة الحياة
“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.