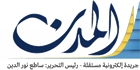جريدة المدن الألكترونيّة
الإثنين 01-07-2019
المدن - ثقافة
طارق أبي سمرا
رشيد الضعيف... البذاءة لا تصنع أدباً

الظاهر أنّ رشيد الضعيف يتلذَّذُ بمَسْخِ صورَتِه في ذِهْن القارئ. فالبَوْح لديه ليس غوصاً في الذات، أو اكتشافاً لها، من خلال الكتابة، بل عَرْضاً – أو حتّى استعراضاً – لعُيوبٍ في شَخْصِه، كأنّ القارئَ نديمُه في سهرةٍ طالت حتّى الفجر، وتعتعهما فيها السكر.
في عمله الصادر حديثاً، "خطأ غير مقصود"(*)، يواصل الضعيف ما بدأه قبل ثلاث سنوات في “ألواح”، فيَروي لنا نُتَفاً من سيرته، مازجاً وقائعَ حقيقيّة بأخرى مُتخيَّلة. وبسخريَتِه وتهكَّمِه المعهودَيْن، يستعيد بعض ماضيه القديم، كعلاقته بأمّه وأبيه، وبعض مُغامرات جَدَّتِه الجنسيّة في بلاد العمّ سام إبّان العقد الثاني من القرن العشرين، ويتطرّق سريعاً إلى إقامته في برلين مدّة من الزمن، ويُسهب في سرد مُحاولاته المُستميتة والفاشلة لمضاجعة امرأةٍ، أيّ امرأة، بعد تجاوزه السبعين وتلقِّيه من طبيبه نبأً راعِباً، ألا وهو أنّه قد يكون مُصاباً بسرطان البروستات، وأنّ عليه انتظار شهرَيْن أو ثلاثة قبل إجراء فحوص سوف تُأكِّد ذلك أو تنفيه.
ما من خَيْطٍ يربط هذه الأجزاءَ كلّها معاً، ذلك أنّ هذا الكتاب ليس روايةً حقّاً، على الرُّغم من ظهور كلمة “رواية” في غلافه الخارجي. لسنا نعلم مَنْ اختار هذا التصنيف: أهُوَ المُؤَلِّف (لأسباب يَصعب التكهُّن بها)، أمّ الناشر (لدواعٍ تسويقيّة ربّما)؟ مهما يكن من أمر، يبقى أن هذا التصنيفَ مُجْحِفٌ بحقِّ الكِتاب، فمَن سيقرأه كرواية – وليس كنصوصٍ مُتفرِّقة يجمع بينها، نوعاً ما، تمحورُها حول حياةِ رشيد الضعيف، الحقيقيّة والمُتخيَّلة – قد يَلحظ فيه غياباً تامّاً لأيّ بُنْيَة حقيقيّة، ما سيحمله على اعتباره عملاً مُفكَّكاً مُشتَّتاً، مِثْل عقدٍ انقطعت سلسلتُه فتناثرت خرزاتُه في كلّ اتجاه.
***
في ما يتعلّق بكتابة رشيد الضعيف، أجِدُني دوماً حائراً مُتقلِّباً، لا أستقِرّ على موقفٍ لأكثر من أسبوع أو أسبوعَيْن، كأنمّا في ذهني رأيين متضاربين حول قيمة أعماله، لا ينفكّان عن تبادل هزائم مدوّية، لكن موقَّتة، يُلحقها أحدهما بالآخر.
أحياناً، أرى في الضعيف وريثاً لبنانيّاً لسرفانتس هدّام الأوهام. أشعر عندئذٍ بأنّ في كتابته خفّة رائعة، شبه مُنعَدِمة في الرواية اللبنانيّة التي، ربما نتيجة الظرف الإجتماعي التاريخي الكارثي المُحيط بإنتاجها، لا تستطيع إلّا أنّ تأخذ كلَّ شيءٍ على محمل الجّد. فالرواية هذه، وإن كانت حديثةَ العهدِ نسبيّاً، تتراءى لي مُرهَقةً ومُثقلةً بهموم كبرى، إذ قصمت ظهرَها باكراً الحروبُ، و"القضايا المصيرية"، وعفنُ المجتمع اللبناني، ما أحالها رصينةً حتّى عندما تحاول أن تكون ساخرة ومُستفِزّة، فلا تسمو بتاتاً إلى ذاك اللهوّ الدونكيشوتي، العابث والحكيم، الذي يُحرِّرنا لبرهة من وطأة الحياةِ ويُرينا إيّاها على ما هي عليه: مزحةٌ ركيكةٌ لا تستحقّ منّا سوى الضحك.
لكن، في أحيانٍ أخرى، يتبدّى لي رأيي في الرواية اللبنانية جائراً يشوبه إفراطٌ في التعميم. وكمَن استفاقَ لتوّه من حلمٍ رأى فيه مخلوقات عجائبيّة لها رؤوس بهيميّة وأجساد بشريّة، لا أصدِّق أنني استطعت أن أجمع سرفانتس ورشيد الضعيف في خاطرة واحدة. والحقّ يُقال إنّ تبدُّلَ ذائقتي الأدبّية على هذا النحو المُباغت لا يحول بيني وبين التسليّة التي أعثر عليها في كتابات الضعيف؛ غير أنني لا أعود أبصر وراء هذه التسلية سوى فراغ شاسع. ذلك أنّ رواياته تنقلب عندي محض سردٍ طريفٍ لأحداث لا تُحيل إلى شيء أبعد منها أو خارجها، ولا تُشعِل شرارة تداعي الأفكار في ذهن القارئ، فتصبح قصّصاً يستنفِد ظاهرُها باطنَها، أيّ طرائف تصلح لتزجية الوقت وتُنسى بعد حين. أمّا القَوْل الذي يذهب إلى أنّ أعمال كاتبنا تنطوي على نقدٍ اجتماعي لاذع، من قبيل تفكيك مفهوم الذكورة الشرقيّة، أو مُعاينة هلعنا، نحن العرب، من القيم الغربيّة (وخاصة تلك المُتعلقة بتحرّر المرأة) التي اجتاحت دنيانا وعجِزْنا عن التأقلم معها، فإنّي أراه زعماً لا دليل عليه بتاتاً في كتابة الضعيف. فالأخيرة، جرّاء التصاقها الحميم بسطح الأمور، تترك للناقد الأدبيّ حيِّزاً تحتيّاً خالياً وبكراً، يَزرع فيه ويحصد ما يشاء.
وفيما أنا موشكٌ هنا على طردِ ضمير المُتكلِّم الذي أتاني على غفلة وبلا أي دعوة، ينبغي أنّ أنبِّه قارئ هذه المقالة إلى أنني كتبتُ أخرى بالفرنسية قبل شهر ونيِّف، تناولت فيها كتاب الضعيف إيّاه بقدرٍ لا بأس به مِن المديح.
***
ليس رشيد الضعيف طريفاً ومُسليّاً فقط، بل يمتلك أيضاً مِن الحِسّ الفكاهي ما يمكِّنه غالباً مِن حمل القارئ على القهقهة عالياً. لكنّ الفُكاهة لديه، بدلاً مِن أنّ تُسلِّط بعض الضوء على جانب مستورٍ لمسألة ما، تتبدّى، في أكثر الأحيان، مجرّد آليّة دفاعية يلجأُ المؤلِّفُ إليها كي لا يضطَرَّ إلى الغوص في ما قد يُثير القلق.
وهذا تحديداً ما يُقدِم عليه في الفصل الأوّل من كتابه الجديد، مُستهِلّاً إياه على النحو الهَزليّ الآتي: “أساس مشكلتي ومبدؤها الأوّل قد تأكّد بالبرهان: أخطأَتْ أمّي خطأً قاتلاً إذْ فطمتني باكراً”. أمّا سبب ارتكابها هذا الخطأ غير المقصود، فهو أنها “اتُّخذَت بالموضة التي كانت في أوج انتشارها آنذاك، واعتمدَت البيبرونة”، فكان رشيد الوحيد من بين إخوته الذي حُرِم سريعاً من ثدي والدته. ويُضيف: “لو أنّها لم تمنع عني حليب ثديها، لكنتُ اشتغلتُ بالسياسة ونجحت”، ثم يشرح لنا أنّ “العلاقة بين الفطم المبكّر والسياسة [...] مؤكّدة بالبرهان الذي لا يُردّ”. ذلك أن فرويد قد اكتشف أموراً كثيرة عن تركيبة النفس البشريّة، من بينها “أنّ أسس شخصيتنا تتكوّن في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من عمرنا. فهل هناك إذن أعظم من الفطم صدمةً يتعرّض لها الطفل الذي عمره شهران؟”. وعلى هذا المنوال يُكمِل هزلَه حتّى نهاية الفصل.
والفصل هذا مثالٌ نموذجيّ على اتّخاذِ الضعيف الفُكاهةَ وسيلةً للمُجانَبة. إذ كان يمكنه استخدام هزله توطئةً لشروعه في كشفِ بعض علاقته المضطربة بأمِّه وما تنطوي عليه من تضاربِ مشاعرٍ كامتزاج التعلُّق الشهوانيّ الأليم بالنفور الحادّ والحقود؛ لكنّه آثَر، عوضاً عن ذلك، أن يَلهو بحفنةٍ من الكليشيهات الفرويديّة، كأنّه قد فرغ لتوّه من قراءة كتاب “خمسة دروس في التحليل النفسي” وعثر فيه على مادَّةٍ لمزحةٍ جيّدة. ومن خلال هذا المُزاح، يكون قد تحاشى الكلام عمّا كان اعتزم الكلامَ عنه أساساً (أيّ علاقته بوالدته)، موهِماً القارئ – وربما نفسه – بأنّه قد تكلّم عنه فعلاً.
***
في الفصل الثالث عشر، يذهب رشيد إلى الولايات المتّحدة مُتقصّياً تاريخ عائلته التي كان بعض أفرادها قد هاجروا إلى هناك بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وفي نيويورك، تؤدّي سلسلةٌ من المُصادفات إلى عثوره على دفاتر يوميّاتِ المدعو السيّد “بايْكِر”، وهو رجلٌ عملَتِ لديه جدَّةُ الكاتبِ، سوزانا، خادمةً بين العامَين 1912 و1914، فكانت تأتي مرَّتَيْن في الأسبوع لتدبير شؤون منزله.
يورِد لنا الضعيف مقاطعَ من هذه اليوميّات، فنَكتَشِف أن السيّد بايكر ذاك كان أرمل تخطّى الستين من عمره، وأن خادمته سوزانا ذات الأعوام الـ19، أثارت رغبته الجنسية فيما هو مُلتصقٌ بها يحاول تعليمها قراءة الأحرف الأنكليزية وكتابتها، فشرع رويداً رويداً يُغريها بالمال ويستدرجها إلى مزيدٍ ومزيدٍ مِن المُلامسات، كأنّ تنقعَ رجلَيْه بالماء وتفركهما، وتُدلِّكَ كتفَيْه وفخذَيْه. ومع مرور الأشهر، يصبح استمناءُ السيّد بايكر أثناء جلسات التدليك أمراً اعتياديّاً.
وفي أحد الأيام، يَعرِض عليها مبلغاً مُعتَبَراً مِن المال لقاء مضاجعتها، فترضخ له. غير أنها لا تقبل أن يُجامعها إلّا من الخلف، رغبةً منها في الحفاظ على عذريتها. نقرأ في يوميّات السيّد بايكر: “أعطيتها، بعد أن انتهيت، نصفَ القيمة التي وعدتُها بها [...] اشترطتُ عليها حتّى أعطيها النصف الباقي ألّا تأكل مساء الخميس-الجمعة، وأن تأتي يوم الجمعة صائمة بلا أن تفطر. أريدها نظيفة بعد حقنة [...] جاءت ملبيّةً طلبي. استمتعتُ. أعطيتها النصف الباقي”. كانت هذه آخر مرّة تأتي فيها سوزانا إلى منزله.
لقد رأى السيّد بايكر بعضاً من البراز على قضيبه: هذا ما يستنتجه القارئ بسهولة، مُدركاً، في الآن عينه، أن البراز على القضيب هو لُبُّ قصّةِ الجَّدةِ وعلّةُ وجودِها. فلو أزلنا هذا التفصيل الوحيد (أيّ ما أبصره السيّد بايكر على عضوه)، لافتقرت الحكاية كلّها لأيّ طعم أو لون. ذلك أن الحكاية هذه مبنيّةٌ على نموذجِ نُكتةٍ، والتفصيل الصغير المُتعلِّق بما رآه السيّد بايكر هو نظيرُ جزءِ النكتةِ الأخيرِ الذي يحمل السامعَ عادةً على القهقهة. صحيحٌ أنّ القارئ قد لا يُضحكه بالضرورة ذاك التفصيلُ، بل قد يُثير قرفه أو يتركه لا مبالياً؛ لكن هذه حالُ أيّ نُكتة أيضاً: فهي لا تُصيب هدفها دوماً، وقد تُضحك سامِعاً وتُشعِر آخر بالإشمئزاز فيما يبقى ثالثٌ غير مكترثٍ بها، إذ أنه لم يفهمها أو وجدها تافهة.
وهنا تتّضح إحدى تقنيّات التهرّب الأخرى التي يلجأ إليها الضعيف. فبالإضافة إلى استخدامه الفكاهةَ وسيلةً لتجنُّب ما قد يبعث على القلق والإضطراب، هو يفتعل الجُرْأَةَ كي يَصْدُمَ القارِئَ ويوهمَه أن ما يقرأه لا يمكث على سطح الأمور، بل أنّه ينطوي على عمقٍ دلالي ونقدٍ اجتماعي وكسرٍ للمحرَّمات يفتقر إليها تماماً في واقع الحال. وخير دليل على ذلك حكايةُ الجدَّة: فما يتراءى في بادئ الأمر قصّةً عن صبيّةٍ مهاجرةٍ وفقيرة يستغلِّها رجلٌ أميركي مُسنّ يعيش في عزلةٍ وحرمان جنسي مُتماديَيْن، يتبدّى في نهاية المطاف قصّةً عن لا شيء. ذاك أنّ عناصر الحكاية جميعها – الهجرة والفقر والاستغلال والعزلة والحرمان الجنسي – ليست سوى الوسيلة لبلوغ النُكتة الختاميّة التي، من خلال جرأتها المُفتَرَضة، قد تخدع القارئ وتحمله على إضفاء معنى على اللامعنى الذي فرغ لتوّه من قراءته. لكن، ما أنّ يُفَكَّ سحرُ الهزلِ والجرأةِ عن كتابة الضعيف حتّى تبدو كثرةٌ من نصوصه أشبه بنكتة بذيئة لا تحوي شيئاً غير بذاءتها. ولا يُفْهَمَنَّ أن في القول هذا أيّ انتقاد للبذاءة. فهي مِن أمتع ما ابتكره الإنسان، وتتيح له التخلُّص من بعض سموم الغضب التي تجري في دمه. بَيْد أنها لا تصنع وحدها أدباً.
***
علاوة على الفكاهة والجرأة المُفتعَلة، يستخدم الضعيف تقنيّةَ تَهَرُّبٍ ثالثة يمكن تسميتها بالنرجسيّة المعكوسة. والمقصود بهذه العبارة هو ضربٌ من البَوْح يتحايل على البَوْح الحقيقي وينوب عنه عبر تصويرِ الذاتِ على نحوٍ كريه ومُنفِّرٍ يُوهِم القارئَ والكاتبَ معاً بأنّ الأخيرَ قد غاص في أعْمَقِ ظُلمات نفسه ثم عاد من رحلته هذه ليعرض تحت نور الشمس الساطع كلّ ما اكتشفه مِن خبايا في دواخله الدفينة. ومِن هذه الصورة البغيضة والممسوخة التي يرسمها عن نفسه في ذهن القارئ، يستمدّ الضعيف، على ما يبدو، لذّةً مماثلة لتلك التي تتملّك النرجسيّ وهو يتأمّل بهاءَ طيفه المُنعكس في المرآة.
“يجب أن أحتفل بانتهاء حياتي الجنسيّة احتفالاً يُبقي ذكراها ماثلةً أمام عينيّ، كأنها تمثال في صالون بيتي”: هذا ما يُقرّر رشيد السبعيني فعله بعد أن يُعلِمه طبيبُه بأن عليه انتظار شهرَين أو ثلاثة قبل التأكّد من إصابته بسرطان البروستات. والاحتفالُ الذي يطمح إليه متواضعٌ، فهو لا يُريد أكثر من “علاقة قويّة مع امرأة، علاقة جسدية وحسب، مرّات عدّة فقط”، يودِّع بها حياته الجنسيّة بجسده الكامل “قبل أن ينقص منه شيء”.
هكذا يوقِظ خطرُ المرضِ رغبةَ رشيد في الحياة، هو الذي كان قد تقبّل العزلةَ والحرمان الجنسي قبل سماعه ذاك النبأ من طبيبه. وهذه الرغبة العارمة في تذوِّق ملذّات الدنيا مرّةً أخيرةً، تستحوذ عليه مصحوبةً بأنانيّةٍ لا حدود لها، هي الأنانيّة إيّاها التي اتّسمت بها كثير من علاقاته السابقة: “يسهل عليّ الاتصال بالنساء اللواتي أقمتُ معهنّ علاقات سابقة واللواتي هجرنَني، لا اللواتي هجرتُهنّ. أولئك اللواتي هجرتُهنّ يُخجلني الاتصال بهنّ لأطلب منهنّ المساعدة. كنت جلفاً معهنّ بلا رحمة. أخجل الآن حين أفكّر في سلوكي معهنّ. لم أكن لأسمح لابنتي، لو كان لي ابنة، بأن تُقيم علاقة مع أحدٍ بصفاتي”.
يمكن حصر هذه الصفات في واحدة فقط، هي المَيْلُ لاستعمال النساء وسيلةً للمتعة بلا أدنى اكتراث بما قد يشعرن به. وهذا ما ينتهجه رشيد في محاولاته الثلاث لوداع حياته الجنسية، محاولات تبُوء جميعها بالفشل، وبينها واحدةٌ هي أقرب إلى الإعتداء الجنسي. فما أن يُبصر رشيدُ “فاكرة”، وهي عاملة منزلية أثيوبيّة شابة استقدمها له الناطور كي تُنظّف منزله مرّتين في الأسبوع، حتّى يُصمّم على مضاجعتها، مُتَّبِعاً أسلوب السيّد بايكر بحذافيره (ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن هذه المماثلة المُصطنَعة بين بايكر والضعيف، وبين الجَّدة وفاكرة، ليست سوى خدعة غايتها حمل القارئ على البحث عن دلالات مخفيّة حيث لا وجود لها قط).
يشرع رشيد بتنفيذ خطّته كأنه يُطبِّق ما جاء في يوميّات السيّد بايكر بصفتها دليل المسنّين لإغواء خادماتهم الأجنبيّات. يبدأ بتعليم فاكرة كتابةَ الأحرف العربيّة فيقبض على يدها الممسكة بالقلم ويروح يلتصق بها أكثر فأكثر في كلّ جلسة جديدة. ومع مرور الأيام والأسابيع، يزيد لها أجرها باضطراد ويطلب منها دخولَ غرفة النوم فترضخ، ثم تدليكَه فترضخ، ثم التعرّي فترضخ. وبعد عناء طويل، ينجح في إقناعها بمداعبة قضيبه، لكنّها تتوقف عن ذلك وهو على وشك أن يقذف، فتهرع إلى الحمام حيث يجدها، بعد لحاقه بها، تتقيّأ منحنيةً فوق المغسلة. ومن شدّة غضبه وإحساسه بالمهانة يكاد يقتلها، لكنه يتمالك نفسه. وفي اليوم التالي، يطلب منها مُداعبة قضيبه مجدداً، كأنّ شيئاً لم يحصل.
هذا ما يَظُنّه الضعيف تعريةً للنفس، لكنّه في الحقيقة نقيض ذلك. فشخصيّة العجوز البغيض التي يستمتع برسمها لنا، أكانت حقيقيّة أم مُتخيّلة أم مزيجاً من الإثنين، هي قناعٌ لا شيء خلفه سوى الفراغ أو ربّما، في أحسن الأحوال، أمور هزلية من قبيل “فطمتني أمّي باكراً [...] لأنها اتُّخذت بالموضة [...] واعتمدت البيبرونة”. العجوز الكريه، والمهووس بالنساء الشابات... هكذا يحِبّ الضعيف أن يراه الآخرون. هذه هي الصورة التي يرغبها لنفسه، الصورة التي تُشعره بالفخر والرضا ويسعى، تالياً، إلى طبعها في ذهن القارئ. ولذلك هي تنمّ عن ما أسميناه نرجسيّة معكوسة.
إن البَوْح، كما يمارسه الضعيف، يسلك منحى أفقيّاً وليس عموديّاً. فبدلاً من أن يُريك – ويُري نفسه – ما يتوارى تحت تلك الصورة المُحبّبة إلى قلبه، يكتفي بتكرارها مرّة تلو أخرى وبلا كللٍ، كأنه لا ينفكّ يُرَدِّد من أوّل الكتاب إلى آخره: “انْظُرُوا إليّ كم أنا صريح وجريء! انظروا إليّ كيف أَسْخر من أمّي وأنتهك عرض جدَّتي وأمسخ صورتي! انظروا كيف أضحّي بسمعتي في سبيل الأدب... وانْبَهِرُوا بشجاعتي رغماً عن أنوفكم!”. وفيما هو يُحدِّق في صورته مُولَّهاً ومسحوراً بها، يكون قد تهرّب من الشجاعة الأدبيّة الفعليّة، والتي تكمن في كسر المرآة لرؤية ما يَسْتتر خلفها.
هذا ما يفوق طاقةَ رشيد الضعيف.
(*) “خطأ غير مقصود”، رشيد الضعيف، دار الساقي، 2019، 184 صفحة.
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.