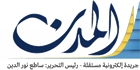مجلة حبر الإلكترونية
الإثنين 13 أيار 2019
عمّار أحمد الشقيري
«حلّاق دمشق» : العامّة يكتبون التاريخ أيضًا

في القرن الثامن عشر، أيّام الحكم العثمانيّ، بدأ في بلاد الشام نظامٌ جديد انتقلت فيه السُلطة من قصر السُلطان في أسطنبول إلى قصور الوزراء وعائلات الباشوات في دمشق، بعد أن منحت أسطنبول إقطاعات للنخبة في دمشق، من علماء وتجّار وولاةٍ، فظهر نتيجةً لذلك نظامٌ ضريبيٌّ جديدٌ هو «المالكانة» مكّنَ هذه الفئات من الهيمنة اجتماعيًا وسياسيًا.
بالترافق مع هذه السُلطة والثروة الجديدتين، تطورت العمارة وتوطنت الثروات الجديدة في دمشق، بحيث «شُيَّد سبعة عشر قصرًا جديدًا داخل أسوار المدينة في القرن الثامن عشر، في حين لم يُشيَّد غيرَ قصرٍ واحدٍ خلال القرنين الماضيين».[1] وداخل هذه القصور، كان الأثاث يُستخدم للمباهاة بالثروات، كما تنوعّت أصناف الطعام العجيبة.
في هذا السياق، تغيّرت عادات أهل دمشق والشام عمومًا، إذ بدأت ثقافة التنزّه في الأراضي الخضراء بعيدًا عن المباني، وبدأ سكّان دمشق يتخلون عن خصوصيتهم نسبيًا، و«تركت المرأة تدريجيًا مكانها الذي كان ينتمي حصريًا إلى المحيط الخاصّ؛ أي المنزل»،[2] ومشت نساء دمشق المسيحيات حاسرات الرؤوس، ومشت البغايا علانيّة في الشوارع، أعَفى والي دمشق، أسعد باشا العظم، المسيحيين من دفع الجزية، وجلس عازفون يهود على مقاعد أعلى من مقاعد الجمهور من المسلمين.
هذه التحولات الاجتماعية في المدينة وبلاد الشام عمومًا، وغيرها، دَرستَها لسنوات الأكاديميّة والباحثة دانة السجديّ، ووضعتها في كتابها «حلّاق دمشق: مُحدَثو الكتابة في بلاد الشام إبان العهد العثماني (القرن الثامن عشر)»، الصادر عام 2018 عن مشروع كلمة للترجمة في أبو ظبي. في هذا الكتاب، سعت الكاتبة إلى إحياء سيرة بعض العوامّ في تاريخ بلاد الشام الوسيط، قبل أن تصل إلى نتيجةٍ مفادها أن الصحافة العربيّة المطبوعة لها جذرٌ في تاريخ اليوميات الذي كتبه بعض العوامّ في بلاد الشام، وأن تلك الحقبة شهدت ظهور اقتصاد جديد للنصوص الأدبية والتاريخية، عكس الحقائق الاجتماعيّة والسياسيّة الجديدة وتفاعل معها.[3]
فما هي هذه النصوص؟ ومن هم مؤلفوها؟ وما الذي يُمكن أن تقدمه لنا وسط آلاف النصوص التي كتبت في التاريخ؟
«محدثو الكتابة»
تستعرض السجدي نصوص مؤرخين كتبوا تاريخ دمشق في القرن الثامن عشر على شكل يوميّات لم تنشر في حياتهم. الأمثلة التي أوردتها تتنوع طائفيًا بين كاتبين مسيحييْن من طائفتين مختلفتين، ومسلميْن من طائفتين مختلفتين، وكاتب سامري. كما تتنوع مهنيًا بين حلّاق من طبقة متدنيّة، وجنديّين، وموظفٌ بسيطٌ في محكمة. لكن يجمع بين هؤلاء أنهم ينتمون لأوساطٍ أو طبقات خاضعةٍ،[4] إما بسبب المركز الاجتماعيّ، أو الطائفة، أو الوظيفة.
من هؤلاء، جنديان من دمشق هما حسن آغا العبد، وانصب تأريخه على طبقة الموظفين، والمراسم، والمؤامرات، والمناوشات العسكرية، وتحركات القوات العسكرية في دمشق، وحسن ابن الصديق، الذي «لا يمكن للقارئ لتاريخه تحديد مناصرٍ للمؤلف أو جماعة انتمى لها».
منهم أيضًا حيدر رضا الركيني، وهو مزارعٌ شيعيّ من جبل عامل في لبنان، كانت «الدولة العثمانية التي حددت هويتها ومشروعها كنقيض للمذهب الشيعي أحد أبرز الأعداء» في سرده.[5] وإبراهيم الدنفي وهو كاتبٌ سامريّ من نابلس يتشابه تأريخه مع تأريخ الركيني؛ كونهما ينتميان إلى من «اهتموا باستقلالهم النسبيّ» عن الدولة العثمانية في حالة الثاني، وعن ظاهر العمر الذي غزا نابلس، في حالة الأول.
منهم كذلك محمد المكي، وهو كاتب محكمةٍ حمصيّ كتب يومياته التي امتازت بـ«أسلوب نثري غريب» حيث أتت على شكل مختصر تليغرافي. وميخائيل بُريْك، وهو قسيسٌ من كنيسة الروم الأرثذوكس من دمشق، كان «على حدِّ علمنا، أوّل قسيسٍ من طائفة الروم الأرثذوكس في بلاد الشام يكتب تأريخًا ليس له أي صفةٍ دينية (..)[وإنما] تصويرًا لتاريخ الدمشقيين وماذا صار في مدينة دمشق»،[6] فضلًا عن حلّاق من عائلة حمّالين في دمشق، هو ابن بدير.
لم يكتب من قبل أحدٌ من الطبقات التي انتمى لها هؤلاء المؤرخون. فقد كان إنتاج نصّ التاريخ حكرًا على المشتغلين بالعلم في الأغلب، وتحديدًا بالعلوم الدينية، وكانوا من ميسوري الحال، وكانت مهنهم مرتبطة مباشرةً بالكتابة أو بمناصب الدولة، مثل القضاة والمفتين والمُعلمين والناسخين والخُطباء والمؤرخين والشعراء ومُقرئي القرآن والأولياء. وشكل هؤلاء حلقات شبه مغلقة؛ إذ لا ينقل كتاب بواسطة طالب علمٍ إلّا بعد حصوله على إجازة. لهذا ظلَّ التاريخ يُكتبه من هم معنيون بتصدير رواية السُلطة أو طبقة العُلماء.
لكن في القرن الثامن عشر، كما تقول السجدي، «انتهت هيمنة العُلماء على إنتاج المعرفة التاريخيّة واحتكارهم للزمن»،[7] حين بدأ في هذا القرن ظهور كتاب تاريخ اليوميات هؤلاء، الذين لم يكونوا يومًا من العُلماء أو مرتبطين بالدولة من خلال مهنهم.
اللغة في سياقٍ اجتماعيّ
تفترض السجدي في البداية أنَّ الأجناس الأدبيّة مقسمَّة اجتماعيًا، بمعنى أنَّ إنتاج بعض هذه الأجناس واستهلاكها يقع ضمن فئة اجتماعيّة ما. كتب هؤلاء التاريخ على شكل يوميّاتٍ، ولكي يعُد ما قدمه هؤلاء ظاهرة جديدة، كان لا بدَّ من وجود عوامل مشتركة بينهم أو بين نصوصهم. بحسب السجدي، أول هذه العوامل كان لغة هذا التأريخ، التي كانت في غالبها «عاميّة بسيطة»، تكثر فيها بالأخطاء النحوية والإملائيّة. هذه الخاصية تذكر بالفصل المقام بين الفصحى والعامية، بترسيخ صورة الأولى على أنها للمتعلمين والمهذبين والعلماء، بينما الثانية من نصيب الجماهير غير المتعّلمة.
تتبع السجدي ظاهرة استخدام العاميّة في النصوص التاريخية لهؤلاء، الذين «أدركوا الفرق بين الفصحى والعاميّة» لكنهم «اختاروا بدرجات متفاوتة ألا يخصصوا الفصحى للسرد المكتوب والعامية للكلام المحكي». لذا، فقد أنتج «محدثو الكتابة نصوصًا هجينة لغويًا جمعت العامية والفصحى، تجاهلت المعايير الأدبية، فبقيت الحدود الفاصلة بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية في هذه النصوص الهجينة غير محددة».
وتضيف السجدي أن هؤلاء المؤرخين استخدموا اللغة كوسيلة وليس غايةٍ بحد ذاتها، حيث تجنبوا الفصحى المنمقة، التي كانت ستقيد «قدرتهم على التعبير عن ذواتهم» لو استخدموها.[8] هذا الأسلوب كان أساسيًا في دخولهم كتابة التاريخ، إذ كان لوجود هذه الفئة مغزى، كانوا ضمن تحرّك أوسع، أي ضمن تحرك اجتماعيّ يبغى الوصول إلى طبقة اجتماعيّة غير التي وجودوا بها (الحلّاق مثلًا). من خلال ما ستمنحهم إيّاه الكتابة. باختصار، حين أفرز النظامان الاجتماعي والسياسيّ الجديدين أبهاتٍ للأعيان والعُلماء ومحدثي النعمة «كان لدى الأقل حظًا خيار الترويج لأنفسهم والحصول على امتيازات بواسطة تأليف نصوصٍ عامّةٍ ألا وهي التأريخ».[9]
كتابة الحاضر ونشأة الصحافة
العامل المشترك الثاني بين النصوص هو تأريخ الحاضر لا الماضي، نظرًا إلى أن هذه الفئة كَتبت التاريخ على شكل يوميّاتٍ.[10] وبحسب السجدي، «حين وصل تأريخ اليوميات إلى بلاد الشام في القرن الثامن عشر كان قد مرّ بتغييرات جعلته أكثر مرونةٍ، مما مكّن غير العُلماء من الاستحواذ عليه، وهكذا، وجب الآن على من أراد تأليف تأريخ أن يتمتع بمؤهلين فقط؛ القدرة على القراءة والكتابة (..) وأن يكون المؤلف ببساطة شاهدًا على الأحداث التي تدور في محيطه المباشر».[11]
هكذا لم يعد المؤرخ بحاجة إلى دراسة الماضي وأحداثهِ التي كُتبت قبله، أو الالتزام باللغة العربيّة الفصحى. فدخلت مواضيع جديدة في نصوص التاريخ، مثل المغامرات الجنسيّة، وقائمة الأطعمة وأسعارها، والنوادر، والعجائب، بدلًا من التركيز على أخبار الحكام والعُلماء والمعارك الكبيرة وسقوط سلالات وظهور سلالات حاكمة. كما سلط المؤرخون الجدد الضوء على ما يجري من فوضى وتغييرات من حولهم، وقدموا تعريفًا بالمشكلات التي يعيشونها ويشهدونها ونقدًا لها، مما قد يكون سهّل ظهور شخصية «بطل النهضة، أي المصلح والصحفي». بعبارة أخرى، فقد «كانت فحوى التأريخ في القرن الثامن عشر أشبه بالصحيفة المحليّة».[12]
على هذا الأساس، تستنتج السجدي أن هذه الكتابات كانت رافدًا للصحافة العربيّة، وبصورة أعم، لعصر النهضة في القرن التاسع عشر. فرغم ارتباط ظهور الصحف في بلاد الشام ومصر بظهور الطباعة في ظل حركة الإصلاح التي دعمتها الدولة، وبتشييد مدارس حديثة، والانفتاح على الغرب، والبعثات العربية إلى الغرب، إلا أن السجدي ترد ظهور الصحف أيضًا إلى «توفر الاستعداد الاجتماعيّ أو الميل إلى الانغماس في ثقافة الصحافة المطبوعة»،[13] وهو ما تدل عليه الأعداد الكبيرة للمطبوعات الصحفية والمشتغلين بالصحافة في الفترة بين عامي 1828 و1928.
نهاية «احتكار الزمن»؟
ربّما لقصّة المؤلفة نفسها مع كتاب الحلّاق خير مثالٍ على احتكار السلطة للرواية التاريخيّة، إذ كان على المؤلفة استبعاد نُسخ تاريخ ابن بدير التي حققها بعض العلماء، وفضلّت الرجوع إلى النسخة الأصلية. لماذا؟
في تحقيقه لنسخة الحلاق التي أنجزها قبل وفاته 1900، غيّر محمد سعيد القاسمي الكثير، فحذف وأضاف على النسخة، وكتب مقدمة يشرح فيها اليوميات، وكيف أنها حدثت في أيام وزراء وأعيان أبناء عائلة العظم، محاولًا إظهارهم كأبطال داخل النصّ، «فحوّله من بنيته الأصليّة – كنتاج هجين يحمل رسالة معارضة وهادمة ونصٍ ذي وظيفةٍ أدائيّة بالدرجة الأولى- وأرجعه إلى تأريخ منظّم نسبيًا يُعنى بالسلاطين والولاة».
تقول المؤلفة بعد اطلاعها على النسخ المحققة والنسخة الأصليّة إنه «تمّ إسكات الحلاق وتغيير لغته إلى درجة أنهما أصبحا، في أحسن الأحوال، خلفيّة ظريفة، ويبدو أن العالِم لم يستطع استساغة مخاوف محدثي الكتابة وطموحاتهم، فاضطر إلى إرجاع الحلاق إلى مكانته الاجتماعيّة الملائمة. بعبارة أخرى يستغل المحقق حقيقة موت الحلاق ليقتله مرة أخرى فيحذف الحلاق وحياته من النصّ».[14]
لذا، يأتي كتاب السجدي كمقاومة لهذا الإسكات. في حوارٍ قصيرٍ معها، تحدثت السجدي لحبر عن الدور الذي يُمكن أن تقوم به مثل هذه الدراسة في تغيير النظرة إلى التاريخ. إذ ترى أن حقل التاريخ عمومًا في القرون الأربعة الأخيرة انشغل بـ«مراجعة وتعديل نفسه، حيث أدرك الباحثون أن مجالهم ودراساتهم ساعدت على تثبيت السلطة، وخصوصًا الدولة القومية، ودعم قصة الظافر والمهيمن». لذا فقد ركزت فمعظم المدارس التاريخية في العقود الأخيرة علی «هدم النماذج التقليدية وبث الشك في مصادرنا الأولية إن كانت وثائق رسمية أو مخطوطات كتبها مؤرخون تابعون للفئات المهيمنة».
تقدم السجدي عملها على أنه عمل «تاريخ اجتماعي»، أكثر من كونه تاريخًا مصغرًا أو جزئيًا (microhistory). فمع أنه لا تناقض بالضرورة بين المصطلحين، بل أن الأول عادة ما يحتوي الثاني، إلا أن تركيزها على الأول جاء، حسبما تقول لحبر، بهدف الرد على مقولة إن المصادر الأولية في مجال التاريخ الإسلامي بطبيعتها لا تسمح بدراسة الطبقات الدنيا ولا تعطي شخوصها أي ملامح فردية.
وتعبر السجدي عن منظور مغاير للتاريخ العربي في بلاد الشام، يبتعد عن «ما تعلمناه في المدارس [من أن] الثقافة العربية لم تزدهر إلا تحت حكم الأمويين والعباسيين، وأن والوجود الفكري والثقافي العربي اضمحل وضمر [حتى جاء] عصر النهضة في القرن التاسع عشر»، وأن العصر العثماني كان «عبارة عن أربعة قرون من الظلام والانحطاط»، ولا شيء آخر. إذ لا تنكر المؤلفة محاولة كبت الثقافة العربية في أواخر العهد العثماني، في ظل تبني نهج التتريك، إلا أن دخول مؤرخين جدد إلى عالم الكتابة يؤشر إلى أن تلك الفترة «سمحت لفئات جديدة للتعبير عن واقعها وآمالها بصوتها بدون وسيط».
التخلص من رواية السُلطة للأحداث هو هدف مثل هذه المقاربات، بحسب السجدي. فهدف التاريخ عمومًا هو التغيير الاجتماعي من خلال طرح سرديات جديدة. لكن هيمنة رواية السلطة مرتبطة بهيمنة السلطة نفسها، واستمرار سيطرتها على المؤسسات، خاصة التعليمية منها، وبالتالي قدرتها على انتقاء ما يناسبها وتخليده، وكبت ما سواه.
أخيرًا، لا تغفل السجدي امتداد هيمنة السلطة إلى كتابها نفسه، الذي صدر بالإنجليزية قبل أن يُترجم إلى العربية. فتقول لحبر: «مما يؤسفني أن هذا الكتاب المتعلق بموضوع عن المجتمع العربي وثقافته و[الناتج] عن دراسة عميقة في مصادر أولية باللغة العربية كُتب أصلًا بالإنجليزية. هذا بالضبط هو منتوج علاقات السلطة بالعالم».
الهوامش
[1] – دانة السجدي، «حلّاق دمشق: مُحدَثو الكتابة في بلاد الشام إبان العهد العثماني (القرن الثامن عشر)»، ترجمة سرى خريس. دار كلمة، أبو ظبي، 2018. ص 39.
[2] – السجدي، ص 49.
[3] – السجدي، ص 52.
[4] – يستخدم المؤرخ الإيطاليّ كارلو غينسبورغ مفهوم الطبقات الخاضعة لوصف الذين «وُصفوا وصفًا أبويًّا بأنهَّم سواد الناس في المجتمع المتحضّر».
[5] – السجدي، ص 99.
[6] – السجدي، ص 94 – 95.
[7] – السجدي، ص 93.
[8] – السجدي، ص 124.
[9] – السجدي، ص 54.
[10] – السجدي، ص 135.
[11] – السجدي، ص 151.
[12] – السجدي، ص 217.
[13] – السجدي، ص 218.
[14] – السجدي، ص 186.
شروط الاستخدام
محتوى حبر مرخص برخصة المشاع الإبداعي. يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر بواسطة رابط (hyperlink)، وعدم إجراء تغييرات على النص، وعدم استخدامه لأغراض تجارية.
حبر مؤسسة إعلامية ومجلّة إلكترونية، انطلقت من الأردن في عام 2007 كمساحة لإعلام المواطن تدار بشكل تطوعي، وتحولّت في عام 2012 إلى مجلة صحفية احترافية تنتج صحافة معمّقة متعددة الوسائط، وتحليلات نقدية، وحوارات عامّة، حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية.
جريدة المدن الألكترونيّة
الإثنين 28-01-2019
المدن - ثقافة
محمد حجيري
"حلاق دمشق" لدانا السجدي.. المدينة بين التصوف وبائعات الهوى

ثمة كتب اجتماعية هامشية، فجأة نكتشف أنها باتت مرجعاً ومتناً في ثقافتنا اليومية، ومرتكزاً في بعض دراستنا ومقالاتنا، وتدخل في دائرة “الكتب الأيقونية”، وتحاك حولها الكثير من الروايات والتأويلات وحتى الأساطير. ومن هذه الكتب “حوادث دمشق اليومية” للشيخ أحمد البديري الحلاق، الصادر في دمشق العام 1959، والذي يصنف ضمن خانة "التاريخ الشفاهي". والكتاب، بحسب محققُه، أقربُ ما يكون إلى تاريخ الغَزّي عن حلب، وتاريخ الجبرتي عن القاهرة، أو إلى كتاب "مطالع السعود" عن بغداد.
كتاب البديري أعيدت طباعته العام 1997، ومرة ثالثة العام 2008، سجّل فيه ما رآه أو سمعه أو لمسه في المدينة السورية، وظلت هذه المدونة ضائعة لفترة طويلة تناهز القرن ونصف القرن، لكنها وصلت بطريقة ما إلى مكتب الشيخ طاهر الجزائري. استعار الشيخ محمد القاسمي، الكتاب، من الشيخ الجزائري، ومن ثم حققه ونشره بعنوان جديد العام 1959، ونشر أحمد عزت عبد الكريم طبعة جديدة للمدونة بعد دراسة النسخة الأصلية ونسخة القاسمي.
وثمة روايتان تتحدثان عن كيفية الحصول على المخطوط. الأولى تقول إن القاسمي الكبير، جَد المُنَقِّح، كان قد اشترى شيئاً من أحد دكاكين الحارة، مصروراً بورقة، وحينما وصل البيت فتح الورقة فوجد فيها كلاماً نفيساً، فعاد إلى الدكان وأقنع صاحبه بأن يبيعه هذا الورق الذي يستخدمه للصر، ففعل، وهكذا استطاع أن يحمي المخطوط من الضياع. والرواية الثانية هي أن الشيخ طاهر الجزائري اشترى المخطوط من مزاد أقيم لبيع مخطوطات قيمة، بثلاثمئة قرش (يوم كان سعر المخطوط لا يزيد عن خمسة وعشرين قرشاً)، واحتفظ به. وبعد زمن بعيد اطلع عليه الكاتب والمؤرخ محمد كرد علي، فأورد ذكره بوصفه أحد مراجع كتابه “خطط الشام”، مع إشارة منه إلى أن المخطوط موجود في مكتبة الشيخ طاهر الجزائري، وهذا ما دفع النساخ إلى نسخه، وصار منه أكثر من نسخة.
عاش ابن بدير، المعروف بالبديري الحلاق، بين سنة 1701 و1762، وكانت عائلته تقطن ضاحية القبيبات على طريق الحج الى مكة، وهو لا يبعد كثيراً من دمشق المسورة. كان ابن بدير سليل الطريقة القادرية التي شاعت بين المدرسين ذوي الميل إلى التصوف. عمل حلاقاً في محل صغير قرب قصر أسعد باشا العظم - حاكم دمشق حينذاك. ورغم أنه لم يكن سليل أدب وعلم، لكنه متأدب وحافظ للقرآن، شهد أحداث دمشق فانكب على أوراقه يسجلها بحبر أسود استجابة لهواية الكتابة والتعبير عن المشاعر وخشية النسيان، واستمر على هذه الوتيرة 21 عاماً، (أي من 1741 إلى 1762). ولأنه حلاق، فهو من أكثر أصحاب المهن الحرة احتكاكاً بالناس، ومقدرة على كسب ثقتهم وسماع حكاياتهم وأخبارهم، تناول جوانب قد تبدو ثانوية عند مقارنتها بالأحداث المحيطة بقصور الملوك والعلاقات الدولية والحروب، لكنها لا تقلُّ عنها أهمية عند النظر إليها من حيث دلالاتها الثقافية والاجتماعية. تناول فيها الأحداث اليومية في دمشق تحت حكم آل العظم المنسّبين من قبل الدولة العثمانية، كان يكتب بشكل يومي عما يجري في حارات الشام من احتفالات، وسفرات، ويقص عن تشييد أبنية باذخة قام بها الوالي أسعد باشا العظم، كبناء قصره والخان الكبير حيث استغل موارد البلد ونهبها للقيام بذلك. دوّن الحلاق ما يقاوم به الحواة، والمتصوفة، والدراويش من أذكار وموالد وعراضات، ولا ينسى أحداث موت العلماء والتجار ووجوه البلد، وأفعال اللصوص والثوار وقطاع الطرق. وذكر احتفال المومسات في حارات الشام، وطريقة لبسهن وطقوسهن في الأزقة والساحات.
وفي الكتاب لن نعثر على وقائع سنة واحدة، لا يشكو فيها الدمشقيون من غلاء فاحش في أسعار السلع، والتي يُفصّلها في كل موضع. ولا يُهمل الحلاق، كذلك، ربط الغلاء بفساد المسؤولين وظلمهم للعباد. ولا يغفل ابن بدير عن تسجيل احتجاجات أهل دمشق في وجه هذه المظالم، والتي يمكن دراستها في سياق مستقل، ومنها خروج العامة العام 1745 من قلّة الخبز وغلاء الأسعار، فهجموا على السرايا، مذكّرين والي دمشق أسعد باشا بأنه مسؤول عند الله عنهم وعن هذه الأحوال، فأخبرهم باللجوء إلى المحكمة. وهناك، أمر القاضي بضربهم بالبارود فقتَل منهم مَن قتل، فما كان من المحتجّين إلا أن قتلوا بعض أعوانه بمساعدة بعض الانكشارية (الجند) وخرّبوا المحكمة ونهبوا أموالها وأغلقوا الشوارع.
ويستخدم ابن بدير أسلوباً تعبيرياً يمزج العامية بالفصحى، ولا يلتفت كثيراً للأخطاء الإملائية في كتابة نصوصه. والكتاب مميز “لأنه لم يُكْتَبْ بتكليف من حاكم أو ملك”، لم يُدون المؤلف تاريخه لأجل تحقيق منفعة، أو شهرة، بدليل أنه لم يَسْعَ إلى نشر الكتاب بين الناس في زمانه. ثم يموت ابن بدير الحلاق، ويختفي المخطوط لمدة قرن ونيف تقريباً، إلى أن يعثر عليه واحد من المحققين. وتبين أن التدقيق والتحقيق الذي أنجزه محمد سعيد القاسمي للكتاب لم يكن سوى مجزرة فكرية، وتاريخية، وأخلاقية، نتجت، كما تقول الباحثة دانة السجدي*، عن العجرفة الاجتماعية، وانحياز المدقق إلى السلطات العثمانية، وممثليها من آل العظم وورثتهم. أزال المحقق أي نبرة تذمر تجاه الحكام من اليوميات، وأي فكرة دلل بها الحلاق على طموحه في رفع نفسه من طبقة الفقراء والمهملين إلى طبقة العلماء، والكتّاب، والمؤرخين. وتمثل أحداث الكتابة لدى ابن بدير لغويّا (في استخدامه الألفاظ العامية)، أو اجتماعياً (في عرضه لعلاقاته مع النخبة من العلماء)، أو سياسياً (في اعلاناته المزلزلة المناهضة للأعيان) وهي ما أزعج القاسمي بعد قرن من الزمان.
وأقرت السجدي في مقدمتها بأنها كتبت الكتاب على دفعات، واستغرقت كتابته ردحاً من الزمن، طافت خلالها بين مدن عديدة في غير قارة، والتقت بباحثين من مختلف الثقافات، ونبشت في مخطوطات لا تحصى توزعت في المكتبات العالمية. أنجزت كتابها النفيس المعنون “حلاق دمشق”. أهمية البحث المنشور لا تقتصر على قراءة ما أجراه المحقق من حذف وإضافة وتبويب فقط، بل تناولت مخطوطات موازية كتبها أشخاص ثانويون في تاريخ مقارب ليوميات البديري الحلاق. ومن بينهم قس أرثوذوكسي، وجندي من الانكشارية العثمانية، وخياط، وموظف محكمة من حمص، لم يعرف عنهم أي اهتمام أدبي في تدوين التاريخ، وهم من سمتهم بمحدثي الكتابة، على غرار محدثي النعمة. ورأت الباحثة في هذه الظاهرة دلالة على تغيّر مفهومي واجتماعي واسع في المجتمعات العربية في القرن الثامن عشر، ومن أبرز تلك التغيرات خروج فئة من البسطاء على نسغ التدوين التاريخي القديم المهيمن، وتنكبهم طريق اليوميات، والسير، المنبثقة من رحم الطبقات المهمشة وحياتها بلغة بسيطة فصيحة تستفيد من العامية المعبرة عن هواجس العامة وأحلامهم.
ولعل تأخر صدور الكتاب هو ما يفسر لنا تأخر الاهتمام بشخصية الشيخ أحمد البديري الحلاق في كتب التاريخ، وسببَ عدم ورود اسمه في كتاب “الطبقات والأعيان” للمرادي الذي احتفل بأعلام القرن الثامن عشر. وفجأة تحول كتاب البديري كتاب الكتب. تحكي السجدي: “شعرت بالغيرة من كتابات التاريخ الأوروبية الحديثة، التي اشتهرت لنجاحها في إبراز تاريخ الطحان”مينوكيو الفريولي، الذي عاش في القرن الـ16، وكشفت نظرته وثقافته، لذا أردت إحياء سيرة بعض العوام في تاريخ بلاد الشام الوسيط، وحذرني من هم أكثر مني حكمة مما سأواجهه من عوائق، فمصادرنا الرئيسة، ولعلها الوحيدة عبر العصور الوسطى، هي كتب تاريخ ألفها العلماء، وفي سياق عصور ما قبل الحداثة، العلماء بالضرورة هم علماء الدين، أي من درسوا واهتموا بالعلوم الدينية والشرعية، ولكونهم الفئة الوحيدة القادرة على الكتابة والقراءة، كتبوا بالأغلب عن أنفسهم ولأنفسهم، فلم يبق للباحث في التاريخ الاجتماعي، سوى نافذة نصية واحدة تطل به على التاريخ الاجتماعي للقرون الوسطى، ونافذة العلماء هذه ضيقة للغاية".
وتقول السجدي: “قضيت عاماً كاملاً في قراءة النتاج التاريخي لعلماء الشام في العصور الوسطى، آملة أن أتمكن من البحث عن دور العامة من الناس، ولكن دون نتيجة. كنت أشعر باحباط شديد إلى أن وقعت عيناي بمحض المصادفة على الحاشية الرقم 13 في كتاب”الفكر التاريخي لدى العرب في العصر الكلاسيكي" لطريف الخالدي، ونص الحاشية “التأريخ الشعبي” لمؤلفة الحلاق الدمشقي في القرن الثامن عشر، او الرّكيني، المزراع في جنوب لبنان في القرن الثامن عشر".
ويعتبر اكتشاف السجدي للمخطوطة الأصلية الوحيدة للحلاق الدمشقي، حدثاً مهماً، كون تأريخ ابن بدير هو المؤلف الوحيد في التاريخ العربي والإسلامي الذي كتبه حلاق، جرأة صاحب “حلاق دمشق” الحقيقية تكمن في فعله البسيط والمذهل في آن واحد، أنه كتب كتاباً! لقد وجد الثقة الكافية في نفسه لاكتساب سلطة مكنته من التمثل بالعلماء على الرغم من أنه لم يتمتع بعلمهم وإجازتهم له، فألف كتاباً في التاريخ، وأبرز تحرك قام به هو تجاوز حدود عمله كحلاق إلى حقل نصي أدبي ثقافي لم تطأه قد حلاق من قبل.
وكانت دانا سجدي قد كشفت في دراستها عن صورة شيقة من التحولات الاجتماعية في مدينة دمشق؛ إذ ركّزت بشكل خاص على دراسة الثقافة الأدبية الشعبية، التي برزت في تلك الفترة من خلال كتابات أفراد من العوام، من خارج الطبقة التقليدية للعلماء والأعيان. وفي محاذاة هذا الظهور لتلك الشريحة على المستوى الأدبي، كان هناك ظهور لطبقة وسطى تنامت ثروتها ضمن التغيرات الاقتصادية، وبدأت بمضاهاة طبقة الأعيان من خلال عمارة القصور والمساجد، ووقف السبل في أرجاء المدينة. هذا بالاضافة إلى ترسيخ ثقافة التنزه واللهو في المجتمع الدمشقي، بين مختلف الطبقات، وتطور طقوسها وممارساتها الاجتماعية، من خلال عادات جديدة رافقت انتشار شرب القهوة والتدخين، وتنامي حضور النساء في فضاءات المدينة العامة.
روايات
وانبثقت حول “التاريخ المصغّر” الذي تناوله البديري، دراسات عديدة مثل “يوميات شامية” لسامر عكّاش، وأخرى استندت إليه في مراجعها الأساسية كـ"ثقافة الترفيه والمدينة العربية في الأزمنة الحديثة، دمشق العثمانية" لمهند مبيضين، لتقديم صورة أوضح عن حضور التسلية واللهو بين مختلف طبقات المجتمع الدمشقي، وتطوّر ممارساته. يكتب الروائي العراقي شاكر الانباري في فايسبوكه “قرأت الكتاب (حوادث دمشق اليومية) بمتعة، وكنت أقيم آنذاك في مساكن برزة، ودهشت لقدرة الحلاق على رؤية تفاصيل ذلك الزمان، بعين ذكية، وروح حساسة، وذائقة انتقاء عالية. دهشت من قدرة حلاق على الكتابة الصادقة والثرية، رغم الأخطاء الإملائية وتفشي اللهجة العامية في المرويات. كنت أفكر بكتابة رواية الراقصة ضمن مستويين زمنيين، الحاضر التسعيني والماضي القريب، أيام الستينيات الدمشقية وكان أبرز وجوهها حياة شارع شيكاغو، الواقع وسط المدينة، وبقي مكانا للسهر والحانات والراقصات والمعارك بين شقاوات العاصمة حتى السبعينيات. حين قرأت يوميات البديري الحلاق عمدت، بسبب تأثيرها واقترابها من أجواء الرواية، إلى إعطاء بعد ثالث للرواية، الراقصة، هو زمن البديري الحلاق، وآل العظم، والحكم العثماني، وإن كان ذلك البعد لم يشكل دعامة أساسية في أحداث الرواية. لكنه على أية حال، وعبر يوميات البديري الحلاق، أعطى للرواية جذورا تاريخية أغنت الأحداث وشخصياتها”.
وذكرت سجدي، في هوامش البحث، أن الروائي ابراهيم نصرالله، استفاد من نسخة منقحة من يوميات البديري الحلاق في روايته “قناديل ملك الجليل”، التي صدرت في بيروت عن الدار العربية للعلوم 2012، وكذلك قالت ان نسخة القاسمي استخدمت كنص رئيس للمسلسل التلفزيوني “الحصرم الشامي” الذي عرض العام 2007. كانت كلمات المقدمة في الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل كالتالي “مائة عام مرت على احداث الجزء الأول، ولم يتغير شيء في المشهد العام للمدينة ما خلا بعض اسماء المنتفعين واصحاب النفوذ والسلطة”.
وثمة جانب مثير للانتباه في كتاب البديري ويتمثل في رصده فتيات الهوى في دمشق. وفي حين تقبل معظم الباحثين رواية البديري هذه بحرفها وتبنّوا موقفه، فإن سامر عكاش، أستاذ التاريخ في جامعة أدلايد في أستراليا، في كتابه الصادر بالعربية “يوميات شامية.. قراءة في التاريخ الثقافي لدمشق العثمانية في القرن الثامن عشر”، يدعونا قبل تحليل هذا المشهد، إلى الوقوف على شخصية البديري وحياته، للتعرف على خلفيته الثقافية وبيئته الاجتماعية والدينية. بالتالي يقول الكاتب السوري محمد تركي الربيعو في تعليق على الكتاب “إذا اعتبرنا ثقافته الشعبية وخلفيته الدينية الصوفية المحافظة، ومصادر رواياته بحكم مهنته، وطرق تركيبها وسردها، فعلينا من البداية ـ وفقا لعكاش ـ أن نكون حذرين في أخذ كلام البديري بكل تفاصيله وبحرفيته على محمل الجد، وفي اعتباره تصويراً أميناً وحقيقياً للواقع الاجتماعي لمدينة دمشق”. و"من الأسباب الأخرى التي تدفعنا إلى التحفظ في التعامل مع نص البديري"، يقول الربيعو، أولاً: “عدم تواتر أخبار انتشار الفسق وبنات الهوى في المدينة من المصادر المعاصرة له، أو التي سبقته، أو التي تلته، وهي كثيرة”. يلاحظ عكاش أن لدينا ستة نصوص لا تقل أهمية عن نص البديري، خمسة عن دمشق وواحد عن حلب. وكتّاب اليوميات هؤلاء ينتمون إلى طوائف متعددة، ويمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، مما يعطينا صوراً وروايات متعددة للمقارنة والتحليل. في كل تلك الروايات لا يوجد ما يؤكد رواية البديري حول انتشار بنات الهوى. والسبب الثاني للتحفظ، هو سجلات المحاكم الشرعية التي تتضمن الدعاوى المقامة على أصحاب الممارسات اللاأخلاقية والمخلّة بالآداب العامة. يرى عكاش أن الصورة السابقة لا يمكن قراءتها بوصفها تعبّر عن انحلال أخلاقي داخل المدينة، بل عن ولادة تحولات عميقة وغير مسبوقة في المجتمع الدمشقي العثماني، أهمها الانفتاح الاجتماعي وتزايد الأجواء الاجتماعية المتغيرة وغير المستقرة.
(*) “حلاق دمشق/ محدثو الكتابة في بلاد الشام إبان العهد العثماني”.
ترجمة البحث: سرى خريس، الأستاذة في جامعة البلقاء الأردنية، ومراجعة المترجم والباحث العراقي سعيد الغانمي، وقد نشر عن “مشروع كلمة” 2018.
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.