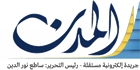جريدة المدن الألكترونيّة
الخميس 05-11-2020
المدن - ثقافة
شريف الشافعي - كاتب وشاعر مصري
أيام إبراهيم عبد المجيد الحلوة.. علاج الواقع وعداواته

الضحكُ أثمَنُ قنصٍ، وأصعَبُهُ، في حياة مصوغة على هيئة شبكة إحباطات وأحزان، وفي واقع مشحون بالمرارات والعداوات، وفي مشهد أدبي مصري؛ على وجه الخصوص، محفوف منذ سنوات بالمعارك والمكائد والأحقاد، وبالشِّلَلية البغيضة التي تضع السدود في مواجهة المغايرين والصاعدين، كي لا يكتبوا ولا يضحكوا.
في كتابه "الأيام الحلوة فقط" (بيت الياسمين للنشر والتوزيع، 2020)، يصطحب الروائي المصري، إبراهيم عبد المجيد، قرّاءه المقرّبين، عبر 240 صفحة، في نزهة حميمية على شواطئ الهزل والمرح، متذكرًا معهم، في بوح اعترافي متدفق بعفوية، “شريطَ عمره” الذي يمكن وصفه -وفق عنوان الكتاب الفرعي- بأنه “مع الأدباء”.
لم يخطط عبد المجيد لكتابة أنيقة معدّة سلفًا، ولم يخض مغامرته بأفكار جاهزة وتصوّرات مسبقة، ولم يضع بروتوكولات لياقة ومحاذير لما يقال وما يُحجب، لكنه مضى ببساطة يستدعي من حمولة ذاكرته الخصبة ألبوم صوره الخاصة جدًّا مع المبدعين والنقّاد والمفكرين والسياسيين وبعض الشخصيات العامة ذات الصلة بالواقع الأدبي، ليحكي عمّا جمعه بهؤلاء جميعًا من مواقف ساخرة، ومقالب، ومفارقات، تفجّر الابتسامة كقنبلة مبهجة، لكنها قد لا تخلو من بارود ومسامير.
الحياة لا تحتمل الجدية
“أن تكون عدوًّا ليس بالأمر السيء”، عنوان اختاره الكاتب لفصل تمهيدي قصير، هو في حد ذاته نكتة، لعله أراد بها أن يضحك على نفسه، أو يتناسى غصة الألم في الحلق “ماذا تفعل حين تجد نفسك محاطًا بالأعداء، أو عدوًّا لأعداء لم يخطروا في بالك؟!”. هو يدرك منذ بداياته أن العداوة تكون مؤسفة ومحزنة حدّ الذروة في المهن الإنسانية، والفنون والآداب، فالمكر والخديعة والكراهية بمثابة قتل للموهوبين والأكثر حساسية، وإن بعضهم “قد يدفع ثمنًا ينتظره أعداؤه، كأن يتوقف عن الكتابة والإبداع، أو يصاب بالجنون”.
من بين هذا الركام من الطعنات، ووسط النفوس المجبولة بالشر من أؤلئك المثقفين، السلطويين وأصحاب النفوذ في الصحافة وأجهزة الدولة في معظم الأحوال، يبدو عنوان الكتاب “الأيام الحلوة فقط” مخادعًا، فلن يكون منطقيًّا استخلاص ما هو صافٍ بلا شوائب، واستحضار ما هو ضاحك بلا دمعات حُمر، لكن لا بأس من المحاولة. ومن ثم، فقد انطلق الروائي، الذي يصف ذاته بأنه “اختار الهامش برضىً تام”، ليؤسطر رحلته مع الإبداع كبانوراما فانتازية، من خلال علاقاته الشخصية، ويومياته، وصداقاته، مكتفيًا باستخلاص ما يراه كوميديًّا في مجمله، وإن كانت تسكنه المآسي الباطنة، وكما يقال، فإن شر البليّة ما قد يُضحك أحيانًا.
هل تحتمل الحياة هذه الجديّة كلها؟ لو انخرط الإنسان في ما يستحقّ الجدّ، كما ينبغي، لما بقي له غير الموت! ولعل فكرة كتاب إبراهيم عبد المجيد تحيل إلى مقولة أوسكار وايلد “الحياة أكثر جدية من أن نأخذها بجدية!”. لقد نال الكاتب المصري كل ما كان يتطلع إليه، وصار بعد سنوات من الجهد والحفر في الصخر، اسمًا مرموقًا في العالم العربي، ونال أضخم الجوائز المحلية والعربية والدولية، وها هو يريد أن يتذكر مشواره المليء بمَن يراهم مخلصين وأوفياء ونبلاء، ومَن يراهم مراوغين ومرواغين وأعداء، فأي مدخل للكتابة غير أن يتذكر ويضحك ويضحك؟!
من خلال الهزل، والسخرية، والتهكم على كل شيء، حتى الوجع، يمكن للإنسان إزاحة قدر من الضغوط والأمراض المكبوتة والطاقة السلبية بداخله، فالمرح هو الفانوس السحري للدعم الروحيّ بل والجسديّ، وهو كلمة السر لتعزيز الفهم العميق للذات والآخرين والوجود. ولم يكن فيلسوف الضحك اليوناني، ديموقريطوس، مجنونًا، لكنه كان يضحك باستمرار ويسخر من كل ما يبدو جديًّا، ولم يكن الطبيب أبقراط موهومًا حين رأى رأس الحكمة نابتة في أرض الضحك، وليس الطب الحديث مبالغًا في دوره، حيث صار يفرد مجالًا واسعًا للعلاج بالفكاهة، لتفريغ الشحنات الضارة للمرضى، والانفعالات المؤذية، ودعم العقل والخلايا المناعية وتحسين مستوى مجابهة الأمراض النفسية والعضوية: “اضحكوا.. تَصِحّوا!”.
إحساس إبراهيم عبد المجيد (74 عامًا) بأنه تمكّن من الانتصار في معارك الكتابة وخصومات الحياة، فتح شهيته على الضحك أكثر فأكثر، واستعادة ما يمنحه السعادة والفخر بعد الرحلة الطويلة. واستشعاره بأنه يقف الآن “في قلب المتن” محاطًا بـ"دائرة قرّاء واسعة"، جعله يتيقن من أنه كان على صواب حين أدرك في خطواته الأولى أن “العالم واسع فسيح الأرجاء”، وأن الذين حاولوا منع كتاباته من النشر كانوا ضيقي الأفق. وفي فسحة مراجعة الماضي، من مقعد المنتصر “صمّمتُ على كسر الحواجز التي أقاموها”، يختلط الضحك بالتسامح أيضًا: “بدأتُ حياتي بحبّهم، وانتبهتُ متأخرًا جدًّا أنهم لا يحبّون إلا أنفسهم، ولم أعاتب أيًّا منهم أبدًا”.
أسماء وحكايات ومواقف كثيرة طاف حولها عبد المجيد في كتابه، من دون غوص تحليلي متعمق لم يكن موضوعًا للكتاب أصلًا، فالسارد أراد نقلًا ميكانيكيًّا ظاهريًّا للقطات صغيرة وكادرات قريبة، بلا رتوش ومعالجات وفلسفات، كأنه يدردش في مقهى، ويلوّح بيديه وهو يقصّ، وينفعل بحدّة، ويضحك بالضرورة، ويبكي أيضًا من شدة التأثر.
أنا رايح للفشل والنجاح
بين سعيد الكفراوي؛ “صديق العمر الجميل”، الذي أهداه عبد المجيد كتابه، وخيري شلبي، ونجيب سرور، وسمير سرحان، ومحمد كشيك، وإبراهيم أصلان، ومحمد البساطي، وبهاء طاهر، وعبد القادر القط، ومحمد عفيفي مطر، ونوال السعداوي، وأحمد الحوتي، والتشكيلي محمود بقشيش، وأحمد عفت (وزير النقل)، وفاروق حسني (وزير الثقافة)، ورفاق العمل في شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، وفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، وغيرهم من المبدعين والفنانين والسياسيين والشخصيات العامة... حاول إبراهيم عبد المجيد أن يلوذ بالدفء والألفة في مشاوير “الفلاش باك” عبر الزمن، متناسيًا ما سمّاه باللحظات “الوِحْشة” التي تقود إلى اليأس والضجر وعدم الارتياح: “لا أحب أن أتذكر المسيئين إليَّ، أو الذين حاولوا الوقوف في طريقي بقطع عيشي في كل مكان أكتب أو أعمل فيه، في السنوات الأولى من حياتي، ولأكثر من عشرين عامًا”.
هذا الدفء، المقترن بالضحك، قرنه الكاتب كذلك بالموسيقى. ففي ختام كل فصل، يحكي عن طقوس كتابته، والموسيقى المصاحبة للتأليف، مستعرضًا رؤيته حول أعمال الموسيقيين العالميين، خصوصًا الروس، من أمثال برودين وكورساكوف وتشايكوفسكي ورحمانينوف، ويعترف عبد المجيد بأن هذه الموسيقى، إلى جانب قراءته للأدب الروسي، جعلت حلم حياته أن يذهب إلى روسيا، أكثر من انتمائه إلى الشيوعية في ذلك الوقت.
ويكشف الكاتب علاقته بالحزب الشيوعي المصري، وكيف اختلف نشاطه بعد نزوحه من الإسكندرية إلى القاهرة: “انطويتُ بعد العام 1972 تحت قبة حزب شيوعي سري، هو الحزب الشيوعي المصري، وانزلقت قدمي إلى السياسة، حتى تركت هذا الحزب العام 1978. وجدت أن جلسات الأدباء في القاهرة مليئة بالأفكار الكبرى، والجميع بلا استثناء ضد سياسة أنور السادات. لم نكن في الإسكندرية نتذكر أن حولنا سياسة. كل مَن قابلت في القاهرة كان تقريبًا غير متوافق مع المجتمع، فقررت الرحيل عن الإسكندرية، وقلت لأصحاب عمري من الأدباء السكندريين: في القاهرة أسباب للفشل والنجاح، لكن هنا قد يكون الفشل إلهيًّا، فنحن ننتهي من الندوة، نلعب طاولة، ونأكل ساندوتشات فول وفلافل من محل محمد أحمد، ونروّح مبسوطين، والدنيا أكبر من كده؛ أنا رايح للفشل والنجاح”.
لا يضع عبد المجيد سقفًا لاعترافاته، ولا فرق في الأهمية لديه بين حكيه الحماسي عن جلسات ندوة نجيب محفوظ، وحكيه بالحماس ذاته عن جلسات الحشيش برفقة بعض الكتّاب والأصدقاء، وتجرّع زجاجات “ستيلا” في مقاهي المثقفين الشهيرة بوسط البلد، وفي “الغُرَز” (المقاهي الصغيرة) البائسة والتافهة!
العشاء فوق صحف المُكفِّرين
من المضحكات المبكيات التي يتذكرها إبراهيم عبد المجيد، في اعترافاته، أزمة “تكفيره” بسبب نشر رواية، وذلك في أثناء توليه رئاسة تحرير سلسلة “كتابات جديدة” الأدبية التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة سمير سرحان في ذلك الوقت من تسعينات القرن الماضي. وقد تفجرت الأزمة بنشر السلسلة رواية “الصقّار” للكاتب الشاب سمير غريب علي، المقيم في باريس حاليًا. فما إن صدرت الرواية، حتى قامت الدنيا ولم تقعد بسبب مقال لفهمي هويدي في “الأهرام” اتهم فيه إحدى شخصيات الرواية بالتجديف، وشاركه في الموقف جلال أمين، وانضم إليهما عدد من كتاب جيل الستينات.
يسترجع عبد المجيد تفاصيل هذه الواقعة بمرارة تنتهي بدورها بطرفة “كنت أعرف الشرخ الذي بيني وبينهم بسبب رواياتي، وكيف ازداد بعد صدور”البلدة الأخرى" و"لا أحد ينام في الإسكندرية" اللتين حصدتُ بهما شهرة كبيرة، وقد نشر كاتب كبير منهم مقالًا في “المصور” يشيد فيه بفهمي هويدي كمفكر كبير. كنت أحتفظ بالصحف التي تشتمنا وتكفرنا أو التي تدافع عنا. عدت يومًا إلى البيت مهمومًا من هذا الجو الغريب الذي لم أصادفه إلا في قراءات عن أمم الجهل. طلبت مني زوجتي الأولى رحمها الله، أن نأكل على الأرض مثل أهالينا زمان. وافقت مبتسمة، وإذا بها تفرش الأرض بالصحف وتضع فوقها الطعام. نظرت إلى الصحف، فوجدتها كلها هي التي تحمل المقالات المعادية أو المؤيدة، فسألتها: لماذا تفعلين ذلك؟ قالت: هذه هي الصحف يا إبراهيم، إما أن يأكل عليها الناس أو يمسحوا بها الزجاج.. فَضّي دماغك واسمع الموسيقى واكتبْ واقرأ!". بعدها لم يهتم عبد المجيد بالمسألة قط، وكأن حادثة تكفيره مع مؤلف الرواية ومسؤولي السلسلة مجرد مزحة!
معجزة المطر
هكذا، لا تخلو ضحكات كتاب عبد المجيد من ثقل أدبي، وربما رصانة سياسية، فهي ضحكات متبادلة مع مثقفين ومفكرين، ومن أكثر أيام الضحك التي يستدعيها ما حدث في العام 1991، خلال حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي، حين كان يدير “المقهى الثقافي” بمعرض القاهرة للكتاب، وكان الطقس باردًا جدًّا، واحتمالات المطر رهيبة. كانت هناك يومها ندوة لنوال السعداوي، وإذ بها تترك موضوع الندوة عن أعمالها والمرأة في مجتمعاتنا وتتحدث عن حسني مبارك وخيانته للعراق وتآلفه مع أمريكا في الغزو، وتشتم أميركا بأقذع الشتائم، كما راحت أيضًا تشتم حسني مبارك!
ويحكي صاحب الضحكات النادرة: “وقفتُ حينها على باب المقهى مندهشًا لا أُعلِّق، وإذا بحسن سرور المساعد لي يقترب مني يقول: ماذا نفعل؟ سوف نسجن كلنا، لا بد أن أحد المخبرين موجود في الندوات! قلت له: لن أقاطعها، وقادر ربنا الدنيا تشتي (تمطر) وتغرق الخيمة على مَن فيها! وما كدت أنتهي من كلامي، حتى ظهرت سحب سوداء فوق المعرض وهطل مطر شديد، وجرى كل مَن في الشارع يحتمي بالخيمة التي ازدحمت بالواقفين والداخلين، ووقع بعضهم على الأرض وفوق بعضهم وانقطعت الكهرباء وتوقف الميكروفون، وحسن يضحك ونحن نكاد نحمل الدكتورة نوال من بين الزحام ونخرج بها بعيدًا! انتهت القصة وحدها، وحسن يقول لي: أنت وليّ.. وليّ!”.
من النكات السياسية التي يحكيها عبد المجيد في كتابه أيضًا، تفاصيل لقاء المثقفين والرئيس حسني مبارك في معرض القاهرة للكتاب “حيث كان الرئيس نفسه يحوّل الأسئلة الجادة إلى سخرية، فلا يكون أمامنا إلا الضحك”. ومن تلك القفشات، أن سألته الكاتبة سلوى بكر قائلة: “لماذا لا يحصل أبناء الزوجات المصريات اللاتي تزوجن عربًا على الجنسية المصرية؟”، فكان جوابه “يعني هما العرب بس اللي عندهم صحة؟ ما المصريين زي الفل!”. وبعد ذلك بسنوات، حصل أبناء المصريات المتزوجات من العرب على الجنسية المصرية، لكن بتوجيه من سوزان مبارك، والمجلس القومي للمرأة.
ويرتحل إبراهيم عبد المجيد مع الضحك إلى كل مكان في داخل مصر، وفي خارجها أيضًا، حيث رحلات المثقفين المصريين إلى باريس، وندواتهم وجلساتهم في المقاهي وعربدتهم وتسكعهم في الشوارع، ويتمنى في نهاية كتابه المذكراتي أن يكون قد نجح في النجاة من الإثارة، بعدم ذكره اسم كلّ جبّار أثيم، ممن لا يستحقون الذِّكر!
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.