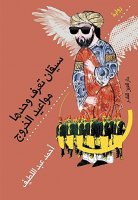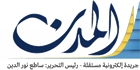جريدة المدن الألكترونيّة
الإثنين 24-06-2019
المدن - ثقافة
أسامة فاروق - كاتب مصري
أحمد عبد اللطيف لـ"المدن": أخشى تحول الرواية منشوراً سياسياً

في روايته الجديدة “سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج” يكتب أحمد عبد اللطيف عن سلطان ذاق حلاوة السلطنة فأغرته. وعن شيخ كان يقرأ ويكتب ويعرف. معرفة الشيخ أقلقت السلطان لأن الشيخ يغرف من معارفه للآخرين، وينشر ما يعرفه بين الناس. فيقرر السلطان التخلص من الشيخ ومما يعرفه الشيخ ومما ينشره الشيخ.
يجمع أهل السلطنة وأمامهم يحرق كتب الشيخ، وأمامهم يفقأ عين الشيخ، ويأمر حراسه بقتله والتخلص من جثته. لكن الشيخ لا يموت، لأن الفكرة لا تموت والكلمات لا تضيع، يراقب الشيخ من قبوه المسحور عينه التي أنبتت ألف عين، وأهل المملكة الذين قرروا التحصن في بيوتهم وحفر مدينة أخرى تحت مدينتهم التي أغرت السلطان. يراقب الصمت الذي أقلق السلطان أكثر من الكلام.
لم يكن الشيخ وحده الذي يراقب ما يحدث كان معه المعري، وبورخيس، ودانتي أيضا جاؤوا ليعاينوا بأنفسهم تأثير ما تركوه من أفكار، وليقرؤوا معا من “كتاب الأحلام” الذي يُكتب في زمن آخر، يكتبه ابن لهم، كاتب ينتمي إليهم، وتعيش مدينته (القاهرة) أزمة مشابهة، بعدما طاولتها لعنة الدم التي تطارد سافكيها طوال حياتهم.
مطاردون من حراس مدينتهم، يتخبط أهل القاهرة في ميدان التحرير ومحمد محمود باحثين عن مخرج لثورتهم، والابن الكاتب يسير كالمنوم بين أحداث اليوم التي يعيشها ويدونها في كتاب أحلامه، وبين أحداث الأمس التي يتابعها في الوقت نفسه من كتاب “ما لم يرد ذكره في قصة القبو المسحور” فيعرف أنه بعد اختفاء أهل المملكة طار النوم من عيون السلطان، وأنه أخذ يفكر كيف بدأ كل شيء، في الأصوات التي تمردت على الجباية، والأصوات التي تمردت على التلصص، وسوء معامله الحراس، والأصوات التي اعترضت على ما حدث للشيخ الذي كان يدون التاريخ، لكنه كان أيضا يعد قائمة عن المختفين فاستحق عقابه.
لكن السلطان رغم ذلك لا يطمئن، يصيبه الصمت بالجنون، فوحدهم أهل المدينة كانوا يعرفون الأسطورة التي تناقلوها جيلاً بعد جيل عن المدينة الأخرى الموجودة تحت مدينتهم، تلك التي حفرها الناس بأيديهم في فترة حكم سلطان أعرج ومجنون كان يأمر الناس بالسير على ساق واحدة، وقطع الساق الأخرى لمن لا ينفذ الأمر، ولما تكاثرت السيقان أمرهم بحفر قبور لدفنها تحت المملكة، وفى يوم خرجت السيقان وحدها من قبورها وقتلت السلطان وحاشيته وحراسه وأهل المملكة الذين لا يستحقون الحياة، ولم ينج من تلك المذبحة إلا الأطفال، فحملتهم السيقان إلى الضفة الأخرى في عمق الصحراء ليبدأوا حياة جديدة.
الأسطورة تقول أيضاً إن السيقان عادت إلى قبورها أسفل المملكة، وعاد الأطفال بعدما كبروا ليعمروا مملكتهم القديمة، وكلما اشتد الظلم والجور فكر أهل المملكة في السيقان وتوقعوا ظهورها، لكنها وحدها كانت تعرف ميعاد الخروج. هنا يتحدث أحمد عبد اللطيف للمدن بالتفصيل عن الثورة والكتابة والرواية الجديدة.
- أنت مُحتكّ بثورة 25 يناير بشكل مباشر من البداية وبحكم عملك الصحافي أيضاً، فلماذا احتاجت الثورة كل هذا الوقت لتخرج في عمل فني؟ متى فكرت في “سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج” ومتى كتبتها ومتى قررت نشرها ؟
أظن أن الثورة كحدث كبير تحتاج إلى بعض الوقت لتأملها وللامتلاء بها وجدانيًا حتى يمكن صياغتها في عمل أدبي، وثورة يناير كانت أكبر من التفاعل معها على عجالة، خاصةً أني لا أسعى إلى توثيقها أو تقديم حقيقة ما عنها بقدر ما أسعى إلى كتابة تصورات على هامشها. أصدق ما قاله ساراماغو أنه “لفهم الأشياء الكبيرة يجب فهم الأشياء الصغيرة”، والأشياء الصغيرة، هذه العابرة التي قد لا تلفت الانتباه كثيرًا، هي ما تحتوي على الفن. لذلك، على مدار السنوات السابقة كانت فكرة الرواية تراودني، لكنها كانت غائمة ولم تتحول بعد إلى صور في ذهني، وحتى أكتب رواية أحتاج إلى أن تتحول إلى صور فوتوغرافية أو شريط فيديو يمر بذاكرتي. حدث ذلك بعد أن انتهيت من كتابة “حصن التراب” في 2016، وظل عالم “سيقان تعرف” السردي يتكوّن على مهل، وعلى مدار ثلاث سنوات تقريبًا كان سؤال الثورة والسلطة من الأسئلة المُلّحة، بجانب سؤال المصير الإنساني.
- رغم التأخير أو التأجيل كما تقول، فالرواية مشغولة بالمآلات وليس برصد ما حدث في الثورة. أم أن هذه المآلات هي الدافع للكتابة أصلاً ؟
لا أعتقد أن فن الرواية يجب أن يشغل نفسه برصد ما حدث، خاصةً أننا نعيش في عصر الصورة، حيث كل شيء يمكن العثور عليه على اليوتيوب أو الأرشيف الديجيتال أو حتى الكتب السياسية أو التاريخية التي تناولت الثورة أو ستتناولها. فن الرواية مشغول بأسئلة أخرى غير الرصد، ربما قراءة الواقع أو اختراع واقع بديل، ربما فرض افتراضات أخرى لنلمس بها الحدث، ربما استدعاء التاريخ أو خلق عالم سردي نفسي وذهني لبطل يشبه الثورة، في حماسه وهزيمته. دعني أعبر لك عن خوفي الدائم من تحول الرواية إلى منشور سياسي، أو الوقوع في فخ المباشرة في التوثيق بدافع تخليص الضمير وأداء الواجب الوطني. كنت أتطلع إلى كتابة رواية عن الثورة على السلطة في المطلق، رواية تعمل بمعولها على الهدم من دون التفكير في البناء، وتعمل كنافذة صغيرة نتطلع منها إلى واقع بديل، من دون أن تجسّد ما حدث، إنما بالأحرى تسعى إلى تجريده وتحويله إلى صور سوريالية. وسواء كانت مآلات الثورة مخيبة للآمال أو ضربة خنجر في جسد الخوف، فالثورة في تصوّري فعل مستمر لا يمكن أن يتوقف، والسلطة، أي سلطة، حتى لو كانت معبّرة عني أيديولوجيًا، تأتي بأسباب الثورة عليها. ربما لهذا السبب سيظل هناك سلطة، وهناك ثورة، وهناك كتابة تنحاز للثورة، وهناك مصائر إنسانية تلفتني لتدوينها.
- لكن على مدار السنوات السابقة، رأينا الرواية تقوم بأدوار أخرى، فإذا لم تنشغل بالرصد ولم تخترع الواقع البديل، فهل يمكن أن يكون دورها في حدث كهذا التوثيق مثلاً، أو النصيحة أو ربما التحريض أم تقديم البدائل والحلول؟ كل ما سبق أو لا شيء مما سبق ؟
دور الرواية الأساسي أن تقدم عملًا جماليًا يترك أثرًا في ذهن المتلقي، وأن تثور من داخلها على الأشكال الكلاسيكية لتقدم ثورة في الكتابة، فمن غير الممكن أن تكتب عملًا عن الثورة وأنت كاتب تقليدي، بلا طموح في التجريب، وممتلئ بالخوف من المغامرة. أما عن دورها من حيث المضمون فلا النصيحة ولا التوثيق، ولا التحريض وتقديم الإجابات، من مهام الرواية كفن. إنما مهمتها هي توفير هذا الكم المعقول من الرؤية وبناء عالم سردي يثقب الواقع ليصنع به عينًا سحرية. الرواية هي فن التعمق في الشيء والوصول إلى قلبه، حينها لن تحتاج كروائي إلى نصح أو تحريض، لأن القارئ، الذكي لأنه قارئ، سيصل معك إلى حيث أردت.
- بمناسبة حديثك عن القارئ، الرواية مُجهدِة إلى حد ما في القراءة، تحتاج إلى تركيز وإعادة قراءة لأن الشخصيات تتشابك والخيوط كلها كذلك، الإمساك بالخيط ومتابعته للنهاية (بتركيز) هو ما يجعل الرواية ممتعة.. كيف ترى هذه المسألة؟ ومتى تفكر في القارئ.. أثناء الكتابة أم بعدها ؟
أتفق معك أنها تحتاج إلى تركيز لأن الحدث موزع على مساحة كبيرة في الرواية، فالقارئ يحتاج إلى جمع التفاصيل المتشظية ليكتمل لديه الحدث، كذلك الشخصيات (على قلّتها) متشابكة في علاقاتها. هي اللعبة السردية أو التكنيك الذي أتطلع للعمل فيه والتجريب في إمكانياته، هو طموح روائي كذلك يحاول إضافة شيء إلى فن الرواية. أحاول، وأتمنى لو أنجح، في خلق نموذج سردي لا محاكاة نماذج جاهزة. أما القارئ فهو شريك في العمل، لأنه يفكر في مصائر الشخصيات ويبحث عن العلاقات بينها، ويخرج بتصورات تخصه ليست بالضرورة تصوراتي. التفكير في القارئ كشريك يأتي بعد نهاية العمل، لأنه لو ظهر أثناء الكتابة سيكون رقيبًا ولن ترضيه في النهاية المسودة الأخيرة. وعمومًا، أنا أثق في ذكاء القارئ وأحاور هذا الذكاء.
- يختار أهل المدينة الاختفاء الاختياري عوضاً عن الاختفاء القسري.. أليس في هذا الاختيار نوع من الإقرار بالهزيمة، خصوصاً بعد أن يقول الراوي مثلاً “ثار أهل المملكة لما علموا عبر الكلمات التي تسللت إلى نفوسهم أن الثورة على الظلم عبادة، فعل تقوى، وأن الصمت طريق إلى الجحيم” ؟
ليست هزيمة إطلاقًا، وإنما مناورة. مَن سيحكم السلطان لو غاب الشعب؟ مَن سيقمع ؟ المسألة أن الشعوب لديها القدرة على هدم أي سلطة لو عرفت قدرتها، لو أدركت اللحظة المناسبة للخروج من اللعبة. إذا كان الحكام يحبون طاعة شعوبهم، ولديهم القدرة على إخضاع هذه الشعوب، وهي مسألة لا شك فيها، وهو تصور الرواية بالمناسبة، فالمناورة هي انسحاب الشعوب من اللعبة غير المتكافئة، هذا الانسحاب، من دون إراقة الدماء، ومن دون دخول في معركة أحد أطرافها مسلح والطرف الآخر أعزل، هو الانتصار الحقيقي للشعوب، لأنها ورقة الضغط الرقيقة التي لا تستطيع أي سلطة مواجهتها. هذا العصيان هو ما يسحب من السلطة نفوذها، فبدون مظلوم ينتهي الظالم، وبدون شعب لا وجود لحاكم. ربما تبلورت هذه الفكرة في فترة ما بعد الثورة، حين كان النزول في المظاهرات ليس إلا سببًا إضافيًا لتمكين السلطة وفرض سيطرتها، وبث الخوف في الجميع. تخيل معي لو اجتمع شعب ما على العصيان المدني، ستتوقف الحياة، وحينها يصير الطرفان متعادلين، والتفاوض على أرضية متساوية. لاحظ أن اختباء أهل المدينة لم يكن أبديًا، إنهم خرجوا في اللحظة المناسبة، حين اكتشفوا الحقيقة، حقيقتهم ذاتها.
- تشير صراحة إلى “رسالة الغفران” و"الكوميديا الإلهية" و"الموت والبوصلة"، وفي فصول أخرى تظهر ملامح واضحة للواقعية السحرية، كيف ومتى تحدد الشكل الفني الذي تريد أن تخرج عليه الرواية ؟
الحقيقة أني لا أحدد شيئًا في البداية، أنا أستسلم لسلسة من الصور التي تتكوّن في ذهني، ثم أطوّر هذه الصور فيما بعد، أو أحوّلها من صورة إلى كلمات. الأشياء لا تظهر لي واقعية فأقوم بتحويلها إلى شيء آخر، بل تظهر كما تقرأها أنت، بتجريديتها أحيانًا، بغموضها، بالتباسها، تبدو أحيانًا كحلم يقظة، لا أسعى إلى المجاز بل الصورة المجازية تسلم نفسها لي، هكذا أؤمن بالإلهام والموهبة، أبذل أقل جهد ممكن في الكتابة، ولا أجلس لأنتظرها. قبل كتابة “سيقان تعرف” كنت أعيد قراءة “رسالة الغفران”، حينها نبتت الفكرة في ذهني، فقررت إعادة قراءة “الكوميديا الإلهية” على مهل ومن دون فصل بين أجزائها، ثم عدت إلى رحلة الإسراء والمعراج واطلعت على تفاصيلها المذكورة في المصادر التراثية، حينها رأيت أبطالي يخوضون رحلة شبيهة في أرض أخرى. هذه الكتابة ليست واقعية سحرية كما قد يبدو، أحب أن أسميها “واقعية حلمية” لأنها بعيدة عن الثقافة الشعبية التي تميز الواقعية السحرية، وتقترب من فانتازية الحلم وغموضه.
- استلهمت “رسالة الغفران” كفكرة وكبناء فني، توقعت أن يظهر المعرّي كشخصية روائية لكنه لم يكن أكثر من اسم.. أقصد انك استفدت منه ككاتب أكتر منه شخصية روائية، وربما الأمر نفسه مع دانتي وبورخيس أيضاً.
أبو العلاء المعري ودانتي وبورخس، داخل العمل، كانوا أكبر من أسماء مذكورة أو عابرة. لاحظ أني فككت شخصياتهم وذوّبتها في أبطال العمل، فكان كل واحد فيهم مزيج من الثلاثة. في المقابل، لم أكن أرغب في كتابة سيرة المعري، مثلًا، وإنما امتصاص هذه الروح والرؤية، استحضار هذه البصيرة، إحلال أبو العلاء في جسدَي شخصيتين تعيشان في زمنين مختلفين. مؤلف كتاب “ما لم يرد ذكره في قصة القبو المسحور” ومؤلف “كتاب الأحلام” علائيان، دانتيان، بورخسيان. لذلك لم أسع لتطويرهم روائيًا، لأنهم يتطورون عبر شخصيات أخرى، وهذا، في رأيي، يعبّر عن تقديري لأبو العلاء تحديدًا، لأنه بذلك يخرج من فكرة كونه شخصًا، إلى روح تسري في أجساد آخرين.
- ابتعدت في الرواية عن الأسلوب الذي اتبعته في أعمال سابقة كـ"حصن التراب" مثلاً، والتي تعتمد في الغالب على تكرار جملة أو أكثر من المقطع السابق في بداية الجملة الجديدة، لم يختف هذا الأسلوب تماماً في الرواية الجديدة حيث ظهر في بعض الفصول أيضاً، لكن بشكل متقطع.. هل رأيت أنه لا يناسب أجواء هذه الرواية ؟
كنت أفكر في تقليل التكرار اللغوي في مقابل التوسع في التكرار في الأحداث. فكرتي أن التكرار كسمة أسلوبية لا تتوقف عند اللغة فحسب، بل تمتد إلى الحدث نفسه، فلسفة ذلك ربما يمكن ردها إلى فكرة العود الأبدي، وهي الفكرة التي سيطرت تمامًا في رواية “إلياس” وخفت وطأتها في “حصن التراب”. في “سيقان تعرف” تتجلى سمة التكرار في تدوير الحدث أو العودة إليه بتفاصيل جديدة، بدون أن يغيب التكرار تمامًا عن اللغة. في النهاية أنتصر لإيقاع اللغة على أن يكون ذلك صالحًا لطبيعة الشخصية والحدث المروي.
- فكرة المدينة الموازية تحت الأرض، قُدّمت في أعمال من قبل، ألم تخشَ اتهامات التكرار ؟
لم تكن فكرة “سيقان تعرف” تشييد مدينة تحت الأرض يمارسون فيها حياتهم كمدينة موازية، وإنما مكان يصل إليه الناس فتتجلى لهم الحقائق، إنه قبو، إنه برزخ، إنه مكان أسطوري يشبه كهف أفلاطون لكن سكانه المؤقتين ليسوا مقيدين، بل العكس، كانوا مقيدين وصاروا طلقاء. لذلك فعميان الدنيا وصلوا إلى هناك فاستردوا بصرهم، وسكان المدينة والمملكة، حين يصلون إلى هناك، يجتمعون للخروج بعد أن انكشفت بصيرتهم الكاملة. لا أعرف أعمالًا تناولت هذه الفكرة بتفاصيلها وفلسفتها، وإن كنت لا أمانع في تلاقح الأعمال، فالكتابة بنت الكتابة كما هي بنت الواقع.
- أنت مخلص للترجمة كذلك، قدمت أعمالا مهمة في هذا المجال، كيف أثر عملك كمترجم على أعمالك الروائية ؟
على عكس ما يتصور البعض، فالعمل في الترجمة يعطل مسيرة الكاتب ويشتته، خاصةً لو كان مترجمًا أدبيًا محترفًا. في الحقيقة أنت تمنح لغتك ككاتب للمترجم، تمنحه قاموسك اللغوي، وتمنحه وقتك اليومي الذي يجب أن تكرسه للكتابة أو ما يتصل بها، لأن الكتابة تحتاج إلى هذا التفرغ، إلى الصفاء الذهني والتأمل بعيدًا عن الكتب نفسها. في المقابل، استفدت كثيرًا من القراءة، وهي هوايتي الأولى، وكنت محظوظًا لأن بوسعي القراءة بلغات أجنبية. هذا ما يثري الكاتب، القراءة وليست الترجمة.
(**) أحمد عبد اللطيف روائي ومترجم وصحافي مصري، صدرت له خمس روايات والعديد من الكتب المترجمة. فازت روايته الأولى “صانع المفاتيح” بجائزة الدولة التشجيعية العام 2011، وفازت روايته الثالثة “كتاب النحات” بالمركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية العام 2015، ووصلت روايته الخامسة “حصن التراب” للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية العام 2018. “سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج” هي روايته السادسة وصدرت عن دار العين للنشر.
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.