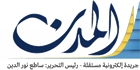مقال جريدة المدن الألكترونيّة
جريدة المدن الألكترونيّة
السبت 14-02-2017
الصفحة : ثقافة
شريف الشافعي
"قطط العام الفائت".. الثورة تنسج إبداعًا كي تتكرر
على مسرح الأحداث المتخيلة، وفي الحياة أيضًا، هناك “أشخاص خطرون” منفيون إلى الماضي، سيقوا قسرًا خارج اللحظة، ظنًّا من السلطة الباطشة أنها باتت في مأمن من “شرورهم” و"شراراتهم". الروائي هنا، في حقيقة الأمر، مثله مثل حاكم البلد الذي تدور فيه الوقائع، كلاهما يدرك أنه يتعامل مع الواقع ظاهريًّا، ويستدعي ماضيًا ليس له وجود سوى في ثلاجة الموتى، فيما يتقلب قلبا كلٍّ منهما (الروائي والحاكم) في السماء، ترقبًا لمستقبل قد تشعله تلك الشرارات، فيكتسح قانون هذا المستقبل كل شيء.
في روايته “قطط العام الفائت”(*)، يلجأ الكاتب إبراهيم عبد المجيد إلى “الرمز” الذي هو ليس رمزًا، فاللعب على المكشوف باصطلاح “السياسة”، التي هي المنبع الفعلي لكتابة هذا العمل، بإسقاطاته المباشرة، وآلياته الخطابية والتعبيرية.
السارد العليم يتحدث بوضوح، منذ السطور الأولى للحكاية حتى آخر كلماتها، عن مصر، وثورة 25 يناير 2011، وما سبقها وأعقبها من أحداث معروفة وموثقة، الأمر الذي يجعل “الإهداء”، ربما، أقرب لسخرية مقصودة، يبقى صداها مترددًا بين ثنايا الرواية: “في بلد يسمى (لاوند)، قامت ثورة في اليوم نفسه، التي حدثت فيه الثورة في (مصرايم). هنا ما جرى في (لاوند)، وأي تشابه مع الواقع غير مقصود”.
لا يقص السارد العليم، ولا يتحدث الشخوص، باللغة “اللاوندية” بطبيعة الحال، بل بلغة “الحالة المصرية”، المفهومة حتى لغير قراء الأدب من محترفي التأويل ومستكشفي خباياه الفانتازية، فالنص “مذكراتي ألبوماتي” برمته إذا جاز التعبير، منحاز، ضمنيًّا وظاهريًّا، إلى ما يمكن وصفه بـ"مبادئ ثورة 25 يناير" (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، وإلى معتنقيها، خصوصًا من “الشباب”، مفرقا بين هؤلاء “الورود”، وبين كثيرين آخرين قادوا أو صنعوا أو شاركوا أو انتسبوا أو تكالبوا على تلك الثورة.
لربما كان هناك، خارج معيار الإبداع، ما يمنع الكاتب من استخدام الأسماء الحقيقية للشخوص والأمكنة، والعناوين الفعلية للوقائع، لكن من الوجهة الفنية، على سبيل المثال، فلا تكاد تبدو رمزية أو دلالة لأن يكون مقتل “فاضل سعيد” (بدلًا من خالد سعيد) هو محرك إشعال الثورة، ولا لأن يسمى وزير الداخلية بـ"وزير الأمن"، على سبيل التورية، ثم إذ به يتحدث (وكأنه يقرأ من صفحات التاريخ) عن واقعة موت “فاضل سعيد”، وعن أجواء الانتخابات البرلمانية التي سبقت يناير 2011، وتصاعد نفوذ ابن الحاكم (المهيّأ للتوريث) مخاطبًا الحاكم “أمير أبو العساكر” بقوله: “في البداية أريد أن أعيد التأكيد أننا لم نقتل فاضل سعيد، هو شاب حشاش، وأنتم تعرفون القصة، لكن جهات أجنبية لعبت في الحكاية. كما أني لم أزوّر الانتخابات إلا بتعليمات من ابن فخامتك، وكان رأيي أن ينجح بعض المعارضة، كديكور يعني”.
هنا، حصة التاريخ كاملة، بعيون كاميرا ميكانيكية، على أنها لا تدعي الحيادية في نقل المشهد، إذ تعترف بوضوح بنقله من جهة “إدارة ميدان التحرير”، على طول الخط، (حتى في الحوارات السرية بين الحاكم وزوجته، في غرفة النوم، إذ لا يكفان عن الإهانات المتبادلة، وتصوير كل منهما للآخر على أنه “جاهل” أو “عاجز”، الخ)، فيما تبدو آراء وتصورات الآخرين، حتى من خارج فريق السلطة المضاد أو محل النزاع ودائرة الانتهازيين والمنتفعين، مجرد سحابات ضالة وظلال باهتة، خاضعة بالضرورة لتأويل “عقل الكاميرا” المفكر، بل وتقييمه، وهو ذلك العقل الإلكتروني، المبرمج فقط وفق سلطة الراوي العليم، بأحكامه شبه المطلقة.
ربما تجد لغة اليقين والإحالات المباشرة إلى العارض الواقعي الزائل موقعها من الإعراب عند أكثر المتفائلين من السياسيين، أو الإيديولوجيين، أو حتى الثوار، ممن تتسق قناعاتهم الفكرية مع مقولاتهم ومع تصرفاتهم وسلكوياتهم الطبيعية على الأرض بضرورة الحال، لكن حين تهدأ منصة الميدان، أو يزول أثرها التهييجي، فما موقع لغة “قصيدة الثورة”، مثلًا، بخطابيتها وشعاريتها وربما زعيقها، في عالم الشعر الآن؟ وما مدى تقاطعها مع المشترك الإنساني الباقي للأبد؟ وماذا يتبقى منها لو أن متعاطيها قارئ من مكان أو زمان آخرين، خارج بؤرة اللهب “المؤقتة”، مهما عظم شأن الحدث؟ وهل الأجدى، فنيًّا وحتى إنسانيًّا وعمليًّا: أن تكون قصيدة الثورة دعوة إلى الثورة، وتمجيدًا لفظيًّا لها، أم أن تحقق القصيدة ذاتها ثوريتها الخاصة، جماليًّا، من الداخل، بتمردها على الثوابت وخلخلتها المألوف، وتحريكها كل جديد في روح وذائقة متلقيها، بما قد يدفعه شعوريًّا أو لا شعوريًّا إلى الإيجابية والتغيير؟
هذه التساؤلات المقترحة في الأدب، وغيرها، لا شأن لها بطبيعة الحال بموقف العمل الأدبي وكاتبه من ثورة 25 يناير، أو أي حدث أو واقعة أو قيمة أو إيمان أو معنى نبيل، وما إلى ذلك. المؤاخذة أو التقييم بالمواقف والاتجاهات ربما تجد لها مكانًا بين السياسيين بعضهم البعض مثلًا، وربما تطول الأديب بشكل عارض حال كتابته مقالًا أو إقدامه على فعل ما، أو إحجامه عن ممارسة أخرى. أما حين تتجرد الأفكار والمعطيات كلها بين دفتي عمل أدبي، فلا مجال للتحليل، كما أنه لا مجال للتحليق، سوى بجناحي الإبداع، بماهيته المجردة، وجمالياته الغائية.
“قطط العام الفائت”، رواية كبيرة وعميقة، لم تكتف بالرصد المجاني للأحداث وتداعياتها خلال السنوات السبع الأخيرة، لكنها حاولت من خلال السرد التفصيلي لوقائع التاريخ أن تحدث ثقبًا في جدار المستقبل، لتستشرف “ماذا سيكون” بعد هذه المستجدات كلها، والأيام المتتالية بانتصاراتها وانكسارتها وتحدياتها وجنونها الصارخ.
المعطى الأدبي، الأكثر وضوحًا في رواية إبراهيم عبد المجيد، يمكن تحسسه في أمرين أساسيين؛ الأول: النزعة الفانتازية، والثاني: النبوءة. وهذان الأمران يعودان مرة أخرى كي يخدما “فكرة” أنتجها السياق الأدبي، هذه الفكرة هي أن “الثورة قادمة”. في هذا العمل، باختصار، “الثورة” هي التي تبدو كأنها تنسج الإبداع، من أجل أن تتكرر من جديد.
الفانتازيا لها شواهد ومنعطفات كثيرة في النص الزاخم، منها تلك القدرة السحرية الخارقة التي يمتلكها الحاكم أمير أبو العساكر، إذ تمكنه من إلقاء أي شخص إلى الماضي، وهذا ما فعله مع “السر عسكر” ناظر الحربية نفسه، إذ ألقاه إلى الماضي، لشكه في أنه قد يكون متواطئًا مع الثوار، أو مدبرًا خفيًّا للثورة من وراء ظهره. كما استخدم الحاكم تلك القدرة العجيبة، فألقى كل من كانوا في الميدان إلى العام السابق. ولكي تنطلي الخديعة على الجميع: “أصدر الحاكم قرارًا بأن هذه السنة ليست 2011، بل 2010، والدنيا كلها مشت وراءه.. الإعلام والصحافة والأحزاب وكله”.
ومن تلك الشواهد والرموز كذلك، هذه البراميل التي تستخدمها جماعة “النصيحة والهدى” من أجل تخدير الشعب في أي وقت ولأية مدة، حتى ينتهوا من صراعاتهم أو اتفاقاتهم المشبوهة مع الحاكم، وقدرة مدير المحن والأزمات “مز” على أن يُخرج من أصابعه الثعابين، وتدخُّل الفنانة الراحلة سعاد حسني التي راحت تقبل الشباب المنفيين إلى الماضي واحدًا تلو الآخر، لتدب الحياة فيهم من جديد، وكذلك تحوّل آلاف الشباب الثوريين المنفيين إلى الوراء عامًا كاملًا إلى “قطط” تملأ الميادين، لتبدأ رحلة اليقظة ومحاولة استعادة الثورة بآليات مغايرة، لا تتكرر فيها أخطاء الماضي، وغيرها من التخييلات والإرهاصات بامتداد النص.
أما نبوءة السارد، فتتجلى بعد اختفاء الحاكم وزوجته مع اقتراب موعد 25 يناير في المرة الثانية (بعد عام من الثورة الأولى)، إذ تتكشف للشباب حقيقة تزييف الحاكم للتاريخ، ويصارحهم “السر عسكر” بتفاصيل كل ما جرى، في محاولة منه لكسب الرأي العام والسيطرة على الموقف بعد عزل الحاكم، وتحييد جماعة “النصيحة والهدى” بعدم ذكرهم بسوء، وهنا تأتي النهاية بأن أغلبية الشباب لم يصدقوا نوايا “السر عسكر”، ومن ثم انطلقت فتيات محلقات بأجنحتهن في الفضاء، وانتشر هاشتاج “#خرافة_أم_حقيقة_انزل. بناتنا تطرن الآن في سماء لاوند، فهل يجلس الرجال في البيوت؟ انزل. انزل. انزل”.
هذه النبوءة الختامية، ومن قبلها تلك النزعة الفانتازية، هما المساران الفنيان، اللذان أثريا خارطة الأحداث التاريخية المنقولة حرفيًّا على مدار النص، بانحرافات تفجيرية غير جاهزة، أنعشت مخيلة التلقي، بقدر ما بلورت فكرة قطبية مركزية لخصت كل شيء من جديد بمفردة “انزل”، باعتبارها لحن المستقبل، لا محالة.
هذا اللحن “انزل”، هو الصاعقة التي هرب الحاكم خوفًا من دنوّها، وهو في الوقت ذاته النغمة الخفية الطروب، التي ظلت تداعب صدر الراوي العليم، منذ أولى كلمات الرواية الافتتاحية، حتى آخر حروفها. على أن الرواية اقترحت موعدًا لانفجار اللحن (25/1/2012)، فيما، في الحقيقة، لا يزال شخوص الرواية مرتقبين المشهد بصمتٍ بين دفتي كتاب.
(*) صدرت عن الدار المصرية اللبنانية في قرابة أربعمئة صفحة
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.
مقال جريدة القدس العربي
جريدة القدس العربي
السنة الثامنة والعشرون العدد 8714 الثلاثاء 24 كانون الثاني (يناير) 2017 - 26 ربيع الثاني 1438 هـ
شهلا العجيلي - أديبة سورية
«قطط العام الفائت» لإبراهيم عبد المجيد : انتقام الأنبياء المخذولين
هذا نصّ يضع ناقدة مثلي، مولعة بالواقعيّة، أمام تحدّ جماليّ ليس سهلاً، يجعلني أتساءل عن الشرط الذي مكّن ذلك الجموح الخياليّ من الوجود، إذ أعدّ رواية «قطط العام الفائت» من تلك النصوص التحريضيّة التي ترجّ تاريخ الرواية العربيّة أكثر مما هي رسالة في الممارسة الروائيّة أو التقنيّات، تماماً مثلما كان (دريدا) ينظر إلى شرط ظهور (مسرح القسوة).
اعتدت على أن أواجه في نصوص إبراهيم عبد المجيد تلك الضربة من (العجيب) التي لا تعدمها حياة الفرد، مثل الإمساك بخيط ميتافيزيقيّ وسحبه بلطف إلى العالم الفيزيقيّ، وأحدّد هنا مصطلح «العجيب»، بذلك الذي لا تألفه قوانين الواقع وفيه بهجة، أو أنّه ينتهي نهاية سعيدة، مثلما حدث مع مجد الدين وهالته النورانيّة في «لا أحد ينام في الإسكندريّة»، أو كما حدث مع البنات اللواتي سبحن في النيل مع عشّاقهنّ في مطلع «أداجيو» ثمّ اختفين، أو ما حدث مع صيّاد اليمام وأمّه… لكن ذلك بقي مؤطّراً بإطار واقعيّ واضح.
ستحدث في العالم موجات تغيير حادّة، كما يرى المستقبليّون، ونتحدث هنا عن تغييرات متداخلة اقتصادية واجتماعية وثقافيّة ونفسيّة، تؤثّر في منظومات القيم، وفي الحياة اليومية بالوسائل والطرق كلّها، لتصير أسلوب حياة جديد، وناشئ وآخذ في الانتشار على المستوى العالميّ، وقد تخرج إلى عمليّات تغيير ضخمة، وأرى أنّ «قطط العام الفائت» واحدة من إشارات التغيير الأدبيّ الذي لا يحدث من غير صراع بين أشكال أقدم وأحدث، وهذا الصراع لا ينطوي على عنف بالضرورة، فقد يكون خلاقاً ومفيداً موازياً لما يسمّى بـ (ديزنة العالم) من (ديزني) أو (هولدته) من (هوليوود)، ولن ننسى أنّ (غريغور سانسا) استيقظ ذات صباح فوجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة ضخمة، وبهذا التحوّل جرّ كافكا العالم الأدبيّ إلى ما سمّي بتيّار العبث.
لعل هذا الشكل من الكتابة الروائيّة، التي تقود إلى السؤال عن رواية المستقبل هو احتجاج صارخ يوازي فداحة القضايا الأخلاقيّة والسياسيّة التي يثيرها علم الأحياء الحديث، والتي قيل منذ مطلع القرن الواحد والعشرين «إنّها ستذهل العقل، وإنّ بحوثاً في علم الجينات، وفي الاستراتيجيّة السياسيّة وفي الاقتصاد، ستحدّد من الذي يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت؟ ومن هو الإنسان؟ ومن الذي سيتحكّم بالبحوث في هذه المجالات؟»، إنّ هذا ما نواجهه اليوم، وسيدلي الأدب بدوره دلوه في هذا الخضمّ، لذا سنتقرّى في نصّ إبراهيم عبد المجيد تحطيم الحاجز بين الأجيال، وبين العام والخاص، وبين الفيزيقي والميتافيزيقي، وبين الرغبة الإنسانيّة والإمكانية البشريّة، ليكون نصّ «قطط العام الفائت» تعبيراً عن الاغتراب، والرفض الإشكاليّ للقيمة الأخلاقيّة الجماليّة التي أنتجها خذلان أولئك الأنبياء الصغار الذين تجمّعوا يوماً ما في ميدان التحرير.
يدخل عبد المجيد بـ«قطط العام الفائت» عالم الفانتازيا بملء المصطلح الذي يقوم على تخييل يضع المتلقّي في حالة من التردّد والشكّ في كونه يعيش بين واقعين، يسير الأوّل بقوانين متعارف عليها، ويسير الآخر بقوانين جديدة مخالفة للطبيعيّ، ولكن الشرط الأساسي الذي يمسك الفانتازيا، حسب (إبتر) هو الرعب، وعدم التمييز بين الواقعين، تماماً كما لا ندرك إن كنّا نعيش في كابوس أو حقيقة في بضع لحظات صعبة، كالفقد أو التعذيب في المعتقلات، أو خوض تجربة قاسية: امتحان أو مرض أو ضياع.
كتبت في عام 1999 رسالتي في دبلوم الدراسات العليا عن أدب الفانتازيا وعلاقته بالعسف السياسيّ، ولم أجد نصّاً روائيّاُ عربيّاً يتمثّل الفانتازيا السياسيّة بتلك الوفرة الشائقة التي تشفي الغليل، كما وجدتها بعد سبع عشرة سنة في هذا النصّ، ولعلّ سرديّات التراث العربيّ مثل «رسالة الغفران» للمعرّي، و«التوابع والزوابع» لابن شهيد الأندلسيّ قاربت المفهوم ، لكنّها نحت منحى الانتقامات الأدبيّة من التصنيفات الثقافيّة التي تلعب فيها السياسة لعبتها. وإذا خرجنا من باب التراث إلى باب ما بعد الحداثة سنجد قطط إبراهيم عبد المجيد هناك حيث سنؤمن بقوانين لم نكن نؤمن بها من قبل، تدعونا لتحرير الخيال، ليس على طريقة الرومانتيكيين، بل على طريقة جورج لوكاس مبتكر سلسلة أفلام حرب النجوم ومخرجها، وإن كان مبدأ التخييل واحداً من عند أرسطو، أو حازم القرطاجنيّ، أو كيتس، ووردزوورث، حتّى عالم ما بعد الحداثة فهو، أي التخييل، عملية إيهام موجّهة تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة، باستعمال الصورة، سواء أكانت لغويّة أم بصريّة.
الحسّ التاريخيّ
إنّ ما يحوّلنا من واقع إلى آخر، ليس عصا سحريّة، أو طاقيّة إخفاء، بل هزّة الثبات التاريخي للديكتاتورين الراسخين، التي تنقلهم وتنقلنا معهم إلى عالم الفانتازيا، فلا أحد منّا سيصدق ما حدث في ذلك اليوم، وكأنه يوم الزلزلة، أو يوم استيقاظ (غريغور سانسا)، هو ذلك اليوم الذي يشير إليه المشهد الافتتاحيّ لـ«قطط العام الفائت»: «ابتسم الحاكم في دهشة وهو يرى أن أصابعه تمتد إلى الأمام. راح ينظر إليها وهو يقف في صالة قصره وقد اتسعت عيناه. قال لنفسه إنه خيال، أصابعي في مكانها. لكنه وجدها تمتد وتطول وتنزل إلى الأرض. راحت تمشي أمامه إلى كل أرجاء الصالة، وتصعد المقاعد التاريخية التي تركها الملوك القدامى للسلطة الجديدة التي انقلبت عليهم منذ عشرات السنين. رآها تتفرق على الجدران الأربعة البعيدة، تمشي فوق لوحات الفنانين الكبار من أوروبا التي لم تبقَ منها إلا صور مقلدة. لقد قررت زوجته ألا تترك صوراً حقيقية خلفهم إذا انقلب عليهم أحد من الجيش كما انقلب زوجها على الحاكم قبله، أو إذا ثار عليهم الشعب».
تمّ الاعتراف بهذا المعراج المتعلّق بتحوّل سياسيّ خطير، من قبلنا نحن المتلقّين، ومن قبل سكّان عالم (لاوند) حيث فضاء الحدث الرئيسي، وهذا التحوّل لا يعزى إلا إلى نوع من المسّ، الذي اعتدنا أن نسم به أيّ ظاهرة غير مألوفة، ولا مرغوبة في الوقت ذاته: «أجلس على مقعد آخر، قد يكون هذا المقعد ممسوساً، لا أحد يدري ما الذي يحدث في البلاد».
يعيدنا ذلك إلى الموروث الدينيّ أيضاً، فالإنكار واتهام الأنبياء بالسحر والجنون تهمة شرقيّة، بل مصريّة حين تحيل إلى أفاعي سحرة فرعون وعصا موسى، ممّا يضخّ في النصّ دم المحليّة المحتفى بها، مشيرة إلى الحاسّة التاريخيّة التي يقول بها إليوت: إنّها لا تتضمن إدراك الماضي ومعه الحاضر فحسب، وهي لا تعني أن تكتب وجيلك في دمك، بل أن تجعل من الآداب من أيام هومير مجتمعة كياناً معاصراً.
التخييل، والحسّ الواقعيّ
نجد مع هذه الحاسة التاريخيّة الإصرار على التخييل، فوداع الخيال هو استسلام كامل للعدو الذي هو الواقع عند اليائسين من أمثال رومان غاري. إنّ الاغتراب الذي تصنعه الفانتازيا حينما تنقلنا إلى (لاوند)، تبدده الشخصيّة المألوفة المحبّبة، إذ تحضر سعاد حسني بقصّتها الوقائعيّة، تأتي من الشام، لتحوّل معايير الذوق العامّ من الجمال النادر المهيب إلى الحلاوة التي تمتلكها الفتاة التي تسكن في الشقّة المجاورة، ولنجد منها نسخاً كثيرة من الصبايا المصريّات اللواتي سيتعرّضن للاعتقال، ذلك أنّها تنقلنا هذه المرّة إلى (العجيب) ليحمينا من قسوة الفانتازيّ، إذ تمنح سعاد حسني قبلة الحياة للثوار في الميدان الذي لا نستطيع إلا أن نحيله إلى ميدان التحرير، وبذلك نعود إلى حكايات العجيب المتصرّف بها، إلى قبلة الحياة، والأميرة النائمة، ورابنزيل… وهكذا كلّما أوغلنا في الاغتراب ستحمينا الشخصيّات الوقائعيّة المحاكية، لذا نجد الدكتور العالمي، والمذيعة منى البرادعي، وسعاد حسني، والشيخ شمعدان الذي يحيل إلى حزب النور، وجماعة النصيحة والهدي، فيعادل الروائيّ الوسط الحمضيّ بالقلويّ على طريقة الكيميائيين، وبذلك لا يفقد الحسّ الواقعيّ المؤسس على الحقيقة والذي هو سبب وجود الفنّ الروائيّ خاصّة، إذ يعده زولا ضرورة مطلقة ليصور المرء الحياة، وما الإنكار الذي تشير إليه العتبة النصيّة الإنشائيّة التي تقول: «وأيّ تشابه مع الواقع غير مقصود» سوى عبارة إخباريّة تحثّ على التصديق.
لعلّ أيّ خروج على الواقع هو من أجل خدمته في النهاية، ذلك أنّ الفنّان في حالة تنافس أبديّة مع سيرورة الحياة، يبحث فيها عن المحتمل الذي لم يتجلّ على مسرحها بعد، وإذا ما فكّرنا بحوادث العالم العربيّ منذ 2010 سنجد أنّها تضع العقل في الكفّ، فلا بدّ إذن من حيلة، من ضرب آخر من الكتابة يثبت إخلاص الأدب للمبالغة، وأنّه فوق الواقع أو تحته، لكنّه ليس الواقع. هكذا تأتي فانتازيا «قطط العام الفائت»، مزيجاً من حيل فرعون وسحرته، وتحويله الثوّار إلى قطط، ورميهم في زمن سابق، أمام قدرات أنبياء صغار هم الثوّار، مؤيّدين بمعارف مضادّة، وشخصيّات محبّبة قادمة من عالم الطفولة الحرّة تمثّلها شقاوة سعاد حسني المحمولة على «بيجاسوس» الحصان الأسطوريّ المجنّح، ويساعدها كينغ كونغ، ومعهم أشعار أحمد فؤاد نجم، وعلاقات حبّ، وتاريخ عائليّ من النضال اليساريّ.
أثبتت هذه الأدوات وغيرها كثير، شجاعة إبراهيم عبد المجيد في هذا النصّ في مضارعة آفاق الشباب الذين نشأوا في عالم الألعاب الإلكترونية، ويستطيعون بناء فضاء وتقويضه بكبسة زرّ، لكنّه بسبب الخبرة والثقافة لم يقم قطيعة مع الموروث العربيّ، إذ تواصل مع حكايات الغيلان وندّاهات البحار والأنهار، ومع موروث المسرح الإغريقيّ حيث يترفّق سوفوكليس بمصير إلكترا. هذه التناصّات المقصودة أو غير المقصودة تلخّص هدف الفانتازيا الذي قد يكون مضارعة الواقع المجنون، أو التجريب والتفوّق على الذات، أو الهروب من اليوميّ، أو الإتيان بضروب من اللعب، وفي النهاية عودة إلى الواقع بعد أن أعلن الروائيّ أنّه فاض بنا، وأنّنا سنخرج من جلده ومن ثيابه.
اغتراب جماليّ
يشير النصّ إلى البشريّة التي تكبّل السلطة، وإلى الاضطهادات التراتبيّة داخل الأنظمة ذاتها، التي تسيّرها المصلحة، وإلى انكسار الأنثويّ في زوجات القادة والرموز السياسيّة. لكنّ البراعة التي تصنعها الفانتازيا هنا تكمن في منح مساحة لخروج كبير على قوانين علم الجمال الأرسطيّ الذي نتعرّف عبر نماذجه عادة إلى أنفسنا، حيث البطوليّ ينسجم مع الجليل، أو مع التراجيديّ، وينفر من الكوميديّ، لكن يتحوّل هنا رمز السلطة الذين ظلّ جليلاً لعقود إلى كوميديّ، عبر الأفكار البشرية التي تنتقم من الشرير، والــتي نعزي أنفســــنا بها إذ نجعـــلها عقابا عادلاً، فنســمع حديثاً تهكّميّاً عن الاشتهاء، وعن الجنس وعنّة الحاكم، وغلمة زوجته المحرومة، فالحاكم يهرب من مقاربة زوجته المسيطرة، وينفرد بصور سعاد حسني العارية، لكنّ الزوجة تلاحقه، فيتعلل بخلل في البروستات: «ولم تعرف أنهم هناك ضحكوا عليه ووضعوا له بروستات من ورق، يذوب مع أي سائل يمرّ به، وينزل في النهاية مع البول. إنه كثيراً ما يبكي في الليل على البروستات الضائعة، ويقول: كانت حلوة زيّ الفلّ».
إنّ انحدار الجليل إلى الكوميديّ يصنعه مشهد دخول وزير الأمن والأمان (مم) إلى المقبرة ليستنطق سعاد حسني في قبرها، لاسيّما إذا ما قارنّاه بمشهد دخول أوديسيوس عالم الموتى، أو بحوار هاملت مع شبح والده، إنّها مفارقة ممتازة تملأ لدى الناقد فراغاً جماليّاً، فيها براعة في نقل التراجيدي والجليل إلى الكوميدي: «لقد اكتشف قبل زيارته أنّه لم يعد يحفظ من القرآن غير الفاتحة وكثيراً ما ينهيها بسرعة، فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. آمين»…هل معقول أنّ الفتاة التي أعادت الشباب من العام السابق هي أنتِ؟…أنا الذي لم يكن لي أي عـــــلاقة بك وأنت تنفــذين أوامر المخابرات في بلدك…ولا كان لي دخل بموتك منتحرة أو بجريمة ارتكبت في حقك من مخابرات بلدك. لقد ضعفت يا سعاد، أنا قاهر الشعب القويّ. ضعفت جداً وبدأت أصدق أنك تعودين للانتقام».
تتفاعل «قطط العام الفائت» الرواية التي صدرت مؤخّراً عن الدار المصريّة اللبنانيّة 2017، مع عوالم فيسبوك، وتغريدات تويتر، والهواتف المحمولة، وإعادة ضبط الزمن، وتتمثّل فضائل الإبداع في تفعيل الحسّ التاريخيّ، والحسّ الواقعيّ، والحسّ التخييليّ، وقد تفسّر إحدى التغريدات العنوان: «نتحول إلى قطط لنهرب من سجونكم. نتحول إلى قطط لندخل بيوتكم ونأكلكم».
– عدد المقال في جريدة القدس العربي بالـ pdf
صحيفة القدس العربي هي صحيفة لندنية تأسست عام 1989.
مقال جريدة الحياة
الخميس، ١٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧
جريدة الحياة
يسري عبدالله
إبراهيم عبدالمجيد الروائي بين فنتازيا الثورة وعبث الواقع
في روايته «قطط العام الفائت» (الدار المصرية اللبنانية)، يضع الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد قدماً في المتخيل، وأخرى في الواقع. يخلق جدلاً رهيفاً بين الفنتازيا والحقيقة، يظهر منذ المفتتح الدرامي للرواية وحتى الختام. ثمة افتتاحية دالة تبدأ بها الرواية، حيث تحيل على فضاء تخييلي، يختلط فيه الحلم بالواقع، تبدو فيها «لاوند»؛ المدينة المتخيلة؛ فضاءً فنتازياً بامتياز، يتكئ على بلد تبدو الإحالات عليه رمزية، اسمه «مصرايم»، قامت فيه ثورة في عام 2011، ترتب عليها خلع الحاكم. تبدو «لاوند» تنويعة على «مصرايم»، ودفعاً بالدلالة السردية إلى حيز البناء الأليغوري، الذي يغاير الأبنية الرمزية التقليدية، حيث ثمة توازٍ ما بين الخيال والواقع هنا، ما بين ثورة لاوند/ مصرايم، والثورة المصرية في كانون ثاني (يناير) 2011.
يبدو التصدير الدال للنص كشفاً عن هذا المعنى: «في بلد يسمى لاوند قامت ثورة قي اليوم نفسه الذي حدثت فيه الثورة في مصرايم. هنا ما جرى في لاوند، وأي تشابه مع الواقع غير مقصود» (صـ 6). ينحاز إبراهيم عبدالمجيد إلى الفانتازيا منذ الاستهلال الروائي، فيخلق لنصه منطقه الجمالي الخاص؛ «ابتسم الحاكم في دهشة وهو يرى أن أصابعه تمتد إلى الأمام، راح ينظر إليها وهو يقف في صالة قصره، وقد اتسعت عيناه. قال لنفسه إنه خيال، أصابعي في مكانها. لكنه وجدها تمتد وتطول وتنزل إلى الأرض. راحت تمشي أمامه إلى كل أرجاء الصالة، وتصعد المقاعد التاريخية التي تركها الملوك القدامى للسلطة الجديدة التي انقلبت عليهم منذ عشرات السنين» (ص - 7).
ولا يكتفي الكاتب بموازاة الواقع رمزياً عبر هذا البناء الأليغوري، ولكنه يؤسطره ايضاً. وتبدو هذه الموازاة بدءاً من أسماء الشخوص (اللواء سامح أبوعامود مسؤول الإعلام في وزارة الأمن والأمان- الحاكم أمير باشا أبوالعساكر- السر عسكر- جماعة النصيحة والهدى- الشيخ شمعدان- هديل/ سعاد حسني). وتبدو أسطرة الواقع عبر تجمد الثوار في أماكنهم في الميدان، ثم مرور هديل/ سعاد حسني لتلثم شفاه كل شاب وفتاة، فتدب الحياة في المجموع، ثم تصعد من جديد عبر أسطورة الحصان المجنح «أبيغاسوس». وتحمل الإحالة على سعاد حسني طابعاً رمزياً، فتداعب الوجدان العام الذي ألِف بطلته الجميلة، وهي تنشر الفن والمحبة والغناء. ثم يتحول الحاكم نفسه إلى فكرة طوطمية قديمة وفاشية.
يوظف الكاتب في مقاطعه السردية آليات الفنون البصرية المختلفة، وتحديداً فن السينما، وتقنيات كتابة السيناريو، حيث يمكننا قراءة مقاطع سردية كاملة مع إمكان تخيلها بصرياً تخيلاً ضافياً: «مدّ لها الحصان جناحه فصعدت عليه واستوت على ظهره، وارتفع بها، وإذا بسحابة بيضاء تهبط مسرعة إليهما تلفهما وترتفع أكثر، بينما صيحات الدهشة وعدم التصديق لما يحدث وإذا بالسحابة بعد أن ترتفع إلى مسافات بعيدة والعيون معلقة بها حتى كادت أن تختفي تظهر منها آلاف الطيور البيضاء مقبلة بسرعة ناحية الأرض فأصاب الكثير الهلع كما أصاب الكثير الدهشة». (صـ 53)
تتعدد مستويات الأداء اللغوي في السرد، فمن اللغة الكلاسية السامقة والرهيفة التي يستخدمها السارد الرئيس في مقاطعه ذات الطابع الإخباري/ الوصفي: «شمس حانية تشرق على بلاد اللاوند. شمس تعلن أن هذه البلاد جميلة وسط الدنيا. ترفع الأنظار إلى بهاء الفضاء على البحر وحول النهر وفي الشوارع البعيدة والأزقة في العشوائيات» (صـ 358)، مروراً باللغة المحايدة، ثم اللغة التي تقترب من فصحى المثقفين، وصولاً إلى العامية المتناثرة في الحوارات وفي بعض مناطق السرد.
تمثل الحوارات بين الشخوص جزءاً مركزياً من بنية الرواية، بحيث تضيف إلى الرؤية السردية وتتممها. فالحوارات بين السلطة في لاوند وأركانها تكشف عن ذهنية القمع والاستعلاء. إضافة إلى أن الحوارات الدائرة بين ممثلي الثورة من الشباب (أحمد خشبة/ مصطفى/ نزار/ شهيرة/ نورهان/...») تبدو محملة بشحنات عاطفية وانفعالية، وكاشفة عن وعي الشخوص بحتمية الخلاص عبر الثورة. يعتمد البناء الأليغوري هنا أيضاً على تلك التقسيمات الدالة للواقع، وموازاتها رمزياً ودلالياً. ففي لاوند توجد جماعة «النصيحة والهدى»، ومرشدها الشيخ شمعدان، ويوجد «أمير باشا أبوالعساكر»... وفي إطار اللعبة الفنية التي يوجدها إبراهيم عبدالمجيد في نصه، نراه يمعن في إيهام المتلقين بتلك المباعدة الفنية بين النص والواقع، ويتدخل المؤلف الضمني للتعليق على الحدث الروائي، مستخدماً آلية التعليق السردي: «والآن؛ بعد أربع سنوات وأنا أكتب هذه الرواية استطعت الرجوع إلى تعليقاتهم وأخذت بعضها هنا،...» (صـ 97).
وإذا كان المتكلم عيّنة أيديولوجية بتوصيف ميخائيل باختين، فإنّ لغات الشخوص في النص تبدو دالة على وعي أصحابها. ولعلّ نموذج أحمد خشبة يعد تعبيراً دقيقاً عن هذا التصور.
تنهض رواية «قطط العام الفائت» على آلية الإحالة أيضاً، عبر مسارين؛ أحدهما عام، حيث الإشارة إلى السياق السياسي والثقافي الذي يشكل الزمن المرجع للرواية، ويبدو واضحاً عبر عشرات الجمل والحوارات السردية داخل النص. والثاني يتأسس على دلالة خارج الواقع، ويظهر مثلاً عند الإشارة إلى الحصان المجنَّح، الذي يحيل على أسطورة أبيغاسوس، في الميثولوجيا الأغريقية، الذي ما إن ولد حتى طار.
يختار إبراهيم عبدالمجيد إذاً لحظته الروائية ببراعة، ويتخذ من القطط - الحاضرة في الثقافة الفرعونية والراسخة في الوجدان الشعبي المصري بوصفها بسبعة أرواح - معادلاً موضوعياً للشباب الثائر، الذي يتحول إلى قطط، بعد أن يعيد الحاكم عقارب الزمن سنة إلى الوراء، ويخوض دراما الثورة مع الآلة الجهنمية للقمع، وكأن الثورة لن تموت، قوتُها في نبلها.
هكذا يقدم إبراهيم عبدالمجيد نصاً مسكوناً بالمتعة الجمالية، والحيل الفنية، بدءاً من عنوانه المخاتل، مروراً بعلاقات شخوصه، ووصولاً إلى بنيته الفنية المازجة بين السياسي والجمالي، الواقعي والفنتازي في سردية متناغمة.
“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.
مقال جريدة العرب
جريدة العرب
نُشر في 09-01-2017، العدد : 10507، ص(15)
الصفحة : ثقافة
العرب - القاهرة
رواية تلوذ بالماضي لتسخر من الحاضر
الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد يؤكد أن السخرية التي بدت واضحة في روايته، إنما هي ممن وأدوا ثورة يناير 2011 وتاجروا بها.
يسترجع الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد في أحدث رواياته “قطط العام الفائت” أحداثا سابقة من الماضي، ولكن في قالب من الفانتازيا غير معهود في أعماله السابقة.
تدور أحداث الرواية، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، في عام 2011 في بلد اسمه “لاوند”، يقول المؤلف في تقديم الرواية إن ثورة قامت فيه في اليوم نفسه الذي حدثت فيه الثورة في “مصرايم” المجاورة.
تبدأ شخصيات الرواية في الظهور تباعا وهي الحاكم أمير أبوالعساكر ومساعدوه مدير المحن والأزمات ووزير الأمن والأمان والسر عسكر، ناظر الحربية، وهي شخصيات لن يعاني القارئ كثيرا في إسقاطها على الواقع في مصر، وتحديد هويتها الحقيقية.
تبدأ الفانتازيا بكشف المؤلف عن القدرات الخارقة لشخصياته، فمدير المحن والأزمات يستطيع تحويل ذراعيه إلى ثعبانين يعذب بهما المعتقلين والمعارضين، أما حاكم لاوند فيلقي بخصومه عبر الزمن ويعيدهم إلى الماضي.
تنجح الثورة في لاوند بعد أن فرت قوات الأمن أمام المتظاهرين الشبان الذين اعتصموا في “الميدان الكبير” بالعاصمة لاوندة، لكن الحاكم بدلا من أن يهرب أو يتخلى عن السلطة يلقي بجميع المتظاهرين إلى العام السابق، ويقنع الشعب بأن العام هو 2010 وليس 2011.
ولاستكمال مقاربة الرواية مع الواقع، يقدم المؤلف جماعة “النصيحة والهدى” التي تستغل الدين في السياسة للوصول إلى الحاكم، وتتعاون مع الحاكم في الخفاء بينما تعاديه في العلن.
تطول الأحداث وتتشعب ويستمر المؤلف في طرح شخصيات جديدة من الشبان والفتيات الذين يقودون الثورة ضد حاكم لاوند من خلال الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ويدركون ما فعله بهم الحاكم لكنهم يصرون على تكرار تجربة الثورة.
في المقابل لا يتخذ الحاكم أي إجراءات لتغيير الأوضاع أو تحسين صورته أو تطبيق إصلاحات، بل يستقدم المزيد من الأسلحة الفتاكة الحديثة لمواجهة الشبان، وكأن المؤلف أراد أن يبلور فكرة أنه مهما عاد الزمن سيكرر الحكام أخطاءهم، وسيبقى الشباب على حماسته ورغبته في التغيير.
ولأن تزييف الزمن أو خداع الناس لا يمكن أن يستمرّا، كان لا بد من حلول شهر يناير مرة أخرى وقيام الثورة من جديد.
لجوء المؤلف إلى الفانتازيا في إعادة طرح ما مر على مصر بعد ست سنوات من ثورتها، ربما ينم عن أشياء كثيرة قد يكون أبرزها “غصة” لا تزال في حلقه مما آل إليه حال فئة الشباب التي أطلقت انتفاضة 25 يناير، وكانت ملء السمع والبصر في الفضائيات ووسائل الإعلام آنذاك ثم توارت عن الأعين ولم يعد لها أي دور أو نشاط سياسي.
كذلك استعان عبدالمجيد بشخصية محبوبة غابت عن الدنيا مثل الممثلة سعاد حسني في روايته، حيث استغل طيفها في إلهاب حماس الشبان، وبث الأمل فيهم، وفي الوقت نفسه إلهاء الحاكم ومعاونيه وإصابتهم بالتخبط طوال الوقت، وهذا قد يكون من قبيل التأكيد على أهمية الفن والثقافة في حياتنا واسترجاع لمعان أحلام تدهسها أحداث الواقع.
رواية إبراهيم عبدالمجيد ليست توثيقا لما جرى في مصر في 25 يناير 2011 أو في أي دولة عربية أخرى، لكنها إطلالة من نافذة المستقبل على ما كان وما جرى في الماضي بعين ساخرة لا تخلو من النقد المستتر في قالب فانتازي.
ويرى الناقد يسري عبدالله في تقديمه للرواية أثناء حفل التوقيع الذي نظمته الدار المصرية اللبنانية للرواية مؤخرا، أن عبدالمجيد قدم رمزية ليست كالرمزية المعروفة في السرد العربي، إذ طرح بناءً رمزيّا متوازيّا، حيث أنشأ توازيا ما بين الواقع والفانتازي، كما عمل على أسطرة الواقع، من خلال العديد من الدلالات، مثل تجمد الثوار في الميدان، وأسماء الشخصيات المرتبطة بالسلطة.
وقال عبدالله، يضفّر إبراهيم عبدالمجيد في هذه الرواية مقاطعه السردية بآليات الفنون البصرية المختلفة، وهذه واحدة من أهم التقنيات داخل هذه الرواية، فنحن باختصار أمام نص منفتح على فنون بصرية وتحديدًا على فن السينما، وهناك استفادة كبيرة من آليات فن كتابة السيناريو إلى الحد الذي يجعلك حينما تقرأ مقطعًا سرديّا ما تراه كصورة سينمائية أمام القارئ.
كما أكد إبراهيم عبدالمجيد بدوره في تقديمه لروايته الجديدة أن السخرية التي بدت واضحة في روايته، إنما هي ممن وأدوا ثورة يناير 2011 وتاجروا بها، وليست السخرية من الثورة نفسها كما ظن البعض.
العرب : أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
صحيفة العرب© جميع الحقوق محفوظة
يسمح بالاقتباس شريطة الاشارة الى المصدر
مقال جريدة رأي اليوم
الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2017
جريدة رأي اليوم الإلكترونية
متابعات- راي اليوم
"قطط العام الفائت" تروي ثورة 25 يناير بقالب فانتازي
أصدر الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد أحدث رواياته “قطط العام الفائت” التي يسترجع فيها أحداثا سابقة من ثورة 25 يناير بسخرية ممزوجة بالنقد المستتر وبقالب من الفانتازيا غير معهودة في أعماله السابقة.
جاءت الرواية في 386 صفحة من القطع المتوسط عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وهي الرواية الـ17 في سلسلة كتابات المؤلف السكندري التي تضم 7 مجموعات قصصية إضافة لكتب أخرى متنوعة.
وتدور أحداث “قطط العام الفائت” في العام 2011 في بلد اسمه “لاوند” قامت فيه ثورة في نفس اليوم الذي حدثت فيه الثورة في “مصرايم” المجاورة، كما يذكر الكاتب في المقدمة.
الحاكم “أمير أبو العساكر” ومساعدوه “مدير المحن والأزمات” و”وزير الأمن والأمان” و”السر عسكر” ناظر الحربية هم شخصيات الرواية التي لن يعاني القارئ في إسقاطهم على الواقع في مصر وتحديد هويتهم الحقيقية.
وتبدأ الفانتازيا بكشف القدرات الخارقة للشخصيات مثل مدير المحن والأزمات الذي يستطيع تحويل ذراعيه إلى ثعبانين يعذب بهما المعتقلين والمعارضين .
ولاستكمال مقاربة الرواية مع الواقع يقدم المؤلف جماعة “النصيحة والهدى” التي تستغل الدين في السياسة للوصول إلى الحاكم وتتعاون مع الحاكم في الخفاء بينما تعاديه في العلن.
تطول الأحداث وتتشعب ويطرح المؤلف مزيدًا من الشخصيات من الشباب الذين يقودون الثورة ضد الحاكم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي في حين لايتخذ الحاكم أي إجراءات لتغيير الأوضاع بل يستقدم المزيد من الأسلحة الفتاكة الحديثة لمواجهة الثوار، وكأن المؤلف أراد أن يبلور فكرة أنه مهما عاد الزمن سيكرر الحكام أخطاءهم وسيبقى الشباب على حماسته ورغبته في التغيير.
لجوء المؤلف للفانتازيا في إعادة طرح الثورة ربما ينم عن أشياء كثيرة قد يكون أبرزها “غصة” لا تزال في حلقه مما آل إليه حال فئة الشباب التي أطلقت انتفاضة 25 يناير وكانت ملء السمع والبصر في الفضائيات ووسائل الإعلام آنذاك ثم توارت عن الأعين ولم يعد لها أي دور أو نشاط سياسي.
كذلك استعانته بشخصية محبوبة غابت عن الدنيا مثل الممثلة سعاد حسني التي استغل طيفها في إلهاب حماس الشبان وبث الأمل فيهم وفي الوقت نفسه إلهاء الحاكم ومعاونيه قد يكون من قبيل التأكيد على أهمية الفن والثقافة في حياتنا واسترجاعا لمعانٍ حلوة تغيب في أحداث الواقع.
عن موقع جريدة رأي اليوم الإلكترونية
من تقديم مؤسس ورئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية :
سياستنا في هذه الصحيفة“رأي اليوم”، ان نكون مستقلين في زمن الاستقطابات الصحافية والاعلامية الصاخب، واول عناوين هذا الاستقلال هو تقليص المصاريف والنفقات، والتمسك بالمهنية العالية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع بقدر الامكان، والانحياز الى القارئ فقط واملاءاته، فنحن في منطقة ملتهبة، تخرج من حرب لتقع في اخرى، في ظل خطف لثورات الامل في التغيير الديمقراطي من قبل ثورات مضادة اعادت عقارب الساعة الى الوراء للأسف.
اخترنا اسم الصحيفة الذي يركز على “الرأي” ليس “تقليلا” من اهمية الخبر، وانما تعزيز له، ففي ظل الاحداث المتسارعة، وتصاعد عمليات التضليل والخداع من قبل مؤسسات عربية وعالمية جبارة تجسد قوى وامبراطوريات اعلامية كبرى، تبرخ على ميزانيات بمليارات الدولارات، رأينا ان هذه المرحلة تتطلب تركيزا اكبر على الرأي المستقل والتحليل المتعمق، وتسمية الامور باسمائها دون خوف.
في حوار مع جريدة الحياة
الثلاثاء، ٧ مارس/ آذار ٢٠١٧
جريدة الحياة
إيهاب محمود الحضري
إبراهيم عبدالمجيد: أصبح لدينا نقاد وشعراء يكتبون الرواية
إبراهيم عبدالمجيد، يحافظ على وجوده، عبر روايات بموضوعات مختلفة، تتفق غالبيتها في دوران أحداثها داخل الإسكندرية، التي حظيت بثلاثية روائية. يؤرخ للمدينة راصداً أحوالها وتغيرات طرأت عليها بداية من الحرب العالمية الأولى وانتهاءً بثورة كانون الثاني (يناير) 2011، بدأت بـ «لا أحد ينام في الإسكندرية»، ثم «طيور العنبر»، وأخيراً «الإسكندرية في غيمة». وأخيراً احتفل إبراهيم عبدالمجيد بحدثين، سبعينيته، وصدور أحدث رواياته «قطط العام الفائت»، عن الدار المصرية - اللبنانية.
«في بلد يسمى لاوند قامت ثورة في اليوم نفسه الذي حدثت فيه الثورة في مصرايم. هنا ما جرى في لاوند وأي تشابه مع الواقع غير مقصود». هكذا، تبدأ الرواية التي تسرد أحداث الثورة المصرية، في إطار فانتازي، يرمز إلى الثوار بالقطط، ويسمي ميدان التحرير، الميدان الكبير، وجماعة «الإخوان المسلمين»، جماعة «النصيحة والهدى»، ويستحضر سعاد حسني لتعطي طاقات إيجابية للثوار.
هنا حوار معه:
> نبدأ بالعنوان؛ «قطط العام الفائت»... لماذا آثرت استخدام لفظة الفائت على الماضي، أو السابق، مثلاً؟
– في الثقافة الشعبية، تدل كلمة «الفائت» على أن ما ذهب لن يعود مرة أخرى، بخلاف كلمة «الماضي» التي يمكن أن تحضر في وقتنا هذا عبر ذكريات تطل بوجهها على ما يحدث الساعة. في الرواية حدث العكس، عادت الثورة من جديد بعد ما ظنَّ الحاكم أنها ذهبت من دون رجعة. كلمة «الفائت» تعبر عن وعي الحاكم، الذي وصل إلى اليقين باستحالة عودة الثورة من جديد.
> لماذا رمزت إلى الثوار بالقطط تحديداً؟
– لا أملك إجابة. أثناء الكتابة تحدث أشياء من دون قصد منك. أؤمن بأن الرواية تكتب نفسها، فقط تكون عندي الفكرة بإطارها العام. كل ما قصدته هو أن أقول شيئاً جديداً، لم يحدث من قبل. مثلًا: لم أكن لأخطط من أجل ظهور الكائن الأسطوري «كينغ كونغ» في الميدان الكبير، ولكن وجدته يقفز على الورق ولمحت فكرة لطيفة تتأهب للدخول ضمن الرواية ففعلت. الآن، لدينا أكثر من رواية تحاكي رواية «1984» لجورج أورويل. هذه الروايات تستشرف المستقبل ويكون الكلام فيها حول القمع والاستبداد وديكتاتورية الحاكم، ويكون هذا الحديث متوقعاً. لذلك، ذهبت إلى منطقة أخرى، عبر استعادة الماضي ومحاولة بعثه من جديد. ربما يكون اختيار القطط رمزاً للثوار، لأنها معروفة بوداعتها.
> ولماذا اخترت سعاد حسني نموذجاً لشحن الثوار بطاقات إيجابية؟
– لا أعرف. ربما لأني أحبها، مثل كثيرين يعشقون براءتها الممزوجة بسحر عينيها.
> هل يمكن تصنيف هذا العمل بأنه رواية رمزية؟
– قد يعتبر رواية رمزية، أو عالماً موازياً. أكثر ما أرهقني هو محاولة أن أجعل القارئ لا يفرق بين الواقع والخيال، فيقرأ العالمين كأنهما من نسيج واحد. كنت دقيقاً للغاية أثناء المراجعة، بحيث أبتعد، قدر استطاعتي، عن المبالغة في الغرائبية كي تصبح المواقف عادية.
> ألا ترى أنك استخدمت هاشتاغ ( #سيبوا-القطط-يا-عرر) ببعض المبالغة؟
– لا أعتقد ذلك. أريد أن أخبرك أنني حذفت عدداً كبيراً من التعابير الاحتجاجية، وما تبقى كان في صلب الموضوع ولخدمة الفن في الرواية، كما أننا نتحدث عن ثورة يقودها شباب، وهو مناسب لتفكيرهم جداً.
> تظهر الموسيقى كثيراً في خلفية رواياتك، وفي القلب من بعضها، إلى الدرجة التي دفعتك إلى تأليف رواية تحمل اسم لحن «أداجيو»... ما علاقتك بالموسيقى؟
– علاقتي بالموسيقى عظيمة جداً. في طفولتي كنت أستمع إلى الراديو، وذات مساء، وبينما كان أنيس منصور يجلس على مقعد الضيف، قال أنه يحب الاستماع إلى البرنامج الموسيقي لما يبثه من موسيقى كلاسيكية رائقة جداً. بحثت عن البرنامج الموسيقي حتى وجدتُه، وإلى الآن لا أستمع إلا إلى هذا البرنامج. أذكر أن محطة «البرنامج الثقافي»، في الراديو المصري، كانت تقدم ساعة أسبوعياً مع حسين فوزي الذي كان يتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية بطريقة سهلة كأنه يجلس معك في البيت. كان أي أحد يستطيع أن يفهمه. أحببتُ الموسيقى من خلاله. اكتشفتُ بعد ذلك أن هذا البرنامج يترك الموسيقى وحدها تعمل من دون مذيع منذ الثانية وحتى السادسة صباحاً، وهو الوقت الذي أجلس فيه لأكتب، وأفكر، في هدوء. لم أكن ملتزماً بعمل طيلة حياتي. قد أذهب إلى العمل مرة أو اثنتين في الشهر، لأتفرغ للكتابة.
> ولماذا هذا اللحن تحديداً؟
– كان يتكرر كثيراً، وسط الألحان، لحن حزين جداً. أحببتُه حتى تخلَّل روحي. بحثتُ عنه حتى عرفت اسمه؛ «أداجيو». في 2003 نشرت روايتي «برج العذراء» وكنت فيها ناقماً على الحياة، كارهاً إياها، بعد وفاة زوجتي بداء السرطان. منذ ذلك الوقت وأنا أريد كتابة رواية عن لحن «أداجيو»، لكني لم أكن قادراً، فقد حاولت مرةً ولكني بكيت كثيراً بعد خمسة سطور فقط، فتوقفت عن الكتابة. في هذه المرة، وبعد مرور 12 عاماً استطعت الكتابة عن اللحن والمرض. بكيتُ أيضاً هذه المرة، ولكن في منتصف الرواية، وقررتُ أن أكمل ما بدأت، فكان «أداجيو»، لحني الأثير.
> تنتظر 12 عاماً لتكتب الرواية؟ ألم تخش ضياع فكرتك؟
– لا، فأنا لا أدون أفكاري عن الكتابة. تأتي الفكرة فأتركها حتى أعود إليها في وقت لاحق. إن بقيت فلا بأس، وإن تبخرت من ذهني، فأنا على يقين بأن عشرات غيرها ستقفز إلى الذهن. أذكر مرة أرادت مذيعة، لا أذكر اسمها الآن، أن تجري معي حواراً عن «مفكرة الكاتب» وعندما أخبرتها بأنني لا أدون أفكاري ولا أحمل مفكرات، وقفت مبهوتة، لأن هذا معناه ضياع الحلقة، ولكن عالجنا الموقف بأن دار الحوار حول ذاكرتي الخاصة التي أعتمد عليها: ذاكرة النسيان.
> لا تعتبر ثلاثية الإسكندرية حكاية متصلة كثلاثية نجيب محفوظ... هل هي تأريخ للمدينة؟
– هي تاريخ وتأريخ للمدينة. لم أكن أفكر في الثلاثية قبل رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية». بعد الرواية ظهرت لي الفكرة، فكتبت «طيور العنبر»، ثم «الإسكندرية في غيمة». الإسكندرية مدينة عالمية، لكنها انهارت على مراحل، الأولى بعد ثورة تموز (يوليو) وتحت شعار القومية العربية تمَّ التخلص من الأجانب في المدينة. في السبعينات أصبحت مدينة سلفية، ثم طرأت عليها تغيرات في نهاية التسعينات وحتى قيام ثورة كانون الثاني. ترصد الثلاثية مراحل تطور الإسكندرية، من العالمية، إلى المصرية، إلى السلفية.
> ما الذي يفسر حضور الإسكندرية في غالبية إنتاجك الأدبي؟
– عشت طفولتي، مراهقتي، وشبابي فيها. تركتها وأنا ابن 25 عاماً. تشربتُها في شكل كبير، ولم أقدر على التخلص منها مهما حاولت. دائماً أجد المدينة تناديني ويجذبني نحوها شيء غامض.
> تؤمن بالفلسفة الوجودية، وتتحدث كثيراً عن أهميتها... فيمَ أفادتك دراستك الفلسفة في كتاباتك الأدبية؟
– قد تقول في رواية ما أن هذا العالم هو عالم اغتراب يقوم على الوحشة والانعزالية، وقد تقوم بوضع بطلك في مكان لا أحد فيه. الخيار الأول ليس بفن وإنما هو تقرير بحت، أما الثاني فيخدم الفن في النص. هنا تفيدني الفلسفة وتسعفني للتعبير عما أريد قوله. في رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية» شخصية ثانوية هي شخصية ساعي البريد الذي استمر في عمله بعد أن قامت الحرب وعندما سأله أحدهم، أجاب بأنه يفعل ما داوَم عليه طيلة سنوات ماضية. هو استلب حريته عبر مهنته ولم يعد يدرك أنه لا بريد وسط تلك الظروف. الاغتراب مسألة مهمة في الفلسفة الوجودية، تأتي من الكون حيث يولد الإنسان ويموت بلا إرادة. بين الميلاد والموت يوجد الجحيم. الآخرون هم هذا الجحيم. أما في الماركسية فيأتي الاغتراب من الآلة التي يريد الإنسان أن يكسرها. لقد وصلتُ بالفلسفة إلى أن المكان موجود أكثر من الإنسان.
> بمعنى؟
– في الروايات الكلاسيكية والرومانسية، يصبح المكان والزمان قيد الحالة العاطفية للإنسان، ولكني ذهبتُ إلى أن الأشياء هي صانعة الإنسان، إذا كنتَ في الصحراء وتريد أن تأكل، فلن تستطيع وستغني مثلاً، أما إذا كنت في المدينة فستذهب فوراً إلى المطعم لتأكل. عندما تنتظر شخصاً ما، فستتحدث بلغة المكان الذي أنت فيه. لغتك حين تجلس في مطعم، ليست هي ذاتها حين توجد في ميكروباص، أو حديقة مثلاً. هكذا اهتديتُ إلى أن المكان هو صانع الشخصية.
> في رواية «بيت الياسمين»، يبدأ كل فصل بحكاية تراجيدية لا علاقة لها بباقي الفصل، وتبدو هذه الحكايات دخيلة على النص الأصلي للرواية...
– اجتهد النقاد كثيراً محاولين إيجاد علاقة بين هذه الحكايات وباقي الفصول. بعضهم نجح في استنتاج علاقة أو اثنتين، ولكن لم ينجح أحد في تفسير العلاقات كاملة. كل ما أردتُ أن أقول هو أن العالم أكبر من ذلك، وعندما يقرأ أحدٌ فإنه يحاول أن يفهم التناقض بين الدراما في الحكايات الصغيرة في مداخل الفصول وبين الكوميديا في باقي الفصول. كانت متعة، ولا أنسى صديقي محمد كشيك عندما قال لي أن أجمع تلك الحكايات التراجيدية الصغيرة في كتاب مستقل، لكني رفضت لأني لم أكن واثقاً في أني قادر على فعلها مرة أخرى.
> رفضت العمل محرراً في جريدة «الأهرام» القاهرية عام 1975... لماذا؟
– رفضت العمل أيضاً في جريدة «الأخبار» القاهرية. طبيعة العمل الصحافي لا تناسبني، لأنها حتماً ستؤثر في أسلوبي في الكتابة. هناك آخرون يستطيعون الفصل بين الكتابة الصحافية والأدبية، لكني لم أرد أن أحاول. كما أن في هذه المهنة مشاكل وصراعات لا طاقة لي بها ولا أحب الخوض فيها. لهذا آثرتُ التفرغ للأدب، الذي أفهمه، وأحبه.
> لدينا إنتاج أدبي ضخم، لكنه لا يجد حركة نقدية ترصده... ما تفسيرك؟
– أصبح النشر سهلاً، والمعروض يفوق طاقة النقاد. معظم النقاد مشغولون بالدراسات الجامعية، وقليل منهم من يتصدى لعمل نقدي. كنا في السبعينات ننشر في «الهلال» و «الهيئة العامة للكتاب» فقط. الجوائز حفَّزت على الكتابة في شكل منتظم. أصبح لدينا نقاد وشعراء يكتبون الرواية.
> قلت من قبل أنك تتمنى إلغاء وزارة الثقافة... لماذا؟
– هذه الوزارة جاءت ضمن آليات الحكم الشمولي بعد ثورة 1952 من أجل إحكام السيطرة على كل شيء داخل الدولة بما في ذلك الثقافة ودورها. الآن لم يعد لها دور. أنا أريد أن تُلغى تماماً وتتحول الدولة باتجاه دعم القطاع الخاص الذي ينشر أضعاف ما تنشره الهيئات الحكومية. يجب أن تتحول «الهيئة العامة للكتاب»، و «هيئة قصور الثقافة» إلى قطاع خاص مع بقاء دار الأوبرا وجوائز الدولة. في فرنسا لا تتولى وزارة الثقافة نشر الكتب، لكنها تدعم الناشرين والمعيار لديها هو الفن وجودة النص، لا شيء آخر. اليوم تخبرنا الدولة، في كل وقت، أنها مع الحرية وضد الحكم الشمولي، فلماذا تنشر الكتب وتتولى إدارة الثقافة؟
> ما الجديد عندك؟
– كتاب في عنوان «أنا والسينما»، قيد النشر عبر دار «بيت الياسمين». يحكي عن علاقتي بالسينما وشغفي بها، الذي بدأ مذ كنتُ في الخامسة من عمري. كنت إذا شاهدت فيلماً مأخوذاً عن عمل أدبي، أبادر بالبحث عن هذا العمل لأقرأه. هكذا فتحت السينما عيني على الأدب العالمي، وهو أمر يستحق أن أوثقه في كتاب.
“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.