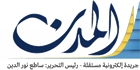جريدة المدن الألكترونيّة
الجمعة 17-05-2019
المدن - ثقافة
حاورها : محمد حجيري - رئيس القسم الثقافي في “المدن
هدى بركات لـ”المدن" :"بريد الليل" ليست نوفيلا ولا أدب رسائلة

لا تحتاج الروائية هدى بركات إلى تعريف أو تقديم، وهذه المقابلة معها ليست حول فوزها بالبوكر عن رواية “بريد الليل”، بل اخترناها أن تكون حول الكتابة وطقوسها ومكانها وزمانها والروايات وأبطالها ولغتها...
- قيل الكثير في توصيف رواية “بريد الليل” وعن رسائلها وتيمتها وشكلها وحجمها، وبغض النظر عن كل ما قيل ويقال... كيف تقدم هدى بركات روايتها إلى القارئ ؟
أنا ما زلت قاصرة عن مزاولة هذا التمرين، أي تقديم الرواية أو الـ"بيتش". وهذا ضروري خاصة بالنسبة لدور النشر الغربيّة. أتمرّن على هذا الأداء لكنّي لا أنجح كما أرى عند كتّاب آخرين. أعتقد أنّ فشلي هذا طبيعي بغض النظر عن فن الأداء لأن ما أريد قوله موجود في النص، واختصاره عملية شاقة. كذلك تلك اللّمحة السريعة على الغلاف الخلفي.
أستطيع مثلا القول إنّها ليست من أدب الرسائل، لأنها لا تحترم مرجعيات معروفة لهذا الأدب، بل تستعمل هذه التقنيّة “ملغّمة” إن جاز التعبير لتحملها إلى مكان آخر... ثم هي ليست نوفيلا، كما أُلمح مرّات. على أي حال الـ"نوفيلا" مثلا صفة غير موجودة في فرنسا، ورواية الكاتب إدوار لويس الأخيرة التي لاقت نجاحا كبيرا تقع في 80 صفحة ولم يقل أحد إنها نوفيلا! ثم هي لفظة استُعملت في أميركا لنشر مقاطع جذابة من روايات طويلة وكثيفة لكتّاب مثل سرفانتس أو جين أوستن... إلخ.
- ما الذي يجمع بين هروبك من نار الحرب العام 1989 وبين من كتبت عنهم في “بريد الليل” الهاربين من نار الحرب السورية ؟
أنا لم أذكر سورية. لكن يحق للقارىء أن يستدلّ على إشارات في النص. وإن افترضنا ذلك صحيحا فليس كلّ كتّاب الرسائل من سورية. وإن ذهبنا إلى هذه الإشارات سنجد الشخصيات التي تنتمي إلى أماكن/ حروب/ كوارث أخرى. لكن هل هذا مهم؟ أعني المكان الذي تركوه؟ أنا أردت الإبتعاد عن تحديد الموطن لأتجنّب الإيحاءات السياسة، ولكي أقول كم أنّهم متشابهون في وحشتهم وانكسارهم وغربتهم.
ربّما أنا حسّاسة جدا في موضوع الغرباء، لأنّي غريبة وأقيم في بلد بعيد عن بلدي، بسبب الحرب، كما ذكرت. عندي دوما هذا الشعور بأن الحرب دفعتني خارجا غصبا عني. وما تلاها من أوضاع لبنان الحالية ومن ظروفي الشخصيّة لا يسمح لي بالعودة. بل إني بشكل من الأشكال لم “أهضم” غربتي، وكأن الأوان قد فات على المراجعة والآن لم يعد مكان الإقامة الجغرافيّة مهما. أنا موجودة حيث يكون أولادي، ببساطة وقبل كل شيء... هكذا تحملنا الحياة/والحروب/ إلى أماكن بعيدة، في الجغرافيا وفي الذات، لم يكن لنا فيها أو عليها أي خيار.. كما تقول إحدى شخصيّات “بريد الليل”...
- قلتِ قبل مدة “إن ما دفعني إلى الشكل الأخير للرواية كان نفاذ مشاهد المهاجرين الهاربين من بلدانهم إلى وساوسي. هؤلاء المشردون في الأرض، مستقلو قوارب الموت، ولا يريد العالم النظر إليهم إلا ككتلة غير مرغوب فيها أو كفيروس يهدد الحضارة، في حين رحنا نكتشف تراجع البعد الإنساني لتلك الحضارة، وتحصن القوميات بإقفال الأبواب. هذا لا يعني أني أريد للبلدان الغربية أن تشرع الحدود أو تنظر إلى هؤلاء كملائكة. أردت فقط الإنصات إلى حيوات تهيم في صحراء هذا العالم”. وبرأي النقاد أنت تكتبين “بلغة عالية عن الشخصيات والتواريخ، وتنوع في رواياتها بين فنون الكتابة الذاتية والسردية”... كيف توازنين بين اللغة المكثفة الأدبية الرفيعة في “بريد الليل”، وبين اناس مهمشين بائسين هاربين، وحرب قاسية...
لغة “بريد الليل” مقتضبة ومباشرة وليس فيها تجميلات أسلوبيّة. وهي مكثّفة بطبيعتها. الهارب المطارد قصير النفَس ولا يملك الوقت للتدبيج... ربّما تكون الميزة هنا، في هذه الرواية هي شكل التناول. أي النزول إلى قعر الكلام، حتّى الكاذب المضاد لما نسمّيه البوح. كان المحو والتكثيف أهم ما اشتغلت عليه في “بريد الليل” وأصعب ما واجهني... من المؤلم أن ترمي بمقاطع تعتبرها جميلة لمصلحة النصّ المتماسك ككلّ.
على أيّ حال أنا لست من الكتّاب الذين يتنكّبون قول الحقائق باعتبار الرواية كشف واقعي. ملازمة الشخصية سرديا لا تفترض بالضرورة الكلام بـ"اسمها"، أو تمثيلها في الواقع. أعني كان من الممكن كتابة “بريد الليل” بأسلوب آخر، بتورية مختلفة وبـ"لغة رفيعة" على ما جاء في السؤال. في “ملكوت هذه الأرض” استعملت اللغتين بالتوازي، مثلا...
- تقولين في إحدى المقالات “كنت بدأت في كتابة”حجر الضحك" قبل أكثر من خمس سنوات من صدورها. كلّما عدتُ إليها كنت أعاود الكتابة من الأوّل. بسبب أني كنت أتركها حين نهرب من البيت (زمن الحرب)، من البيوت المتعدّدة، وحين أعود إليها أجدها كسمكات الولدين الطافية على المياه الآسنة، ميتة"، “بريد الليل” والروايات الأخرى، كيف كانت كتابتها، لناحية الوقت والطقس واعادة الكتابة والمكان ؟
للإجابة على سؤالك ينبغي علي أن أعود إلى كل رواية على حدة. لأن لكل رواية “حكايتها”. على أي حال في ما خصّ الوقت فهو حاجة باذخة، تفترض أنك لا تحتاج للعمل كي تعيش، وهذا ليس وضعي. أي أني لا أستطيع التفرّغ، إلا لفترات قصيرة جدا، كأن أستفيد من إقامة أدبيّة مثلا. الآن بت أشعر كم أن ذلك ضروري للتأمّل في تعميق التجربة. فما نكتبه ينكتب حين نكون إزاء الورقة، أو الكومبيوتر. للسبب نفسه ليس عندي “طقس” للكتابة، لكني أصفى ذهنا في الفجر، ربّما بسبب إنشغالاتي كأمّ في البداية، حين كان الولدان صغيرين، ولكي “أربح” ما بقي من النهار في القيام بأعباء الحياة... وعن إعادة الكتابة فهي ضرورة مطلقة بالنسبة لي. يجب أن “أنسى” النصّ لمدّة قد تطول، لكي أعود إليه بنظرة ناقدة تتخذ المسافة من “تيّار المشاعر” الجذّاب، والذي قد يفخّخ الكتابة. بمعنى أنّه يحدّ من السيطرة على السرد، كما حين “يندمج” ممثل فاشل بدوره..
- في مكان آخر تقولين “كلّما كبرت في العمر أو في الكتابة ازداد شكّي في ما أعرفه. صحيح أنّني أقرب إلى حدس آلام الآخرين، فيصبحون شخصيات متألّمة، إذ يكشف كلامنا القاسي عن الألم قاعاً أو قيعان لا نريد رؤيتها، ونفضّل أن نتناساها ونتناسى مسؤوليتنا فيها وعنها. أنا كإنسان أشكو قلقي وأودّ أن نتواصل عبر وسائل نسمّيها فناً، تساعدنا على كسر الوحشة بشيء من المتعة. أفضّل مثلاً الكتابة الروائية على وسائل التواصل التي لا أملك حساباً في أي منها”، ما الذي تغير في الافكار التي تكتبين عنها أو الأشخاص الذين تكتبين عنهم، بدءا من “حجر الضحك” مروراً بـ"حارث المياه"، واهل الهوى" و"رسائل الغريبة"، وصولاً حتى “بريد الليل” ؟
ربّما الذي تغيّر هو أني أصبحت أكثر شجاعة إزاء القارىء، أو الناقد، عموما. أصبح بإمكاني تناسي أدوات التلقّي والقراءة إلى حدّ ما. أصبحت أسمح لنفسي بعدم “الشرح”، أي أن أكون أكثر جرأة، وأكثر اعتمادا على ذكاء القارىء وعلى ثقافته. أنا أطمح لأن أكون “شعبية” لكني أعرف إنّي لست كذلك، وهذا يجعلني أكثر احتراماً للقارىء. مع ذلك أنا أعطي مخطوطتي لقارئ “عادي” (إحدى شقيقاتي أو ابنتها مثلا)، لا مثقّف ولا ناقد محترف، وأهتم لرأيه كثيرا، إذ يفيدني هذا الرأي في الإطلاع على مستويات التلقي...
- هل ثمة قاعدة محددة في كتابة رواياتك الجديدة “ملكوت هذه الأرض” و"بريد الليل" وشكلها؟ أم أنك تنفذين قولك “شكل كتابة الرواية يولد مع فكرتها الاساسية رواياتي مختلفة عن بعضها وفي كل مرة تتركب على ايقاع معين”؟ هذا السياق أو الإيقاع هل قادتك ذات مرة إلى رواية متعثرة النهاية، أو عجزت عن إكمالها ؟
بالفعل. كلّ رواية تتركب على فكرتها الأساسيّة، في الواقع على جملتها الأولى. أي أني أحدس بما ستكون عليه الرواية عندما أبدأ فعلا بالكتابة. لأنّي أكتب “في رأسي” طويلا. هذا أيضا بسبب الإنشغالات اليومية وإيقاع العمل من أجل العيش. أنا لا أتشكّى إذ لذلك إيجابية كبيرة على ما أعتقد. لذا حتّى الآن لم ألق تعثّرا حقيقيا يوقفني عن المتابعة حتّى نهاية الرواية...
على أيّ حال أنا بطيئة في الكتابة، ويلزمني وقت طويل، أقلّه أربع سنوات بين رواية وأخرى.
- عادة ما تلجأ بعض الكاتبات (وحتى الكتاب) العربيات إلى تصوير الرجل العربي أو الشرقي في مشهدي الذكوري والعنيف، أما أنت فتختارينه بصورة الهش والضعيف والمريض وحتى حين يكون ذكوريا تضفين عليه واقع الضعف، أي أثر اجتماعي ثقافي جعلك تركزين على صورة الرجال الضعفاء في رواياتك؟ حتى إنك صرحت ذات مرة بأنك “تعذبت كثيراً في السيطرة على شخصية الرجل” ؟
هذه الجملة قلتها في مجال تناولي لرجل روايتي “أهل الهوى”، ليس بسبب أنّه رجل، بل لصعوبة تكوّن هذه الشخصيّة في رأسي. كان “يفاجئني” عنفُه إذ ألحق به ويخرج من رأسي بصورة مضنية لأنّه كان يردّني إلى عنفي الداخلي الشخصي الذي لم أكن أعرفه، أو ما اختزنته من عنف دون إدراك مني... الضعفاء يشون بقسوة العنف بشكل أكثر دلالة في قوّة البطش والقدرة- سرديّا - على تلقّي السحق والقهر. لعبة المرايا هذه أكثر غواية عندي، وأنا أكثر إلتفاتا إلى ناحية الظل، والى السؤال في ما قد يجعل رجلا يعنّف الكائن الوحيد الذي يحبّ، مثلا. إذ نعم، هناك من الذكوريين من يستحق الشفقة، ومن يشي بأمراض مجتمعه أكثر من غيره من “الأبطال” والشخصيات. فالفرد قد يكون وعاء صريحا تتجمّع فيه جراثيم الجماعة المأزومة. أنا لا أحاكم شخصياتي أخلاقيا، أنا أقترب، وأنصت فقط. ثمّ أن العلاقة بين الجلاّد والضحيّة، وقد كُتب فيها الكثير، مدعاة للتأمّل.
- تعيشين في فرنسا منذ ما يقارب الثلاثة عقود، ومع ذلك معظم كتاباتك عن لبنان، وجزء كبير منها عن الحرب، وحضور فرنسا يبدو هامشياً اذ جاز القول، هل الكتابة هي مخاض ذاكرة عمر معين من الحياة أو قراءة رؤية موازية للواقع وتجلياته وناسه وحروبه؟
فرنسا، التي لم أختر الهجرة إليها، وفّرت لي الحريّة في انعزالي عن ضرورة التأقلم مع الواجب الإجتماعي ومراعاة فولكلور العلاقات المفروضة علينا. وهي كرّمتني في أوجه كثيرة. لكني لست فرنسية أصلية ولن أكون. ولست فرانكوفونيّة رغم مساهمات لي عديدة وباتت مهمّة باللغة الفرنسية التي أحبّها وأقدّرها أيضا طبعا. لكن لي لغة وهي العربية، لأني ببساطة عربية، وأكتب عن مكان عربي وعن أناس، شخصيات، لغتهم هي العربية. كنت ربّما سأكتب بالفرنسية لو أني أجهل اللغة العربيّة، أو لو أن لكتابتي طموحات “عالميّة” سريعة لا تحبّ التأني أو الإنتظار. الترجمة إلى الفرنسية التي تتبع رواياتي تأتي أحيانا بالتزامن مع النشر بالعربية.
- هل الكتابة باللغة العربية تجعلك بعيدة من الواقع الفرنسي ؟
لست بعيدة من الواقع الفرنسي أبدا، لكنّه حتّى الآن ليس “منطقتي” السرديّة، ربّما لأنّي حملت معي ما يكفي لعمرين أو أكثر. وربّما لأن أسئلتي الأكثر إلحاحا تأتي باللغة العربية ومنها. على أيّ حال أصبح العالم أوعية متصلة بحق. واهتمام الغرب بكتاباتنا، كما يحصل حاليا مع “بريد الليل” منذ صدورها، ووصول التعبيرات السرديّة العربيّة إلى مستويات عالية، يؤكّد أن الرواية العربية تركت الهامش إلى المتن. وأكرّر أنّه ليس بالنسبة اليّ وحدي طبعا. أنا لست مع النظرية التآمريّة التي تلقي على الغرب، كلّ الغرب، كلّ شيء في الغرب، نوايا باستهدافنا. الغرب متعدّد. الغرب متعدّد قطعا وهو ليس واحدا، وعلينا أن نكف عن إلقاء اللائمة دوما على غيرنا في ما يصيبنا... لا أحد يستهدفنا إن لم يجد سواعدنا في خدمته.
- ما النصائح التي يمكن توجيهها لمن يود كتابة رواية، خصوصاً من الشبان ؟
العوذ بالله! نصائح؟! حتّى لو كان عندي نصائح، ككثرة القراءة مثلا، فهي لا تنفع...
عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة
حقوق النشر
محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.
جريدة العرب
الأحد 2018/09/02
الصفحة : ثقافة
محمد الحمامصي - كاتب مصري
هدى بركات : الرجال في رواياتي ضعفاء
الروائية اللبنانية هدى بركات تؤكد أن أحداث السنوات الأخيرة كشفت في الشخصية العربية أعطاباً وجودية.
منذ روايتها الأولى “حجر الضحك” استطاعت الروائية اللبنانية هدى بركات أن تحتل مكانة متميزة في مسيرة الرواية اللبنانية خاصة والعربية عامة، حيث تلتها برواية لا تقل جمالا وثراء وهي “حارث المياه” التي فازت بجائزة نجيب محفوظ عام 2001 لتتوالى بعد ذلك رواياتها “أهل الهوى” و”سيدي وحبيبي” و”بريد الليل” و”ملكوت هذه الأرض” التي حظيت باهتمام واسع بين المتلقين والنقاد على امتداد العالم العربي لثراء النص واكتناز الرؤى التي قدمتها الرواية وأيضاً بفعل تمكّن الكاتبة من رسم شخصياتها وابتكار أحداثها، وهو ما جعل هذا العمل الروائي غنيا بعوالم متعددة الملامح والوجودات بكل ما تزخر به وما يتخلق فيه بفعل خيال خصب.
العام الماضي فازت الكاتبة بجائزة العويس في دورتها الخامسة عشر، وهو ما دل على طبيعة الاستقبال الذي باتت تحظى به من قبل النقاد والقراء على حد سواء، وهو تأكيد على براعتها في إبداع عمل روائي متميز. جاء في تقييم لجنة التحكيم للجائزة “أعمال هدى بركات طافحة بالفقد والخسران والتيه والعنف والبحث عن معنى في الفوضى العارمة حولها، حيث تكتب بلغة عالية عن الشخصيات والتواريخ، وتنوع في رواياتها بين فنون الكتابة الذاتية والسردية”.
في هذا الحوار مع بركات نتعرف على ملامح من تجربتها الأدبية.
الجديد: هل تعتبرين روايتك الأخيرة “بريد الليل” مانيفستو ضد كل ما حدث في السنوات الأخيرة في المنطقة العربية؟
هدى بركات : قد تكون روايتي الأخيرة “بريد الليل” مانيفستو عاطفي -قطعا ليس سياسيا- إنّها أقرب إلى الشكوى العميقة التي لا تجد من تشكو إليه. فأحداث السنوات الأخيرة، كما تسمّيها، كشفت أعطابا كثيرة في مجتمعاتنا العربيّة، أعطابا وجوديّة بالفعل، وأكثر من دفع الثمن هم الضعفاء المنكشفون دون حماية، وهؤلاء الذين ازدادوا غربة على غربتهم.
الجديد: رسائل “بريد الليل” لا تصل.. هل هذا لأنك تعتقدين بأن الأمل شبه معدوم بالنسبة لمجتمعاتنا العربية؟
هدى بركات : نعم، إنّها رسائل لا تصل إلى المرسل إليهم، تعترضها أقدار وظروف، حتّى نخال أنّها، حين كُتبت، لم يكن كاتبُها يأمل فعلا بوصولها… لذا تتخذ الرسالة شكل الشكوى لإنسان مستوحش ووحيد. يحمل الظلم كما يحمل البراءة عبئا. فترتجّ الحدود، مثلا، بين الفعل الإجرامي وسلّم الأخلاقيّات. وكذلك بين الواقع والخيال.
إنّها مرحلة اللايقين بامتياز، كأنّنا في ليل بهيم فقدنا فيه القدرة على فصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وذلك من دون مراجع ثابتة إلى أيّ نوع انتمت… شخصيّات الرسائل ضائعة لأنّها واقعة في يُتم بلدانها ومجتمعاتها. هل نسمّي هذه الحالة يأسا؟ إنّه تخبّط وضياع كبيران. وفي هذه الحال ليس هناك أجوبة ليتشكّل الأمل، علينا فقط، ربّما، البحث عن الأسئلة الآن.
الجديد: قصصك في “بريد الليل” تقطع الأنفاس حتى ليخال القارئ أنه لن يخرج حيا من مغامرة القراءة. هل من جدلية واضحة بالنسبة لك بين الجلد “جلد القارئ” وتمتيعه عبر أدب يليق به هذا الاسم؟
هدى بركات : أعتقد أنّها المتاهة، بتقنيّة الرسائل التائهة، بحيث نخرج من تفاصيل النصوص الفرديّة إلى المشهد وهو مكتمل لنجد ما يربط بين هؤلاء جميعا. إنّه انكسار حيوات ضاعت بضياع مراجع هوّياتها بحدّها الأدنى.
وفي الفصل الثاني، “في المطار” حيث تجتمع مصائر لا يجمع في ما بينها سوى عبث الحياة، يتأكّد شيئا فشيئا سوء الفهم الفظيع الذي نخضع له كعرب في مجتمعات اللجوء والهرب. إنّها غربة مزدوجة، عن بلداننا التي تركنا حروبها هربا، وعن أمكنة اللجوء حيث لا يريدنا ولا يقبل بنا أحد.
ليس هناك أحكام قيمة في هذه الرسائل. هذا ربّما ما يجعل منها عملا أدبيّا خالصا. لا أعتقد أنّ في ذلك “جلدا للقارئ” كما تقول. لكن نزع الوهم والنظر إلى موضع الألم يتطلّب ولو القليل من الشجاعة على مواجهة العري.
الجديد: “ملكوت هذه الأرض” هو كتاب العودة إلى منطقتك في شمال لبنان، وهو برأي الكثيرين تحفتك، هل هذا هو البرهان على أن الكاتب مهما هاجر وتغرّب سيبقى ابن بيئته؟
هدى بركات : روايتي “ملكوت هذه الأرض” شغلتني لسنوات طويلة، وانتظرت من أجل البدء بكتابتها استعدادا داخليا. ليس فقط لأنّها “عودة” إلى المكان الأوّل، بل بسبب ما استحالت إليه أحوال التفتّت في كافة المجتمعات العربيّة.
فلو استبدلنا لبنان الشمالي بمناطق من سوريا أو العراق مثلا لوقعنا على معادل غير بعيد لبلدان فشلت في تحقيق استقلالها، وأضاعت طريق اللحمة الوطنية والمواطنة لتغرق في لجج المذهبية والقومية المتعصّبة… العودة إلى مطلع القرن الماضي كانت بالنسبة لي الصعود إلى منابع الفشل الأولى. كيف حصل ما حصل ومن أيّ نقطة أو موضع بدأ الشرخ؟
بالطبع عدت إلى ما أعرفه، إلى بيئتي، وقد أقول لك إن الهجرة والتغرّب يزيدان من حدّة الرؤية، ويثريان المسافة المكانيّة والزمنيّة على السواء من شوق الغوص في البيئة التي يخرج منها الكاتب ليعود أكثر تمكّنا من أدواته، وأكثر تطلّبا في نوعيّة ما يكتب… دون الوقوع في نوستالجيا سخيفة طبعا، تجمّل بدل أن تقاضي.
الجديد: جدوديّتك تظهر في “ملكوت هذه الأرض”، بعد الأمومة ما الذي تضيفه الجدوديّة للكاتب؟
هدى بركات : أعتقد أنّنا أضعنا الجدود، في ما أضعنا من موروثاتنا الجميلة. كأنّنا في لحظات غضب ونكران أردنا إلغاء الماضي برمّته. اعتقدنا أنّها أوهام “الحداثة”، وطبعا كانت لحظة عمى سمّيناها “ثوريّة”.
اختلطت على جيلنا أمور كثيرة، وحين عدنا إليها لم نجدها. في حكايات العائلة كما في بناء المدن وأحوال المجتمع رمينا الطفل مع ماء الحمّام كما يقول المثل الفرنسي. استعادتي الجدّ في الرواية كانت ركيزة انطلاقها، ومفتاح قراءتها الأوّل.
الآن أنا جدّة. شخصيا هذا يضيف إلى معاني حياتي ثراء كبيرا وفرحا بلا حدود. لكن حزني الوحيد هو عدم استطاعتي التكلّم مع ياسمين باللغة العربيّة، رغم أنّها باتت ترطن بها قليلا لأنّها تتعلّمها في مدرسة خاصّة. أحاول التعويض قدر المستطاع، بالحكاية والأغاني، وبالطبخ أيضا، وبالسفر إلى لبنان كلّما سنحت الظروف… وبانتظار أن يسمح القانون بإعطائها جنسية أمّها.
الجديد: بداية هل نستطيع القول إنك تأخرت في إصدار عملك الروائي الأولى “حجر الضحك”؟
هدى بركات : نعم هذا صحيح. لم أكن مستعجلة. لم يكن يهمّني إضافة كميّة من أوراق بلا قيمة على الكميات التي تُنشر. النشر مسؤوليّة كبيرة كنت أتهيّبها جدا. فقط حين نشرت مجموعتي “زائرات” التي كتبتها كتمرين، رحت أفكّر بروايتي الأولى “حجر الضحك”. قضيت في كتابة ومحو حوالي خمس سنوات أو أكثر.
أولا بسبب ظروف الحرب والتهجير، وثانيا بسبب تجربتي في الحياة التي كانت تتغير بسرعة، ولإدراكي أن الكتابة –وهي لم تكن من أولوياتي مع وجود طفلين صغيرين– عمل بناء جادّ وشاقّ وعليه أن يحمل جديدا ولو بحدّ أدنى. ومرّة أخرى أقول إنّي لم أكن مستعجلة، كما ما زلت حتى الآن، وسأبقى أشتغل على إيقاعي الخاص. فعدد الإصدارات لا يهمني أبدا، كما لا يهمّني حضوري “الاجتماعي” ككاتبة.
الجديد: على الرغم من أن “حجر الضحك” كانت روايتك الأولى فقد حازت احتفاء كبيرا من قبل القارئ قبل الناقد هل كنت تتوقعين ذلك، وهل لذلك علاقة بكونها تناولت الحرب الأهلية اللبنانية من جانب واتخاذها لمثلي شخصية أساسية؟
هدى بركات : هذا صحيح. والحقيقة أنّه فاجأني فعلا. فـ”حجر الضحك” لامست في نجاحها أبعادا لم أكن أتوقّعها. وما فاجأني فعلا، وما يزال، أنها لم تخضع لأيّ نوع من الرقابة رغم تداولها الواسع حتى اليوم.
كنت أعتقد أنها ستواجه أقلّه بعض “المآخذ” في موضوعات جديدة، خاصّة في تناول شخصيّة المثلي من دون حكم قيمي سلبي، وما يستتبع ذلك من صفحات جريئة في تصريفات الحب من دون أن تكون جنسيّة أو بورنوغرافيّة.
لم تكن “حجر الضحك” الرواية الأولى التي تناولت الحرب الأهلية، ولا أعتقد أن ذلك سبب نجاحها بأيّ حال. ليس الموضوع، أيّ موضوع، هو ما يعطي الأهميّة لعمل روائي، أو فني عموما. بل كيفيّة التناول، وبأيّ محمول ثقافي، وبأي عمق لوعي المبدع… وهي “شروط” صعبة للغاية، لا يمكن توقّعها، أو التقصّد فيها.
أنا شخصيا لا أفكّر في “أسباب النجاح” وقد لا يقلقني بعض صعوبة في التلقّي. هذا ليس شغلي. بل هو من ملحقات العمل التي تأتي بعد الانتهاء منه… وقد تكون بعض ظروف الواقع إعاقة أمام نجاح عمل جيّد ما، وهذا لا يُنقص من جدارته وجدّته… حصل ذلك مع روائع كثيرة. ليس من شأن الكاتب طلب “ضمانات نجاح”، أو العمل على ذلك، بل أن العكس قد يكون صحيحا.
الجديد: الكتابة في رواية “سيدي وحبيبي” جاءت سرداً متقطعاً وغير متسلسل، هل كان ذلك من جانبك بمثابة تقنية مناسبة في السرد أم هي صيغة فرضتها هوية بطل الرواية وديع؟
هدى بركات : لا تفرض الشخصية شيئا. بل هي من “ضمن” تقنيات الكتابة نفسها. في رواية “سيّدي وحبيبي” جاء شكل السرد من موضوع الحكاية التي أرويها. لذلك أقول إن لكل رواية روايتها، أي تقنياتها الخاصة بها تماما، ولا تنطبق على غيرها. فأنا لا أملك تقنيّة واحدة، لي، لكتابتي الروائيّة.
تأتي تقنية السرد عندي حين أصل إلى تكوين الجملة الأولى، أي حين يتأكّد لي أنّي بتُّ قادرة على كتابة الرواية. الجملة الأولى هي أصعب ما في الرواية، وهي بداية اليقين من قدرة البدء بسماع “الصوت”، أعني صوت السرد الحامل لمستوى التناول اللغوي للحكاية. إن انتظار هذا الصوت الخاص يعني استعدادا قد يأخذ وقتا طويلا. قد أبقى في نوع من البحث والتجريب لمدة طويلة قبل أن أبدأ الكتابة. قد أنتظر طويلا قبل “السيطرة” على طرف الخيط والتمكّن منه في يدي –أي تلك الجملة الأولى- بعد ذلك تبدأ الرواية حياتها على الورق.
الجديد: لماذا تبدو شخصية الرجل في مجمل رواياتك ضعيفة يتجلى هذا واضحا في روايتيك “أهل الهوى” و”سيدي وحبيبي”؟
هدى بركات : هذا صحيح في مجمل كتاباتي، وليس فقط في هاتين الروايتين. الرجل يبدو “ضعيفا” كما تقول لأن شخصياتي ليسوا أبطالا. إنهم على الأغلب هامشيون، أو هم يصارعون أقدارا غاشمة أو ظروفا قاسية في مجتمعات مأزومة وعنيفة… وتطلب من الرجل أن يكون محاربا ليذود عن القبيلة رغم وعيه بأخطائها. فكيف يستطيع الفرد أن يكون “قويّا” آنذاك، وبأيّ مفهوم للقوّة؟ ونحن نتخبّط في أمراض مزمنة من أين نخترع ذلك التماسك المطلوب من الجماعة، وبأي معيار.. نعم. شخصياتي ضعيفة. وحين تنقلب إلى البأس تكون صارت في الإجرام.
الجديد: ما أبرز ما حملته من لبنان حين خرجت منها عام 1989 وما دوره في تشكيل رؤيتك الروائية واختيار شخصياتك وأحداث رواياتك ومواقفك من العالم؟
هدى بركات : ما حملته معي من لبنان حين خرجت عام 1989 هو كلّ ما أنا هو اليوم، مع إضافات قد أصفها بالهامشية. أنا أعيش في فرنسا كأنّها نافذة أطلّ منها إلى بلادي، خاصّة في الكتابة. لم أكتب عن فرنسا سوى بعض النصوص الأدبية التي طُلبت مني، أو بعض المقالات الصحافية والمساهمات التي كتبتها بالفرنسيّة.
صراحة لا يمكنني تقدير الفرق في مكوّنات وعيي لو أني بقيت في لبنان. أنا لم “أهاجر” من أجل مشروع أو هدف. أنا هربت مع ولديّ هربا من نار الحرب. وفي لبنان كانت ثقافتي في مكوّنها الفرنسي موجودة، ولم أكتشف شيئا هنا غيّر حياتي. حصلت على ما كنت أسعى إليه أي الأمان. هذا كل ما في الأمر… ربّما جعلت إقامتي هنا، عن بعد، نظرتي أكثر حدّة وأعمق نقدا لما نحن فيه، إذ لا أخضع هنا لمسايرات وتنازلات قد يفرضها التأقلم مع واقع بلادي.
الجديد: هناك محطات فارقة في تكوينك الثقافي والفكري والإبداعي هل لك أن تلخصيها لنا؟
هدى بركات : يصعب الردّ على هذا السؤال لأننا أنفسنا لا نعي ما هي تلك المحطّات المهمّة.. لنقل ـاختصاراـ إن تجربة الحرب كانت تجربة شديدة العنف، وهي خضّت وعيي بالعالم إلى حدّ أقصى. كأنّها أعادت تربيتي، و”دوّرتني” بشكل مختلف.. إلى ذلك أعتقد أنّها الكتب. فبعض ما قرأت وأقرأ يغيّرني عميقا، يغيّر في تكويني وفي كتابتي وفي نظرتي إلى كل ما حولي. حياتي بسيطة جدا لكن قراءاتي ليست كذلك.
الجديد : كيف تتابعين المشهد الروائي اللبناني الآن وماذا تقرئين المنجز؟ هل هناك إضافة لمسيرة الرواية والقصة؟
هدى بركات : أنا أتابع بالقدر المستطاع توزيع الكتب في فرنسا، ليس فقط الرواية اللبنانية بل العربية عموما. لكن ليس لي رأي أدلي به إذ أشعر أنّه سيكون ناقصا.. الواقع أن الإصدارات أصبحت كثيرة وعديدة بالنسبة للرواية، وأعتقد أن الكلام عن إضافة لمسيرة الرواية ما زال مبكّرا نظرا إلى الكمّ الذي ينهمر.
الجديد : أخيرا، كيف ترين المشهد الثقافي عامة في لبنان، هل ما يزال يملك زخما كذاك الذي عرفناه خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقد عايشت تلك الحقبة عن قرب؟
هدى بركات : “الزخم” موجود كما لاحظنا، لكن الجديد هو في الفنون البصرية، والبصرية/ السمعية وفي التشكيل، زخم وجدّة لم تعرفهما العقود التي ذكرت. أنا فرحة بهذا ومن خلال متابعاتي هناك ما يتحقّق بالفعل. ربما عندي بعض انحياز بسبب أن ابني رضا رسّام بارع وموهوب.
ينشر الحوار بالاتفاق مع “الجديد” الشهرية الثقافية اللندنية
العرب : أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
صحيفة العرب© جميع الحقوق محفوظة
يسمح بالاقتباس شريطة الاشارة الى المصدر
جريدة الشرق الأوسط
الاثنين - 16 رجب 1439 هـ - 02 أبريل 2018 مـ رقم العدد [ 14370]
الصفحة : ثقافة
بيروت : سوسن الأبطح
هدى بركات لـ «الشرق الأوسط»: مرتاحة لإيقاعي في الكتابة ولا يغريني الترويج
بعد صدور روايتها الأخيرة «بريد الليل»
في روايتها الأخيرة «بريد الليل» حيلة جديدة تنتهجها هدى بركات، لتدخل قارئها في لعبة الرسائل الخمس التي يكتبها أصحابها، وكأنها تصفية حساب مع أشخاص لن يقابلوهم مرة أخرى، وهم في الحقيقة لا ينتظرون جواباً، ولا يريدون تفسيراً، أو يرجون تبريراً. شيء من البوح المتوازي لأناس لا يربط أحدهما بالآخر شيء سوى ساعي البريد، الذي بدوره سيعلق في دائرة الحرب الجهنمية التي تجعل هذه الرسائل بين يديه مجرد حكايا عالقة: «تتكدس كالأوراق الميتة، في زوايا الشوارع الفارغة».
منذ روايتها الأولى «حجر الضحك» وهدى بركات تنال رضا القراء، وإعجابهم بحياكة قصصها، وأسلوبها الكتابي. نالت «جائزة النقد» يومها، ومن ثم «جائزة نجيب محفوظ» عن روايتها «حارث المياه»، ثم كُرّمت في فرنسا مرتين، حين حصلت عام 2002 على وسام من رتبة فارس في الأدب والفنون، ومرة أخرى عام 2008 حين نالت وسام الاستحقاق، ورواياتها جميعها مترجمة إلى الكثير من اللغات. بعض هذه الروايات صغيرة كما «بريد الليل» التي تقع في 126 صفحة. وهي أديبة مقلة بالنسبة لروائيين باتوا يصدرون كل سنة كتاباً بمئات الصفحات. بركات تعتبر أن لها مقاييسها الخاصة في الكتابة، وطريقتها في التأليف، ولا تجد نفسها ملزمة اللحاق بمتطلبات السوق، حتى وإن كانت مغرية. تشرح قائلة: «في دار نشر (أكت سود) يشجعونني دائماً على الإسراع في الكتابة. لكن هذا هو إيقاعي، ولا يمكن أن يتغير، لا بفعل تشجيع الدار، ولا إغواء ترجمة، ولا حتى إغراء الترويج الذي يتطلب حضوراً دائماً. مرتاحة كما أنا، ولا أعرف كيف أشتغل بطريقة أخرى، حتى لو نسيني القراء بين الرواية والتي تليها».
لا تكتب بركات رواية تلمس أنها هي نفسها تضجر منها، ولا تحمل جديداً. «الجدة لا تكون فقط لجهة الموضوع، وإنما على مستوى الوعي بالكتابة. لذلك؛ فإن رواية (بريد الليل)، لا تشبه ما قبلها لا بالنهج ولا الحجم ولا الموضوع. كل كتاب عندي مغامرة، مع أنه قد يدور حول الأسئلة نفسها، لكن الاختلاف يكمن دائماً في الأسلوب وكذلك الطريقة والتعبير». «بريد الليل» فيها حيلة تتماشى مع المناخات التي أرادت أن تصل إليها. حياة الشخصيات مكسورة. هم أنفسهم لا يعرفون أين بدأوا، وليس لديهم قناعة بما سبق؛ لذلك يبدو السير نحو المستقبل متعثراً. «لا يقين كاملاً لدى هؤلاء الأشخاص. الاعترافات التي دوّنوها ليست في الحقيقة اعترافات، أغلبها كذب وغش وخداع، وأخبار عن قصص لم تحدث؛ لأن أحداً لا يعرف ما هي الحقيقة». تستدرك بركات «أساساً لا يقين في العالم كله، مهاجرون يتركون بلادهم لا يعرفون أين يذهبون. كل البلدان العربية تعيش لحظة اهتزاز فظيعة. ما أردت قوله في هذه الرواية، ما كان ليكتب إلا بهذه الطريقة. فما سطر في الرسائل لا يصل إلى أصحابه، وهو إن وصل فتلك كارثة؛ لذلك فهي رسائل مضمونها لا ينتظر جواباً، ولا يؤدي إلى يقين».
والبوسطجي في القصة ليس تكنيكاً روائياً فحسب، كما كتب بعض النقاد فهو يوجد في بلد لم يعد فيه شوارع ولا عناوين ولا بيوت بسبب الدمار الذي تسببت به الحرب؛ مما يجعل عمله مستحيلاً. «هو هنا له رمزيته، بحيث إن دوره الوجودي برمته قد انتهى، ولم يعد له من وظيفة فعليه لتأمين التواصل بين الناس. فالإيميل بنظري ليس رسالة بالمعنى الذي نفهمه. لقد أصبحت الرسالة رمزاً لتواصل قد انقطع».
ثمة إشادة بلغة هدى بركات، بأسلوبها الأدبي الجذاب، لكن تقنية «البزل» التي تستخدمها في تركيب لوحاتها أثناء الكتابة لها إيجابياتها، وقد يكون انعكاسها سلبياً أحياناً على القارئ، الذي يشعر، ربما بأن الخيط، أفلت منه. وهي على وعي بذلك؛ فقارئها «له حساسية أدبية» وهو «في بعض الأحيان نخبوي»، كما تقول. «أعرف، أن ما أكتبه ليس دائماً سهلاً، وهذا ليس مقصوداً، لكن بالنتيجة على القارئ أن يبذل جهداً، فإما أن يستمتع معي، أو يرمي بالكتاب». ففي رواية «ملكوت هذه الأرض» يمضي القارئ خمسين أو ستين صفحة، قبل أن يصل فعلياً إلى الشخصيات. البعض قد يجد في ذلك عيباً، لكنها تراها صفحات مهمة جمالياً، لما سيحدث بعد ذلك. «لقد استغرقت في هذا الفصل لأدخل القارئ في عالمي الروائي، بأسلوب جمالي، احتاج مني جهداً كبيراً لأشكل معجماً يناسب البيئة الجبلية وعواصفها الثلجية التي أصفها. وهي أجواء تحتاج إلى مفردات ليست وفيرة في الأدب العربي».
ثم أن تقنية «التشظي» كأسلوب في الكتابة الروائية «لا أنتهجها في كل رواياتي. فلكل رواية حكاية بالنسبة لي، والتقنيات تستل من الموضوع نفسه». تمر هدى بركات على أسماء روايات كتبتها، تضرب مثلاً بـ«حجر الضحك» التي شكلت البداية، وتقول: إنها «كانت مختلفة عما جاء بعدها. أما رواية (أهل الهوى) فكأنما كنت أسمع صوت رجل يخبرني قصة لأكتب أحداثها».
ليست روايات هدى بركات نقل لوقائع تعيشها، بقدر ما هي من بنات خيالها. «تنطلق الشرارة الأولى للكتابة بهاجس، يراودني ملحاحاً، وأنا في الباص (الحافلة)، وأنا أطبخ، أكنس أو أقرأ. في مطلع كل رواية كتبتها يمكن للقارئ أن يعرف الهاجس الذي منه انطلقت. في (حجر الضحك) كان السؤال كيف يمكن للإنسان أن يبقى بريئاً، حين تراءت لي شخصية خليل الذي تبين أنه مثلي». هكذا يبدو أن اختمار فكرة الرواية يأتي من التفاعل مع مسار الحياة المعاشة، وطالع من تفاصيلها «ربما لأنني امرأة والوقت ضيق، وأولادي يأتون قبل أي اعتبار آخر. فلا بد أن أجرب في رأسي حيث يستعصي التجريب بالكتابة ولوقت طويل». باستثناء «حجر الضحك» التي كتبتها مرات عدة؛ لأنها لم تكن واثقة بعد من قدراتها وموهبتها، فإن أي رواية أتت بعد ذلك استغرقتها سنة ونصف السنة تقريباً، تتركها لشهرين من الاختمار ثم تعود إليها لتعيد قراءتها، بل وتعيد كتابتها أيضاً. إذ تقول: «أميل كثيراً لحذف مقاطع كبيرة، أتخلص من كل ما أعتبره ثرثرة، أو إطالة، قد تضجر القارئ. عندي من الشجاعة في الحذف ما يكفي لأتخلص من صفحات تعبت في تدبيجها».
هي من جيل لا يغفر له أن يقف عند حدود جنسه «ليست مرجعيتي سيمون دوبوفوار في (الجنس الآخر)، وإنما مرغريت يوسنار التي كتبت عن النسوية بوعي متقدم». وعن روايتها «أهل الهوى» المكتوبة على لسان رجل، شرحت تكراراً أنها قصدت أن ينطق هذا الرجل بعبارات وتشبيهات وصوراً لا تخرج إلا من أفواه نساء. فأدواتها الكتابية لا يمكن أن تكون أدواة رجل.
تركت لبنان في عز الحرب الأهلية وقبلها كتبت رواياتها الأولى من وحي المعارك والدمار وهي تتنقل من منزل إلى آخر هرباً بأولادها، وبقيت الحرب لا تفارق كتبها في مغتربها. في روايتها الأخيرة «بريد الليل» صحيح أننا لا نعرف أين تدور الأحداث، ولا يبدو من السياق أنها في لبنان، لكنها الحرب أيضاً، تؤرق حياة أصحاب الرسائل والبوسطجي الذي يحملها، ثمة خراب جاثم دائماً. هي في هذا لا تشبه الروائيين اللبنانيين من جيلها الذين بقوا في الوطن وخرجوا من هذه التيمة، فالبعد يجعل نسيان ما حصل أصعب. ولهدى بركات أسباب أخرى منها أنها تعتقد أن الحرب أي حرب تهز الوعي، والإجابة على أسئلتها الصعبة تحتاج إلى وقت مديد «الحرب العالمية الثانية، لا يزالون يكتبون عنها في أوروبا. ربما لو بقيت في لبنان لاضطررت إلى التأقلم مع الحياة اليومية. على أي حال كل ما كتبت يطل من ناحية أو أخرى على بيروت، ربما لأنني أعرف لبنان قبل الحرب، وأدرك كيف كانت الحياة، وما الذي انتهت إليه».
على محك التجارب القصوى كل القناعات تهتز، هذا من الطبائع البشرية، والحرب من أقسى التجارب التي يعايشها الناس. تشرح فكرتها قائلة: «فأنا لا أعرف مثلاً لو أنني كنت فرنسية وعشت أحداث الحرب العالمية بوحشيتها، هل كنت سأجد نفسي عميلة لصالح الألمان مثلاً أو في الجانب الآخر؟ من يدري؟ من يستطيع أن يقدّر الظروف، والمحيط؟ فالخيارات في زمن السلم هي غيرها في زمن الحرب، حين تختلّ المعايير، والضوابط والمرجعيات. فأنا أتساءل دائماً كيف يتحول في الحرب نصف شعب إلى قتلة، أي ميكانيكية تحول كائناً عادياً إلى قاتل للآخر. في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ثمة قديسون تم تطويبهم، كانوا قبل ذلك مجرمي حرب».
تناسل الحكايا، خروج القصة من بطن أخرى، في روايات هدى بركات يحيل أحياناً إلى السرد العربي القديم، وهو ما لا تعترض عليه، بل تعتبر أنها ليست فقط من سلالة الكلاسيكيين العرب، بل هي جددت في هذا السرد، خففته من فخامته والتكرار. «فأنا معجبة إلى حد بعيد بطواعية اللغة العربية وأجدها حديثة جداً. هذا لم يكن تلقائياً ولا عفوياً. قرأت القديم ولا أزال. كان يجب أن أعلّم نفسي ما لم أتعلمه في المدرسة. كنت حينها أكره العربية، ثم بعد ذلك، في لحظات الوعي، وفي الجامعة، تعرفت على الأدب. كتابتي باللغة العربية جاءت بفعل خيار شخصي، فقد كنت عند تخرجي وبحكم طبيعة دراستي أقرب إلى الكتابة بالفرنسية، ولا أزال أكتب نصوصاً بالفرنسية، حين يطلب مني المشاركة في عمل ما أو كتاب مشترك أو مقالة». ولا داعي للحديث عن كمّ المغريات للكتابة بلغة أجنبية، من تسويق وغيره. لكن «قلبي ليس ثنائي اللغة، فتكويني اللغوي عربي. وعندي احترام عميق جداً للعربية، أعمق من أن أستطيع وصفه». إنه عشق للغة تشعر بها بركات خارجة من صلبها، معجونة بوجدانها «حين أقرأ نصوصاً لابن حزم أو الجاحظ أو المتنبي، أو الصوفيين، وابن عربي أشعر ببهجة وأكاد أصرخ (الله أكبر ما هذا الطرب). ومن الجيل الحديث أرى أن محمود درويش هو أحد ورثة هؤلاء. فعمق قصائده هي اللغة، ومن دون عبقريتها، لا شيء يبقى».
ومع كل ما يشاع عن صعوبة كسر المحرمات بالعربية، تعتبر بركات أنها تكتب ما تريد ولم تتعرض لمضايقات. «فالاقتراب من التابوهات يجب أن يتم باحترام، ومن دون استفزاز. التعامل مع المحرم ليس أمراً سهلاً. وجماليات السرد تحتاج إلى مجهود كبير للتعامل مع ما يسمى المسكوت عنه».
في بشري، بلدة جبران خليل جبران الجبلية المهابة بطبيعتها ووديانها وخضرتها ولدت هدى بركات، وإليها تعود زائرة كلما رجعت إلى لبنان من مغتربها الفرنسي، وعنها كتبت «ملكوت هذه الأرض» التي رأى فيها أهل البلدة إساءة إليهم ولم يستلطفوها. لكن بركات، على عكس ما قيل، تكنّ لبلدتها بشري حباً كبيراً. «كتبت الرواية بعناية فائقة، وأعطيتها وقتاً طويلاً، ونسجتها بمفردات اشتغلتها بحيث تعبر عن طبيعة المكان والأجواء. هناك من رأى في المكتوب هجاءً لأنه نقدي، وهذا أمر طبيعي؛ فليست الحياة مديحاً. لكن الحقيقة أن ما كتبته لبشري هو حب خالص».
عن جريدة الشرق الأوسط
جريدة الشرق الأوسط، صحيفة عربية دولية رائدة. ورقية وإلكترونية، ويتنوع محتوى الصحيفة، حيث يغطي الأخبار السياسية الإقليمية، والقضايا الاجتماعية، والأخبار الاقتصادية، والتجارية، إضافة إلى الأخبار الرياضية والترفيهية إضافة إلى الملاحق المتخصصة العديدة. أسسها الأخوان هشام ومحمد علي حافظ، وصدر العدد الأول منها في 4 يوليو 1978م.
تصدر جريدة الشرق الأوسط في لندن باللغة العربية، عن الشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق، وهي صحيفة يومية شاملة، ذات طابع إخباري عام، موجه إلى القراء العرب في كل مكان.
لقراءة المزيد
جريدة القدس العربي
السنة التاسعة والعشرون العدد 9073 الثلاثاء 23 كانون الثاني (يناير) 2018 - 6 جمادى الأولى 1439 هـ
رشا الأمير - روائيّة لبنانيّة
بريد هدى بركات: رسائِلُ تَقْطَعُ الأنفاسَ وليلٌ لا ينجلي!
لا تحتاج هدى بركات، وهي مَنْ هي بين الروائيين والرِّوائيات العرب، في «بريد الليل» الصادرة حديثا، (دار الآداب 2018)، أن تُخْفي خطتها على القارئ – القارئة، أو أنْ تزعم بأنَّ خِطَّةَ هذا الكتاب فَتْحٌ غَيْرُ مسبوق في دنيا الرِّواية.
فـ«بريد الليل»، للوهلة الأولى، يُقَفّي على آثار سلالة عريقة يرتفع نسبُها أعلى عليين مِنَ الأعمال الأدبية التي اصطنعت «الرسالة »، أو الرسائل المتبادلة، صيغة أو ذريعة أو حتى بنية سردية. والرواية المكثّفة القصيرة تستلهم للوهلة الأولى أسلوبا فَنِّيا، عابرا للصناعات (صناعة الرسم، السينما، الكتابة)، قوامه التَّضْمين ــ تضمين أجزاء من لوحة، مثلا، في اللوحة نفسها أو إنشاء لوحة، مِنْ أجزاء لكلٍّ واحد منها، إذا ما قيس بمقياس التمام، كفاية من نفسه، ومن أشهر الأمثلة على هذا الأسلوب لوحة «وجه الحرب» لسلفادور دالي، حيث تنزل الجمجمة التي هي عامود اللوحة، مع بعض التصرف، محلَّ الفكين والأسنان من الفم، ومحل العينين من المحجرين.
نعم، كِلْتا الوهلَتَيْن الأوليين هاتَيْن في محلّهما، ولا تكادان أن تطلبا دليلا يستدل به على صحتهما، ولكنَّ «بريد الليل» النصّ المكثّف لا يكتفي أنْ يأخذ من أدب التراسل بطرف، ومن أسلوب التَّضمين بطرف آخر، وأن ينام على هذا الحَسَب العريق والنسب، وهذا ما يجعل منه كتابا على حدة، وينفي عما تقدم من وصفه صفة المبالغة أو التهويل !
بالورقة والقلم، يتألّف الكتاب من ثلاثة فصول: قوام الأول المعنون «خلف النافذة» خمس رسائل على أن تفهم كلمة رسالة هنا بالمعنى الأوسع للكلمة. فإذ تبدأ الرسالة الأولى بـ «عزيزتي،» سرعان ما تنقضّ هدى بركات على هذا المطلع فتعلق عليه ساخرة بأنَّ افتتاحها الكتاب – الرسالة الأولى منه بـ«عزيزتي،» إنما يُساير العرف الذي يريد أن تبدأ الرسائل على هذا النحو، وأنَّ «عزيزتي،» هذه لا تعني ما تقول، أو تعني أكثر من ذلك بكثير، وأنها بَدَلٌ عن كلمة ضائعة لا أمَلَ، على الأرجح، بالعثور عليها. وإذْ يَجري هذا التحفّظ الابْتِدائيُّ على كل الذين – اللواتي يفترض أن تتوجّه إلَيْهِم- إلَيْهِنَّ رسائِلُ الكِتابِ الخَمْسُ، فـ«عزيزتي،» ليست أيَّ كلمة: إنَّها مُخاطَبُ المرسل (سلة) ومخاطبَتُه، وعليه فان التَّشْكيكَ، من أوَّلِ الأمر، بهوية هذا المخاطب (ـبة)، تشكيك بوجوده، وتشكيك بأنَّ الرسالة مرسلة إليه (إليها). بانية على هذا التَّحَفُّظِ – التَّشْكيكِ الأصلي بأنَّ هذه الرسائِلَ رسائلُ، وبأنَّ المخاطَبَ (ـطَـبَةَ) في كل واحدة منها هو المرسَلُ إليه أو المرسَلَةُ – إليها. لا تحتاج بركات، بعد الرسالة الأولى إلى كثير لتمضي في لعبة التضمين التي لا تستقيم إلا بأنْ يحلّ شخوص في شخوص، وليس مَحَلَّ شخوص، وبأن تحلَّ أمكنة في أمكنة، وليس مَحَلَّ أمكنة، وبأن تَحلَّ علاقات بشريَّة وعواطف متبادَلَة، (وفي كثير من الأحيان غير متبادلة)، في علاقات وعواطف، وليس محلها وهكذا.. وبمقدار ما يستجيب الشُّخوصُ والأمكنةُ تحت قلم هدى بركات لِداعِيَةِ الحلول مَنْ في مَنْ وما في ما، تتسارع الوتيرة ــ وتيرةُ الحلولِ والتَّضْمين ــ إلى حَدٍّ لا انتقاصَ معه من الكتاب أنْ يُقالَ بأنَّهُ يرهق القارئ ويقطع النَّفَسَ منه.
عليك، مَثَلا، بالرسالة الثانية: امرأة، بمفردها، في غرفة فندقها في عاصمة أوروبية ــ امرأة بمفردها لا تنتظر أحدا ويجافيها النعاس فتملأ ليلها بتفقد المكان «مسكة باب الخزانة تشبه ما كنت رأيته عند عمتي» وإذ تنتهي من المسكة تلك تنتقل للتحديق «في درفة الخزانة وتعرجات الخشب» وهكذا إلى أن يصل بها الفضول إلى تصفّح دليل الفندق الذي يذهب بها الافتراضُ إلى أنه لا حاجة له أصلا «في فندق صغير كهذا» ولا في زمن الهواتف الذكية، ولكن، كما يتفق، للَّـهِ أنْ يستودع سره في أضعف خلقه، ففي هذه المطبوعةِ المفتقدة لكل الأسباب الموجبة لأن تقبع في «درج الطاولة الصغيرة إلى جانب السرير» تعثر النزيلة على الرسالة التي سوف تؤثِّثُ ليلها. ولكن رسالة كاملة الأوصاف، أي تامة ومعروفة المرسل والمرسل إليه لا تكفي لأنْ تعبّر على متنها المرأةُ المُسْتَوْحِشَةُ في غرفة فندقها اللَّيلَ كُلَّه… مِنْ ثَمَّ تحكم بركات على الرسالة أن تكون «ناقصة، بلا خاتمة»، واستطرادا بابا على نهايات شتّى لا رُجَحانَ لواحِدَةٍ منها على أخرى، ولكن ليس هذا فحسب! فاعتلالُ آخِرِ الرسالة لا يحول دون أن يدعو القسمُ السالمُ منها إلى الحيرة… فالرسالة «تتحدث عن شاب كان كتبها في غرفة مفروشة رخيصة الإيجار في شارع شعبي قريب، فكيف وصلت إلى هنا؟». وعلى هذا النحو من التتالي تسير بنا المرأةُ المتوحدة التي يستبد بها الأرق في غرفة فندق متواضع، التي لا نعرف، حتى الآن، من أمرها شيئا إلى الانهماكِ بقصة ذلك الشاب الذي أنس من نفسه ذات يوم، في الشقة المفروشة التي كان يقطن فيها، أن يكتب رسالة، ولا يتمها، للمرأة التي يحب! ولا تدع المرأة إياها، القارئ يشاركها في فك لغز ذلك الشاب حتى تباشر، هي نفسها، خَلَلَ الشُّقوقِ التي في قصة الشاب، بالحديث، على نحو المراسلة أو المخاطبة، إلى مجهول كان بينها وبينه ما كان..
على هذه الوَتيرةِ من السَّرْدِ القاطِعِ للأنفاسِ يجري كلُّ واحدٍ مِنَ الفُصولِ الخَمْسَةِ من القِسْمِ الأوَّلِ من الكتاب مجراه؛ وإذ يطوي القارئُ هذا القسمَ كما لو أنَّهُ كتاب تَمَّ، وإذ تتعمد بركات أن يكون مِسْكُهُ «أرجو ألّا تتأخر في الرَّدِّ»، في غمزة لا تخفى إلى «عزيزتي،» التي يُفْتَتَحُ بها، يستقبل القارئ قسما ثانيا تحت عنوان «في المطار». عشرون صفحة، بل أقلُّ، قوام هذا القِسْمِ الموزع بدوره على خمسة فصول. لا إشارةَ صريحة إلى أن هذه الخمسة مرادفات على الخمس الرسائل التي يضمّها القسم الأول ولكن حسب القارئ أن يثق بأنْ التَّوارد في فصول القسمين ليس من العفو في شيء ليتبيّن أن هذا القسم الثاني من الكتاب أشبه بملحق «الحلول» الذي يلي أحيانا صفحات المسائل من بعض الكتب المدرسية. ولكن حذارِ الظنَّ بأنَّ ملحق الحلول هذا هو الجزاء الحسن الذي تُكافئ به بركاتُ قرّاءَها (وقارئاتها) الذين يُثْبِتونَ طول نفس يعبر بهم، بِسلام أو في الحد الأدنى بأقَلَّ خسائر ممكنة، مَفازَةَ الرسائل الخمس ومتاهاتها المنتسجة نسجا عنكبوتِيّا محكما. صحيح أنَّ بعض فصول القسم الثاني قد تبدو وكأنها تقولُ أشياءَ سكتت عنه الرَّسائل، أعني تقترح إضافات على قِصَصٍ أبقتها الرسائل معلّقة، غير أن هذه الأشياءَ والإضافاتِ لا تَسْتَتِمُّ الرَّسائِلَ، ولا تُفْرِج عن كُلِّ ما وراءَها مِنْ أسرار مخبوءة، أو ما يظنه أصحابها أسرارا مخبوءة. يمكن للقارئ أن يلهو قدر ما يشاء محاولا الربط بين الرسائل الخمس، كما بين الملاحق الخمسة وتلك الرسائل، وله أن يُعيدَ المحاولة المرة تلو المرة، مآله، على الأرجح، أن يكتشف بلا كلل، وأن يعيد الاكتشاف، بأنَّ البوح، مهما بدا مسترسلا، ومهما عَوَّلَ عليه صاحبه، سابِعُ المستحيلات وبأنَّ الرسالة، وإن بدأت بـ«عزيزتي» واختتمت بـ«لا تتأخر في الرد»، تبقى ناقصة، فالفراغ، كما تقرر بركات على لسان إحدى بطلاتها، هو «سيّد الخيال والمعاني» وفي هذا الفراغِ، بوصفه من أسماء للنقصان، يُنادي على الرسائل أن تكتب. ولكن ما الخير من رسالة كتبت في جَوْفِ الليل ولا تَجِدُ من يُؤَدّيها ؟
على سبيل الخاتمة، بل قل على سبيل الدّعابة السَّوداء، تغلق هدى بركات روايتها على فصل، (قَصير)، لا تتحرّى له عنوانا أصرح من «موت البوسطجي». ولكن، هنا أيضا، حذار العناوين المضللة: ليس هذا الفصل بنعي للبوسطجيِّ ولا بمرثيةٍ تُعَدِّدُ مآثره. ففي جعبة البوسطجي، آخِرِ الأحياءِ في بِلادٍ الحَروبِ الماضِيَةِ قدما، مُفَهْرِسِ الرَّسائِل، كاتِبِــها لربما، خَبَرٌ أسْوَأُ مِنَ المَوتِ، أو حتّى مِنْ موتِهِ هو: لا ناس هُنا بَعْدُ ولا عناوين… رسائل فقط !
عدد المقال بالـ pdf في جريدة القدس العربي
عن صحيفة القدس العربي
القدس العربي”، صحيفة عربية يومية مستقلة، تأسست في لندن في نيسان/أبريل 1989. تطبع في الوقت نفسه في لندن ونيويورك وفرانكفورت، وتوزع في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا. يتابع موقع الصحيفة يوميا على الانترنت مئات الآلاف من أنحاء العالم كافة.
اكتسبت الصحيفة سمعة عربية ودولية طيبة، بسبب نشرها للاخبار الدقيقة ولتغطيتها الموضوعية للأحداث، والتحليل العميق للقضايا العربية والعالمية، معتمدة في ذلك على مجموعة من المراسلين والكتاب المميزين.تواصل الصحيفة تطورها خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث انضم الى طاقمها مجموعة جديدة من المحررين والمراسلين الاكفاء والكتاب المرموقين. وتحرص الصحيفة على التواصل مع قرائها، ونشر تعليقاتهم وآرائهم على صفحات نسختها الورقية وعلى موقعها الألكتروني و”فيسبوك” و”تويتر”.
السبت، ٢٠ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨
جريدة الحياة
أحمد المديني
«بريد» هدى بركات لا يصل أبداً
اسم هدى بركات يسبق عنوان إصدارها الجديد «بريد الليل» (الآداب، 2017). وحين يصبح للكاتب رصيد، شأنها، يغدو الاسم مكلفاً، ففي جعبة بركات روايات ذات قيمة فنية معتبرة في مضمارها، نحصر منها: «حارث المياه» (2001) و «ملكوت هذي الأرض» (2012) خصوصاً. تعني الكلفة ما يمليه الرصيد على صاحبه، مع كتابته ومعشر متلقيه، من البرهنة على استمرار إمساك زمام قلمه، والقدرة على الإتيان بمزيدٍ يُشبع الفضول إلى متغير وليس استزادة كلام، كيفما اتفق، وبخاصة في زمن أدبي عربي أضحت فيه الرواية مشاعاً.
في «بريد الليل»، تلبّي هدى بركات الفضول، بالتسمية أولاً «بريد»، وبكيفية بناء أو صنع مادة هذا البريد، ثانياً، ومنوال سرده، فنحن كما يعيِّن الغلاف مع ميثاق (رواية)، ثالثاً، وبوضع نسق (ما) للرواية ضمن النظام العام الذي يختص به جنسُها الأدبي، هذا إذا افترضنا أن هناك فعلاً نية اختراق لدى الكاتبة للنمط التقليدي الذي اعتادته. نعلم أنه سبق لها تجربة تأليف يُصنّف في خانة أدب التراسل «رسائل الغريبة» (2004) بثّت فيه أشجانها وخطّت في نقاها تأملاتٍ ومشاعر كائن منشطر بين اغترابه وجذوره، بيد أن تلك من نوع النص الحرّ. وما بين أيدينا حديثاً «بريد» يتسمّى بمعناها، ويقترن بجنسٍ اسمُه الرواية، أي يشترط بفنّه.
يتكوّن «بريد» هدى بركات من خمس رسائل مسدّدة، متفاوتة الطول، متباينة المرسل ومتقاربته في آن. ويتوزع كِتابُها على ثلاثة أقسام، الأخير خاتمةٌ قصيرةٌ جداً تقدم لحظة التنوير في السرد الكلاسيكي. ترتبط جميعُها بقرينة علاقة غير سببية بين مرسليها، هي الحبكة المعتمدة لنظمها في السلك الروائي، بعِضُدِ تيمات متساندة، وإن كان هذا لا يكفي. الرسالة الأولى من شخص، رجل، إلى امرأة، حبيبة، هي رسالته الأولى يستدعي فيها أوقات عيش وعاطفة مشتركة، ويبثها ضجره، يقدّم معلومات عنه: فقدانه الصلة مبكراً بأهله، زوال محتده، إقامته في غرفة بائسة بوضع مادي معدم، ويعاني من بارانويا أحد يراقبه دائما (مخبر، استخبارات)، همه استحضار مقاطع من ماضي عمله عند عسكري انقلابي فتح جريدة ليعلّم أصول الديموقراطية، عاش بلا أوراق مهاجراً سرياً، قنصلية بلده ترفض تجديد سفره، اشتغل مروِّج مخدرات ومعارضاً سياسياً، يبحث عن أرملة يقترن بها ليحصل على الأوراق ثم الجنسية (مستنسخات).
الرسالة الثانية، تبعثها سيدة إلى «الحبيب»، وهي جالسة في غرفة فندق إثر موعد مضروب بينهما بعد فراق طال. في الانتظار تكتب إليه رسالة (لأملأَ انتظاري) وهي مقتنعة بأنه لن يحضر(!) بدورها تستدعي ماضيهما معاً: «ما الذي كان بيننا؟ ما الذي بقي مما كان بيننا؟ ولماذا قد تأتي، ومدفوعاً بأيّ شوق لتلك الأيام القليلة؟»(45) وتترى خواطرها وبوحُها وتساؤلاتها في تداعيات متقطعة. وفي النهاية، لا يأتي الحبيب، فتقرر أن تبحث عنه لتجد: «أثراً له في باريس. وسأعرف إن كان عاد إلى بلده بعد الثورة التي قامت هناك»(!). الملفت أن هذه السيدة تعثر في غرفتها على الرسالة الأولى، خصائصها أنها ناقصة، بلا خاتمة، مَروِيُّها لا يشبه حكايتها وإن أحست كأنها نفس المرأة التي يتكلم عليها، بما يخلق التباسا مقصودا من الكاتبة أنها ذاتُها، المهم أنه يصنع عندها قرينة الربط بالسابق.
الرسالة الثالثة، أسمّيها «اعترافات ولد لأبيه». فالرسائل تتسّم بنبرة اعترافية (كنسية) تلتمس بطبيعتها الصّفح. يدوِّنها كاتبُها من مطار ما، يسميه البرزخ، أي محطة عبور، متسائلا اولا هل ستصل إلى أبيه، وهو يبثّ أوجاعَه وحنينه إلى أمه، يتذكر حضور قوة غاشمة اعتقلته في بيتهم ليس بسبب الحشيش ظنَّ أمه، ويسرد لها/ لنا ما سامه من أنواع تعذيب وإذلال فوق الاحتمال من العساكر ليعترف بما لا يعرف، بأسماء وصور نمطية مبذولة في روايات «الربيع العربي» حدَّ الإسفاف. بعد مساومته ينقلب بدوره إلى جلاد، ينادَى ب «سيدي» و»يرهب الخليقة»، إلى أن وقعت واقعة «الربيع» فأفلح في الهرب واختلط بالثوار، انتقل معهم إلى المعارضة، منها تسلل مع العابرين إلى البحر، علينا أن نخمِّن كثيراً مع هذا المتن الترسُّلي فنملأ بياض مجهوله (المعلوم) ترجُح كفةُ غرضيتِه في الميزان. يخبرنا محكيُّ الرسالة على لسان الهارب عن محطات وجوده في بلد الهرب(؟) وشقائه وجوعه في المخيمات ورفقته مع هارب مثله من ألبانيا، إلى أن عطفت عليه سيدة حيث يوجد، نقلته إلى بيتها، عاشرها إلى أن تقزز من عمرها ووضعه برفقتها فسرق مالها ومصاغها بعدما قتلها ليلوذ بالفرار ويلقى عليه القبض في المطار. تلي الرسالة الرابعة بمثابة اعترافات أيضاً من سيدة إلى أخيها، تحكي في سياق خواطر وتفجّع ومن قبيله، علينا أن نأخذ منها قصتها الشخصية، نمطيةً مرة أخرى، مغادرتها بيت العائلة بعد طلاق وهجرتها إلى بلد ما، تاركة ابنتها في حضن أمها، وما عاشته في بلد المهجر، يرجح أنه في الخليج العربي، وتقلبت من مهن ورذالة إلى أخرى، لتعيل من تركتهم هناك، وصولاً إلى الكشف (اللازمة) عن الرابط مع الحكاية السابقة، إذ تعثر السيدة وهي تجلس على مقعدها في الطائرة على ورق ممزق في ثنية كرسيها، فتكتشف الرسالة التي كتبها القاتل الذي لم يرسل بريده، يتضمن اعترافه، قد أنزلته الشرطة من الطائرة مصفّداً.
ما سيلي بعد ذلك ملحقات تكميلية، زوائد جاز تضمينها في مَظنِّها الأصلي من محكيها، تدلت زعانف وتمطيطاً، أو يستأنس بها لمن يستهويه شرك أن «بريد الليل» رواية تقليدية تحتاج إلى إشباع فضول قارئها من البداية إلى النهاية، وهو ما لا تبخل به الكاتبة، الخبيرة بمقتضى هذه المسطرة مسايرة لـ «أفق انتظار القارئ» فتصنع له نهاية كلاسيكية. وعلى رغم أنها تظاهرت بنبذ نسَقها في شكل عام، استعارت منه فقط النوع التراسلي (Epistolaire)، وهو تراث ومتواتر في فن الرواية، لتنتهي بنا إلى خاتمة «البوسطجي» المتعطل بسبب الخراب الذي عمّ بلاداً هاجر ناسها، منهم كتّاب الرسائل، ولمّا تعذر توزيعها عكف يقرأها: «صنعت منها ما يشبه الفهرس، وجمعتها في ملفات بعناوين واضحة، ووفق تواريخها. فربما عاد إلى هنا أناسٌ وموظفون يريدون توصيل الرسائل إلى المرسل إليهم» (126). صنيعُهم جميعاً كتب بدوره مخافة الموت، رسالته، لتبقى إلى جانبه من يدري قد يصل أحد غداً إلى مركز البريد.
هكذا يغلق «البوسطجي» الدائرة التي فتحت بكلمات الرسالة الأولى، ينتقل سرها إلى الثانية، وصولاً إلى الخامسة الأخيرة، على أن العبارة الأخيرة في النص تترك شقاً مفتوحاً لإيصال الرسالة. هذه الحبكة/ اللعبة تبدو للوهلة الأولى وهي تخرج الرواية، نقول، جدلاً دائماً، من النسق الكلاسيكي، مستنبتة منه بدءاً كضمان البوليفونية في الرواية التراسلية، وانتقالاً إلى صعيد صنعة تجريبية بنزوع لتنويع الشكل، تغريب التناول، التأرجح بين السرد والتداعيات وتراوح بين حكاية الواقع والإيهام به، وطرح الشخصية ونقضها، وتمويه المكان، وتعويم الزمن. يُعرض علينا نص مبني على التجريد، وليس على التشخيص والوصف والتعيين، لا يتسمّى فيه أحد ولا شيء: لا اسم للمرسل، للمرسل إليه، لعنوان البريد، ما يتعارض كلياً مع قواعد النوع ( يُنظر ريشاردسون، لاكلو، يورسنار). بلاد، فندق، مطار، أب، أم، عسكر، هجرة، مقابل فيض تباريح والتفكير بصوت مرتفع لتعبئة خطاب رسولي، يعاضد نبرة الاعتراف، ذاك، ورسالة الكتابة عن موضوع الساعة.
إنها الكتابة «الأليغورية» عن خراب بلد في شرق المتوسط، عن استبداد نظامه وممارسته، ما نجم عنه من ويلات الهجرة والتشرّد، والرسائل بكتابها، شخصياتها المزعومة، وما يفترض أن يقدم تجسيداً للموضوع، صار تيمة معتمدة في الرواية خلال السنوات الأخيرة بإفراط. الرهان ليس على التيمة، وإنما معالجتها، في صلب روائيتها
. وقد اختارت هدى بركات، التي لم يفارقها أبداً إحساسها بالانتماء إلى حرائق وطنها ومنه اعتناق جراح الإنسانية المفتوحة، أن تدلي بشهادتها، وتحدد موقفها. لا جرم جهير وحاسم في عملها هذا، قابل أن يُحوّل إلى بيان (مانفستو) إذا أنت نزعت عنه قناع لعبة التراسل التي تقوم مقام (القول المختلف) وتُسوِّغه، أي الأليغورية، التي تتكفل بتقديم فكرة مجردة، تلك. ليكن، رغم أن هناك تباينا للرأي في هذا الاستخدام، وسيبقى. فإذ حبّذها رونسار في الشعر، فقد اعتبرها ديدرو، بعدما اختبرها ببراعة بصوت أحادي في»الرسائل الفارسية» لغاية سجالية وهجائية: «المصدر العادي للعقول العقيمة». أقول، سيبقى ما بقي الأدب، وهنا يمكن أن أسمع تصفيقاً، من جهة، وصفيراً من جهة معاكسة. ليس من عادتي الحكم على النصوص، ما لا يمنعني من السؤال عن مفهوم الأدب، فناً ونظاماً، والرواية اليوم مهمازه، وأنا لا أخاف من انهيار قواعد التلقي الكلاسيكية القمينة بالأدب، ولكن من اللعب خارج الملعب، إذاك يبطل اللعب جملة وتفصيلاً. أحسب هدى بركات تعلم الفرق جيداً بين الوضعين، ومثلي قلقة، لذا إذ انتهيت من هذا المقال، لذت سريعاً، بصفحات من» الرسائل البرتغالية» تلك، لأتغذى من نقاء الجذور.
جريدة الحياة
“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.
منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.
اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.
تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.
باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.
اللبنانية هدى بركات تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2019
هدى بركات : أنا مِن مكان آخر - نيويورك - حوار مع ابتسام عازم - 12 يوليو 2019 - العربي الجديد - لندن